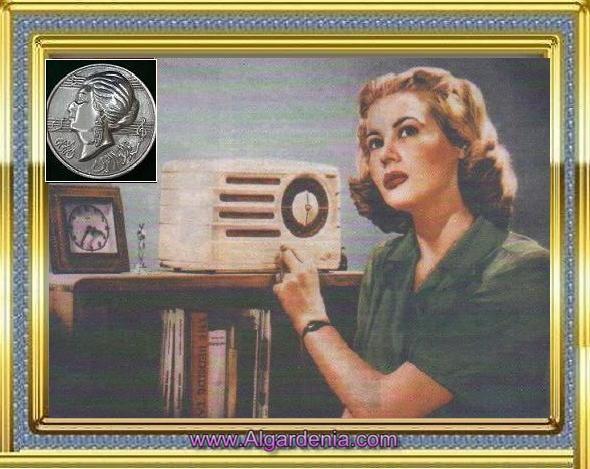ظل القلنسوة يتمدد إلى عهد القبعة: مسيرة التمرد من القسطنطينية إلى النجف
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 09 تموز/يوليو 2025 14:45
- كتب بواسطة: ذو النورين ناصري زاده
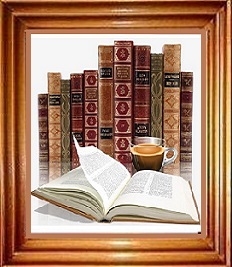
ذو النورين ناصري زاده
ظل القلنسوة يتمدد إلى عهد القبعة: مسيرة التمرد من القسطنطينية إلى النجف
في زاويةٍ معتمةٍ من متحف توبكابي بإسطنبول، تقبع قلنسوة إنكشاريةٌ صامتة. يلامس ضوء خافتٌ صدأها المتآكل، وكأنما ترسلُ عبر القرون همساً إلى أرض الرافدين: "احذرْ أن تصنعَ من مقدسكِ سيفاً.. فقد يلتفتُ السيفُ ذات يومٍ عليك". هذه العبرةُ التي أدركتها الدولة العثمانية متأخرةً عام ١٨٢٦ (في "الواقعة الخيرية")، تطلُّ اليوم من شرفاتِ العراق الحديث، حيث تعيدُ الفصائلُ المسلحةُ كتابةَ المأساةِ بمدادٍ من دمٍ وذهب.
لقد ولدت الإنكشاريةُ من رحم الحلم الإمبراطوري: أطفالٌ مسيحيون اختُطفوا من البلقان، نُزعتْ هوياتهم كأثوابِ طفولة، ثم حُوكت عليهم ثيابُ "العبيد المكرَّمين". صاروا حراساً للسلطان، جسداً يتحرك بإرادة الباب العالي. كذلك ولدت فصائل العراق بعد ٢٠٠٣. حين مزّق الاحتلالُ جسدَ الوطن، ثم تفجّرتْ من صمتِ النجف فتوى "الجهاد الكفائي" (٢٠١٤)، فتحوّل التجّارُ والمدرّسون إلى مقاتلين. لكنّ المقدسَ، حين يتحول إلى مشروعٍ مسلح، يبدأ بإفرازِ تناقضاته القاتلة.
أدرك الإنكشاريةُ أن سيوفهم صارت قادرةً على تشييد عروشٍ موازية. فتحوّلوا من حرّاس القصور إلى سدنتها الخفيين، يرفعون السلاطينَ ويخلعونهم. وفي دهاليز بغدادَ اليوم، يعيد التاريخُ لعبته: فالفصائلُ التي رضعتْ من حليبِ الفتوى، تذكّرتْ أن السلاحَ لا يقدّس إلا نفسه. هكذا ارتدتِ الرصاصةُ عباءةَ التاجر: سيطرةٌ على منافذَ حدوديةٍ (كميناء البصرة)، وتهريبُ وقودٍ تحت غطاء "المقاومة"، يساوي أكثرَ من ألفِ خطبةٍ في الحسينية.
لم يكن التمردُ عصياناً عسكرياً فحسب، بل كان *موتاً للرمز. فالإنكشاري الذي كان يسجدُ لسلطانِه كقديسٍ، صار يرى في قلنسوته تاجاً. وفي العراق، صاحَ المقاتلُ الحشدي في وجه مرجعِه: *"أنا من صنعتُ المجدَ بسلاحي!". كأنّ دماءَ الشهداءِ صارتْ عملةً في سوقِ المزايدات، وشعاراتُ الجهادِ مجرّدَ حبرٍ على شيكاتِ المصارف.
هنا تكمنُ اللعنةُ: كلّما ابتعدتِ الفصائلُ عن حوزةِ النجف، ازداد تمسكُها بخطابٍ دينيٍّ أجوف. ترتدي "المقدس" المتدرع بالولائية لتخديرِ الضمير، بينما تبيعُ الوطنَ في سوقِ النفوذ. إنها ازدواجيةُ الإنكشاري الذي رفعَ المصحفَ صباحاً ليقتلَ بهِ مساءً كلَّ معترض. انفصامٌ يولدُ حين تتحولُ الأداةُ إلى وثن.
وإذا تساءلنا: لماذا نجحَ السلطان محمود الثاني في إبادةِ الإنكشاريةِ عام ١٨٢٦، بينما تعجزُ النجفُ عن كبحِ أبنائها؟ فالسرُّ في الفرقِ بين *"دولةٍ تبني ثقافتها على السيف"* و*"مرجعيةٍ تحاول بناءَ دولةٍ بالدم"*. العثمانيونَ حَسمُوا المعركةَ لأنّ السيفَ كان لغتهم. أما في أرض الرافدين، فالمرجعياتُ كشاعرٍ يحاولُ ترويضَ ذئابٍ بقصيدةٍ.
في الختام، قلنسوة توبكابي ليستْ أثراً غابراً. إنها مرآةُ عصرنا المشوّه. فالعراقُ عند منعطفٍ: إمّا أن يدفنَ "إنكشاريةَ العصر" كما فعل محمود الثاني، أو يتحولَ إلى أندلسٍ تُصهرُ سيوفُها لأجراسٍ وجوامعَ. لكنّ التحديَ الأكبرَ للحوزة: هل تستطيعُ إعادةَ تفسير "الجهاد" كمعركةٍ ضدَّ الفسادِ؟ أن تصرخَ: "كفاكم استشهاداً.. ابنوا المدارسَ بدل الخنادق!"
ذاكرةُ التاريخِ لا ترحم. القلنسوة في إسطنبول لم تنطقْ إلا لأنّ صاحبَها قُتل. أما في العراق، فلا تزالُ الأسلحةُ تُسمعُ ليلاً. والسؤالُ الباقي: *هل نتعلمُ من القلنسوة قبل أن نصيرَ صدأً عليها؟* فالحدائقُ وحدها تُنبتُ ظلالاً للخلود، والخنادقُ تلدُ سرابَ دمٍ.
وفي اللحظةِ التي يُختزلُ فيها الوطنُ إلى ساحة مزادٍ – حيث سيطرةُ فصيلٍ على حقل نفط، أو صفقةُ سلاحٍ باسم "المقاومة" – تتهاوى أسوارُ النجفِ أمامَ جدارٍ من تناقضٍ: *أيها المقدس، من سينقذك من أتباعك؟*
معادلةُ الخيانةِ تتكررُ: "الدفاعُ عن المقدس" يصير سلعةً، ورجالُ الدينِ يصبحوا غير مؤثرين . فالإنكشاريُّ لم يمت لأن السلطانَ قتله، بل لأنّه نسي أن السيفَ الذي يُذبحُ بهِ السادةُ يصيرُ سكيناً في ظهره. وهذه الفصائلُ تحفرُ – بيدٍ – قبورَ خصومها، وبأخرى تُلقي الترابَ على مقبرتها.
والحوزة؟ تقفُ على حافةِ الهاويةِ كعازفٍ يمسكُ وتراً مقطوعاً. فهل تُصلحه؟ الجوابُ ليس في الفتوى، بل في كسرِ صنم "الولاء الأعمى". ما قيمةُ خطبةٍ تنددُ بالفسادِ وأبناؤك يسيطرون على المنافذِ باسمك؟
هنا يُولدُ التحدي: أن تخترعَ النجفُ "مقاومةً" جديدةً:
- *لا تقتلُ بالرصاصِ بل تُحيي بالعدل*
- *لا تسرقُ خزائنَ الدولةِ بل تبني المستشفيات*
- *تنادي من المنابر: "حاربوا سرطانَ الفسادِ لا أن تطعموه بدمائكم"*
فذاكرةُ التاريخِ صادقةٌ. القلنسوةُ تروي: "كنتُ رداءَ عظمةٍ فصرتُ غطاءَ عار". والعراقُ يكتبُ فصله الأخير: إما أن يدفنَ سيوفَه ليُزهِرَ ورداً على دجلة، أو ستُروى حكايتُه للأحفادِ كتحذيرٍ:
*"هكذا تموتُ الأممُ حين تصيرُ مقدساتُها سجناً لأوهامها".*
واليومَ.. القلنسوةُ تتكلمُ.
فهل من مُستمع؟
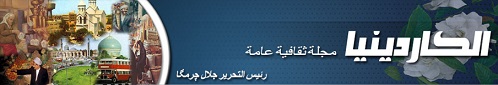
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1400 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- صورة لصدام حسين أمام ترامب تشغل العراقيين .. ما القصة؟
- طائرة تزويد وقود بوضع استنفار.. سيناريو الهجوم الجوي يقترب من إيران
- مليون دولار لكل مواطن … عرض سخي من ترامب لسكان غرينلاند
- تجربة سياحية غير مسبوقة .. أول فندق على سطح القمر يفتح أبوابه في ٢٠٣٢
- أرملة شاه إيران: "لا عودة إلى الوراء" والمواطنون سينتصرون في هذه المواجهة غير المتكافئة
- المخاطر العالمية جغرافيا جديدة لمسارات قاسية تـتسيد المشهد الدولي
- رفعت الأسد ... رحل مخلفاً تركة ثقيلة من الانتهاكات
- خاص - أزمة سيولة تربك صرف الرواتب لهذا الشهر
تابعونا على الفيس بوك