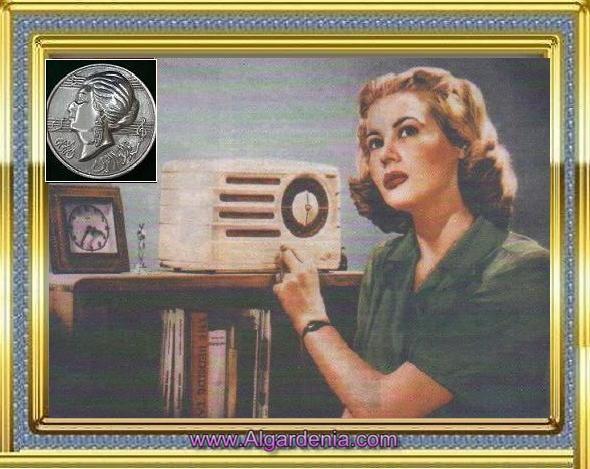أزمة المياه في العراق: سدود من الجيران وفشل من القادة
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 15 آب/أغسطس 2025 15:43

ندرة المياه محرك يفاقم التوترات الداخلية.
في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية، يواجه العراق معركة صامتة لكنها مصيرية: أزمة مياه متفاقمة تهدد الأمن البيئي والاجتماعي للبلاد. فبين تراجع منسوب الأنهار، وسياسات دول الجوار المائية، وغياب الإدارة الفعالة، يجد بلد الرافدين نفسه أمام تحد وجودي يضع قدرته على الصمود والتخطيط المستدام على المحك.
العرب/بغداد - بينما تتصدر الحروب عناوين الأخبار في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، يخوض العراقيون معركة من نوع آخر، أقل ضجيجا لكن لا تقل خطورة، وهي معركة مع أزمة مائية متفاقمة تهدد استقرار البلاد. فالتغير المناخي يجفف الأنهار، والدول المجاورة تقطع تدفقات المياه، في حين فشل القادة العراقيون في إدارة هذا المورد الحيوي.
وتعاني البلاد من أزمة شحّ مياه تعدّ الأخطر منذ أكثر من 80 عاما، حيث تراجعت الاحتياطات المائية من نحو 18 مليار متر مكعب العام الماضي إلى ما يقارب 10 مليارات حاليا.
وتنعكس آثار هذه الأزمة في جميع أنحاء البلاد، حيث تضرّرت مناطق الجنوب بشكل خاص.
وفي محافظة ذي قار، نزحت أكثر من عشرة آلاف أسرة بسبب جفاف الأنهار وانكماش الأهوار، أما في البصرة، فقد تسبّبت الملوحة العالية والتلوث الناتج عن شحّ المياه في تفشي الأمراض المرتبطة بالمياه.
وفي عدد من المدن العراقية، خرج المواطنون للاحتجاج على انقطاع المياه، الذي استمر لدى البعض لأكثر من شهر.
وقد أعلن وزير الموارد المائية في صيف 2025 تعليق خطة الزراعة للموسم المقبل، بما في ذلك زراعة القمح، بسبب نقص المياه.
ويقول الباحث حيدر الشاكري في تقرير نشره معهد تشاتم هاوس إن تناقص الأمطار وارتفاع درجات الحرارة يشكلان تحديين عالميين، غير أن ما يزيد من تفاقم الأزمة المائية في العراق هو السياسات المائية التي تنتهجها دول الجوار، لاسيما تركيا وإيران، إلى جانب فشل الإدارة الداخلية.
وخفضت السدود التركية والإيرانية تدفقات المياه بشكل حاد، بينما لم تستطع الحكومة العراقية الرد بسياسة دبلوماسية مائية فعالة أو مستدامة.
وساهم الفساد والمصالح الشخصية للنخب السياسية العراقية في إضعاف المؤسسات الرسمية، مما سمح لجيران العراق باستغلال الانقسامات الداخلية للحصول على مكاسب أحادية.
ويعتمد أمن العراق المائي بدرجة كبيرة على البنية التحتية الموجودة في دول الجوار، وعلى رأسها تركيا وإيران. ففي تركيا، يتضمن مشروع جنوب شرق الأناضول أكثر من 22 سدا و19 محطة كهرومائية على نهري دجلة والفرات، منها سد أتاتورك الضخم، وسد إيلسو الذي دخل الخدمة في 2020، ويُتهم بالتسبب في تقليص تدفق المياه إلى العراق. وأما سد جيزرة، الذي لا يزال قيد الإنشاء، فيُتوقّع أن يزيد الوضع سوءا.
ومن جانبها، أنشأت إيران سدودا ومشاريع تحويل مجرى على الروافد التي تغذي دجلة، مثل نهر ديالى (سيروان) ونهر الزاب الصغير، وقد تم توجيه هذه المياه لدعم الزراعة الإيرانية وتوليد الطاقة.
ورغم توقيع العراق مذكرات تفاهم واتفاقيات تقنية مع هذه الدول، إلا أنها بقيت دون إلزام قانوني أو تنفيذ فعلي.
وتستمر دول الجوار في استغلال هشاشة الوضع السياسي في بغداد ودمشق لتعزيز نفوذها المائي. فتركيا، على سبيل المثال، تنتهك مرارا اتفاق المياه الموقّع مع سوريا عام 1987، بإطلاق كميات تقلّ عن الحد المتفق عليه.
وأما داخليا، فإن العراق يعاني من فجوات كبيرة في الحوكمة، ويُظهر تحركا متأخرا دوما، لا يأتي إلا عند بلوغ الأزمة ذروتها.
وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت الحكومة عن خطط لبناء عشرة سدود لحصاد مياه الأمطار في المناطق الصحراوية، بالإضافة إلى منح مشروع تحلية مياه البحر في البصرة، الذي طال انتظاره، لتحالف عراقي – صيني.
ورغم أهمية هذه المشاريع، إلا أن تأخر تنفيذها يكرّر نمطا مألوفا في البلاد، حيث تغيب الاستجابة الاستباقية وتُهيمن المحسوبيات والفساد على تنفيذ المشاريع.
وتعثرت مشاريع حيوية بسبب الفساد والتدخلات السياسية. ففي البصرة، شهدت مبادرات التحلية تأخيرات متكررة وارتفاعا في التكاليف وخلافات حول العقود، وسط تقارير عن تفشي المحسوبية وغموض إجراءات التعاقد.
وترك هذا الإخفاق سكان المحافظة تحت رحمة شبكات مياه متهالكة ومعرّضين لنفس الأخطار التي تسببت في أزمة صحية كبرى عام 2018، حيث أُصيب حينها مئات الآلاف بالتسمم نتيجة تلوث المياه.
وتكرّر الأمر نفسه في عقود أُبرمت مع شركات تركية، حيث ربطت تقارير محلية إطلاق كميات مياه مؤقتة من قبل أنقرة بمنح عقود إنشاء السدود لشركات تركية، ما حول المياه إلى أداة مساومة سياسية.
وغالبا ما تكون ردود بغداد على ذروة الأزمات آنية وغير مستدامة. ففي عام 2018، وبعد انخفاض منسوب دجلة، انعقد البرلمان العراقي وطلب من تركيا تأجيل ملء سد إيلسو.
واستجابت أنقرة مؤقتا، لكنها سرعان ما عادت لملء السد. وفي يوليو 2025، زار رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني أنقرة، حيث أعلن اتفاقا مؤقتا لزيادة التدفقات المائية، لكن خبراء حذروا من أن الاتفاق لن يصمد بعد أغسطس.
ويعود جزء كبير من شبكة الري في العراق إلى سبعينات وثمانينات القرن الماضي، ويعمل بنسبة كفاءة لا تتجاوز 60 في المئة، نتيجة فقدان كميات كبيرة من المياه بسبب الاعتماد على الري بالغمر وقنوات غير مبطنة.
ولم تؤدِّ عوائد النفط العالية في السنوات الماضية إلى تحديث هذا القطاع، في ظل الفساد وسوء الرقابة، ما أدى إلى فشل مشاريع إعادة التأهيل الممولة دوليا، وعجز الوزارات عن التنسيق بشأن تقنيات توفير المياه، وهيمنة المحاصصة السياسية على قرارات الاستثمار.
وتضعف هذه الإخفاقات الهيكلية قدرة العراق على التفاوض مع دول المنبع، إذ تدرك هذه الدول هشاشة العراق السياسية، وانشغال نخبته بالصراعات قصيرة المدى بدلا من صياغة إستراتيجية طويلة الأجل لحماية أمنه المائي.
ولهذا، لا بد من إصلاحات جذرية على المستوى الداخلي والإقليمي. داخليا، على العراق إنشاء هيئة دبلوماسية مائية وطنية، بصلاحيات واضحة للتفاوض ورصد التدفقات، والتنسيق بين الوزارات والمحافظات وإقليم كردستان.
ويجب إعطاء أولوية قصوى لإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه، من خلال عمليات شراء شفافة تحدّ من الفساد، مع تحديث نظم الري لتقليل الفاقد وتحسين الكفاءة.
وإقليميا، ينبغي أن يسعى العراق إلى إشراك وسطاء دوليين موثوقين مثل الأمم المتحدة أو منظمات إقليمية لتيسير اتفاقات ملزمة مع تركيا وإيران.
ويمكن للعراق الاستفادة من انضمامه في 2023 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود، ليكون بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تنضم إليها، كإطار قانوني يدعم موقفه التفاوضي.
إن أزمة المياه في العراق ليست مجرد قضية بيئية، بل اختبار حقيقي للحكم الرشيد. وقد أظهرت أزمة البصرة عام 2018 وما أعقبها من احتجاجات، كيف يمكن لإهمال البيئة أن يتحوّل بسرعة إلى أزمة صحية واحتقان سياسي.
وإذا استمر التراخي، فإن كلفة التقاعس لن تُقاس فقط بالمياه المفقودة، بل أيضا بفقدان ثقة الناس، وزعزعة استقرار الدولة.
ويجب ألّا يكون مستقبل المياه في العراق رهينا بالجغرافيا أو تقلبات الطقس، بل رهينا بإرادة سياسية حقيقية، واتفاقات مُلزِمة، ومؤسسات قادرة على حماية هذا المورد الذي يشكّل شريان الحياة لكل عراقي.
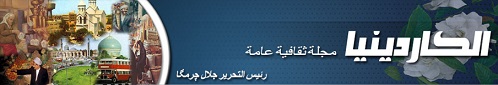
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
مقالات متميزة
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
861 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- حين تتقدّم الطائفة على الوطن: يهيمن الولاء المعكوس
- ألكسندر سولجينتسين .. الكاتب الذي فضح عالم القمع السوفييتي
- الدولة بوصفها حيادًا أخلاقيًا: في معنى العلمنة المدنية وإدارة التنوّع
- حين يتحوّل التشكيك إلى إنكار: بغداد بين التاريخ والذاكرة المؤدلجة
- الفرق بين الشجاعة والتهور
- خيالات إنهيار الولايات المتحدة الأمريكية
- لحظة الصمت
- هل نجا النظام الإيراني من تهديدات ترمب؟
تابعونا على الفيس بوك