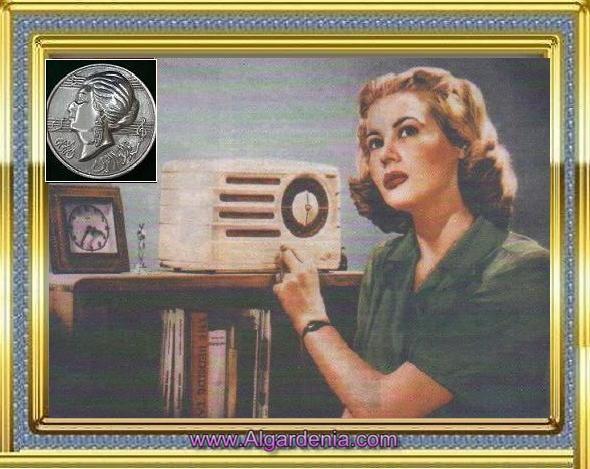قراءات في التراث البلاغي العربي
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ السبت, 27 أيلول/سبتمبر 2025 16:29
- كتب بواسطة: أ.د.نزار الربيعي

الاستاذ الدكتور : نزار الربيعي
قراءات في التراث البلاغي العربي
رفت قراءة التراث البلاغي حضورا كبيرا في الدراسات النقدية الحديثة، وذلك لاعتبارات أهمها الثراء الذي يتسم به هذا التراث من حيث تعدد مصنفاته بشكل يعكس اختلاف المشارب الثقافية لأصحاب تلك المصنفات. وأيضا نظرا لتعدد مرجعيات مشاريع القراءات الحديثة. الشيء الذي نتج عنه تنوع في إدراك الذات القارئة للموضوع المقروء، مما يعني تنوع فهم التراث وتأويله واتخاذ موقف منه. وعليه فقد غدا التصور السائد للقراءة قائما على “تصور يبدأ بتأكيد ما يقوم به القارئ من اختيار لمعنى بعينه داخل التتابع المتضام لمساق الكلمات في النص المقروء، وينتهي بأداء القارئ لهذا المعنى المختار، بما يكشف عن خصوصية فهم هذا القارئ. ومعنى هذا أن كل قراءة هي غير بريئة، قد تضيف إلى النص المقروء وقد تحذف منه حسب الظروف الذاتية والموضوعية للقارئ.
ومع ذلك فهناك مؤلفات كثيرة في الساحة النقدية الحديثة، لا تنفذ إلى صلب القراءة، وإنما “تنحصر في أهون الدوائر العملية، التطبيقية، نقلا وتقليدا، تلخيصا وعرضا، تعليقا وحاشية، استدراكا وتعقيبا. الشيء الذي أنتج قراءات متشابهة للتراث، وجعل صورة الأعمال الأدبية التراثية واحدة في أذهان بعض الدارسين وفي المقابل نجد قراءات تتجاوز الشرح والتفسير فتقدِّم قراءة خلّاقة تتأسس على وعي نظري بموضوعها، بشكل يمكّنها من خلق توازن بين جهاز قراءة التراث وأجهزة النقد العربي المعاصر، مؤكدة بذلك كون قراءة التراث هي “جزء لا ينفصل عن فاعلية جهاز القراءة الأعم للنقد العربي المعاصر كله، وأن العلاقة بين (نظرية القراءة) و(علم الأدب) ليست علاقة وثيقة تقوم على التفاعل فحسب، بل هي علاقة يميل البعض إلى جعلها علاقة اتحاد على أساس أن (علم الأدب) هو نظرية في القراءة ابتداء
عليه فإن أكبر عائق تسبب في ركود قراءة التراث في أوساط بعض الدارسين المحدثين يعود إلى غياب جدلية (التراث) و(الحداثة)؛ ففي الحقل البلاغي و قراءات تتصدى “لدراسة التفكير البلاغي، في الغالب، من منظور أحادي البعد يقع على هامش النقاش الجوهري المطروح، اليوم، في أغلب التيارات النقدية الحديثة والدائر حول إمكانية إعادة قراءة البلاغة في ضوء المكتسبات المنهجية الجديدة ولاسيما مكتسبات اللسانيات أو عدم إمكانية ذلك. الشيء الذي يدعو إلى إعادة القراءة في ضوء الشروط السابقة. وهذا ما سيدفع بالناقد إلى اختيار المنهج البنيوي لقراءة التراث البلاغي العربي، “قصد فهمه في ذاته واستجلاء أبعاد النظرية الأدبية التي يتضمنها، ثم لمحاصرة مظاهر المعاصرة فيه التي يمكن استحضارها، اليوم، للمساهمة بها في تغذية النقاش القائم، حولنا، في هذه القضايا
لما كان الحيز الزماني للتأليف البلاغي عند العرب ممتدا إلى ما يزيد عن ستة قرون، فقد رأى الناقد أن الجاحظ (255 هـ) يمثّل نقطة ارتكاز في البلاغة العربية، فمؤلفاته هي “بمثابة ذاكرة حفظت لنا أطوار العلم الأولى، وفتحت السبيل إليها كما حملت ملامح ما تلاها وتولد عنها وبذلك تكون قد قامت بوظيفة مزدوجة: استقطاب ما سبق وتمثله ثم الزيادة عليه، ونشره ليستفيد منه اللاحق ويبني عليه. ولذلك فقد قسم فصول بحثه إلى ثلاث محطات: ما قبل الجاحظ، الحدث الجاحظي، ما بعد الجاحظ.
وعليه، انطلق الناقد في قراءته للتراث البلاغي من تتبع آثار العرب الأوائل إثر تلقيهم للشعر والنص القرآني، وذلك بالتركيز على مواقفهم التي كانوا يصرفون فيها وعيهم اللغوي لأغراض فنية تتجاوز الإبلاغ العادي في لغة الاستعمال. ولذلك فقد كشفت المدونة التراثية القديمة – باختلاف مصادرها – أن التفكير البلاغي عند العرب ظهر نتيجة تفاعل عوامل ثقافية وتاريخية وحضارية، تميزت بها بنية المجتمع العربي الإسلامي، “فحملت الناس على التفكير في اللغة تفكيرا معياريا جماليا يترصد عناصر الجودة فيها ويصف الأساليب ويصنفها معتمدا ما بينها من تفاضل. وقد كان تلقي العرب الأوائل للشعر، أبرز عامل في نشأة هذا التفكير، وذلك لما له من أهمية في البنية الثقافية للمجتمع، إلى درجة أن الشعر أصبح “نمط التعبير الذي شغلهم عن التفكير في أنماط أخرى”
ونتيجة لذلك، واكبت نشأة الشعر عند العرب الأوائل حركة (نقدية) في إطار المفاضلة بين شاعر وآخر، وهي عبارة عن أخبار وروايات لا تتجاوز الانطباع والتعبير عن الانفعال الذاتي. وقد كانت غالبا ما تأتي في عبارات مقتضبة تتخلل المصادر المختلفة التي اهتمت بالتراث العربي من كتب أدب وتراجم وطبقات وغيرها.
والملاحظ أن هذه الأخبار قد شكلت “اللبنة الأولى في العمل النقدي والبلاغي، وتشير إلى بداية الاهتمام بقضية الصياغة، مثال ذلك ما روي عن أم جندب لما احتكم إليها زوجها امرؤ القيس وعلقمة فقالت لهما: قولا شعرا تصفان فيه الخيل على روي واحد. فقال امرؤ القيس: الطويل
خليليّ مرّا بِي على أمّ جُنْدُب ** لنقضي حاجات الْفُؤَاد المعذب
وقال علقمة: الطويل
ذهبت من الهجران فِي كل مَذْهَب ** وَلم يَك حَقًا كل هَذَا التجنب
ثم أنشداها جميعا. فقالت لامرئ القيس: علقمة أشعر منك. قال: وكيف ذلك: لأنك قلت: (الطويل)
فللسوط ألهوب وللساق درّة ** وللزجر مِنْهُ وَقع أهوج منعب
فجهدت فرسك بسوطك ومريته بساقك وقال علقمة:
فأدركهن ثَانِيًا من عنانه ** يمرّ كمرّ الرّائح المتحلّب
فأدرك طريدته وهو ثان من عنان فرسه لم يضربه بسوط ولا مراه بساق ولا زجره قال: ما هو بأشعر مني ولكنك له وامق. فطلّقها فخلف عليها علقمة فسمّي بذلك الفحل.
يبدو من خلال هذا الخبر تفوق علقمة على امرئ القيس في نظر أم جندب، لتعبيره الأكثر مناسبة لبيئة المجتمع الجاهلي، وذلك من خلال اعتماده لغة هادئة تعكس مدى ارتباط الإنسان العربي بفرسه، وهو ما لا نجده عند امرئ القيس.
إن هذا الخبر – وغيره – يدل “على بداية الوعي بضرورة انطلاق الأحكام من الشعر نفسه بالنظر إلى خصائص لغته، والاقتناع بأن الألفاظ وإن كانت من نفس الحيز الدلالي فإن بعضها ألصق بالموضوع من بعضها الآخر وأكثر ملاءمة للمعنى الذي قصده الشاعر ومن هنا أتت ضرورة التفكير فيها واختيارها طبق الغرض
من خلال ما سبق، يبدو أن منطلق قراءة التراث البلاغي هو المنهج البنيوي فعبره حاول خلق حوار تفاعلي بين التراث والحداثة كما وعد في المقدمة، وذلك انطلاقا من الكشف عن أبعاد النظرية البنيوية، والمتجلية في حديثه عن مفهومي (الحيز الدلالي) والاختيار). وهو المنطق نفسه الذي نجده في معرض حديث الناقد مثلا عن تصور الجاحظ للبيان الذي يحتل معنى واسعا يضم طرق الدلالة والوسائل التي تمكن المتكلم من أداء المعنى، وذلك في قوله: “وهذا معنى عام يتسع للغة ولغيرها، ويدخل في مشغل علاميّ تمخض، اليوم، عن علم قائم الذات يطلقون عليه (علم العلامات) إلى هنا نجد الناقد في تصوره الحداثي عن التراث البلاغي، لكونه وقف عند أبعاد تتقاطع مع النظريات الحديثة فيه ولم يقع في الإسقاط. وهو ما يؤكده قوله عقب تحليله لبعض روايات العرب الأوائل وأخبارهم: “فبيّنٌ من هذه الروايات أن العرب تجاوزت مجرد التذوق والانفعال إلى ربط البراعة في نظم الشعر بالبراعة في صياغة الصورة الفنية، ولكن بدون أن يتحول ذلك إلى دراسة منظمة وتحليل وتعليل لهذه الصور والأساليب، والتعريف بها والإشارة إلى أسباب الحسن. وهي مباحث لم تهيئهم حياتهم العقلية البسيطة في ذلك الوقت إلى خرقها مما سيتوفر لغيرهم بمفعول حوادث أخرى تجدّ في المجتمع العربي الإسلامي
نخلص تقتضي كل قراءة للتراث تجنب إعادة النصوص بالكيفية نفسها شرحا وتلخيصا، لأن هذه القراءة لا تعدو في أحسن الظروف أن تنتج النص المقروء نفسه. أما البديل فهو قراءة منتجة قادرة على استكناه المخزون الفكري والأدبي للنصوص، قراءة لا تدعي الحياد أبدا لأن القارئ لا يمكنه التجرد من ذاته وهو يمارس فعل القراءة، بل يكون موجها للمعنى بشكل يسعى من خلاله إلى خلق تواصل مثمر بين التراث والحداثة
يبقى المنهج البنيوي نسبيا في مقاربة الخطاب الأدبي الذي يعتمد لغة عصيّة على المعالجة العلمية. كما أن هذه النسبية لا تقتصر على المنهج بل تشمل التراث المقروء أيضا، أن البلاغيين القدامى توقفوا عند ضبط بلاغة اللغة العربية ووجوه بيانها لا بوصف التجارب الأدبية الشخصية والأساليب الملائمة لها، مما يتطلب إعادة قراءة هذا التراث في ضوء المناهج الحديثة.
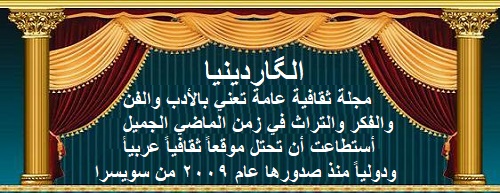
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1628 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- مجتمعنا العراقي بين ظاهرة حسون الأمريكي وظاهرة البريكية
- نيوزويك: هؤلاء القادة أسقطتهم أميركا عبر التاريخ
- في الهديلِ أهزُّ مَهْدِي
- اتساع نطاق الاحتجاجات في إيران .. و"إيران إنترناشيونال" تحدد هويات ١٦ قتيلاً
- بانتظار الزلزال المقبل: إيران تترقب لبنان يتهيّب سوريا تفاوض
- تقرير: خامنئي يخطط للفرار إلى موسكو إذا تصاعدت الاضطرابات في إيران
- في الذكرى ١٠٤ لتأسيس شرطة العراق
- التعري التدريجي
تابعونا على الفيس بوك