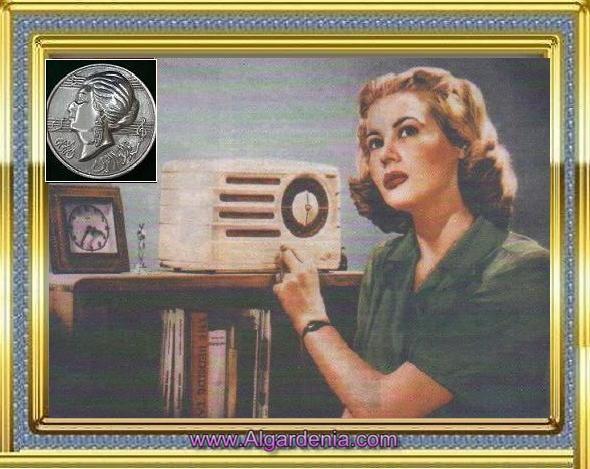الدولة القومية أم الدولة الدينية
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 20 آب/أغسطس 2025 06:20
- كتب بواسطة: د.ضرغام الدباغ
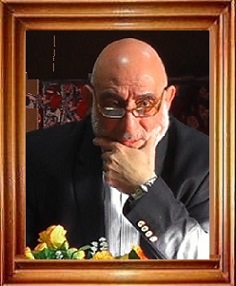
د.ضرغام الدباغ / برلين
الدولة القومية أم الدولة الدينية
كنت أناقش مرة أحد الإسلاميين، ورغم أنك يصعب أن تسحب أحدهم إلى مناقشة علمية، ولكني بصبر شديد أوصلته لنقطة لابد أن يقر بالعجز، أوصلته للعجز حقاً، وكان عليه أن يعترف، بأن الرأي الذي طرحته كان صحيحاً ومطابق للعلم والمنطق وأحداث وتجارب التاريخ، ولكنه لم يشأ الاعتراف بذلك فأعتصم بآخر ذرة من الغش والفشل بقول " نحن لا نبحث عن الدنيا بل نريد الآخرة ".
فأجبته: أن الله خلقنا من أجل الدنيا .. واعطانا دنيا جميلة وطيبات ومال وابناء لنستمتع بها، لا من أجل الموت، أن نفكر وأن نعمل وننتج ونقدم البشرية نحو الأفضل. مبتكرين، مكنشفين، مطورين، وبتقديري أن الخطاب السياسي الديني لكي يتلائم مع العصر ليصبح مفهوماً أولاً ومقبولاً ثانياً... أن لا يكثر الصدام مع الناس ومصالحها المتجددة .. فليحاولوا تفهم العصر ومشكلاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية .. التطور والتحول طبيعة الحياة، ولو شاء ربك لجعلها في أسلوب وتفاصيل حياة الأولين ...!
التيار الاسلامي في تركيا وماليزيا نجح لأنه تفهم الناس، وتوصل عن طريق الإقناع والعمل والأداء الممتاز عبر فستان قصير او طويل وبلحية أو بدونها، وسواها من مظاهر، إلى كسب قناعات الناس وبالتالي أصواتهم في صناديق الانتخابات في مجتمعات متقدمة حضارياً .. ترغم حتى من لا يؤيدك على الاعتراف والاعجاب بها، توصلوا لها بطريقة لطيفة ومهذبة ... الإسلام السياسي في أقطارنا .. إن شاء أن يبقى متقدما عليه أن يتفاعل مع الناس لا يقف عثرة في طريق التقدم وأن يتفهم الحداثة ومتطلباتها .. بالقوة لن يتحقق شيئ ... فالاسلام حين نزل كان تقدمياً بالنسبة لمجتمع 610 / م، كان 3 من قيادة الحركة من العبيد (صهيب الرومي، بلال الحبشي، سلمان الفارسي) وحرم وأد البنات، وتشريعات عائلية واجتماعية متقدمة، فكان الاسلام نفض لغبار الجاهلية والتخلف وفجر سيحلق بالعرب والمسلمين إلى بناء دولة متقدمة حضارياً، وفي بناء الدولة واسسها، وثقافيا وعلمياً.
واليوم إن شاءت التيارات السياسية الاسمية أن تتقدم، فيجب ان تكون برامجها ومناهجها متقدمة، وخطابها السياسي / الثقافي أن يكون متقدما حضارياً وأن تلمس الجماهير ذلك،
صفة فريدة: الألتحام بين الفكر القومي العربي والإسلام
واستطراداَ في مناقشة فكرة الدولة القومية، نتيقن أنها ليست فكرة إقطاعية. ولو كان الأمر كذلك لكانت أوربا قد أدركته خلال عصور الهيمنة الإقطاعية الطويلة على المجتمعات الأوربية، كما أنها ليست بورجوازية، فلو كانت كذلك فكيف أنتبه لها أبن خلدون بهذه الدرجة من الوعي. أن فكرة الدولة القومية هي جزء من الوعي السياسي لأي شعب يحس ويشعر بكيانه ويدرك أبعاد وحدود بلاده ومصالحه الحيوية الاستراتيجية والاقتصادية في المقام الأول. كما يشعر بلغته وتميزها، وثقافته وتأريخه. فقد كانت حقيقة تاريخية قد ترسخت منذ العصور البابلية والآشورية، أن جبال الأناضول شمالاَ وجبال زاغروس شرقاَ مثلت الحدود الطبيعية لمنطقة كانت على الدوام مرتعاَ لشعب سام يتألف أساساَ في معظمه الغالب من أقوام هاجرت من شبه الجزيرة العربية واستوطنت أحواض الأنهر، ومضت تواصل تثبيت ألوانها الثقافية، وتكتسب ملامح محددة بمرور الوقت، أنماط معيشة واقتصاد، ثقافة ولغة، عادات وتقاليد، شدتها مفردات الحياة وأحداث تاريخية إلى بعضها البعض. وقرأنا في الألواح البابلية لأول مرة كلمة عرب، عربو، أرابيا، بحدود ألف قبل الميلاد فصاعداَ.
ويكتب الفيلسوف الهنغاري المعاصر جورج لوكاس (Georg Lukács/ (1885–1971)) شيئاَ يقارب ما نذهب إليه : من أن لا قاعدة نهائية للمسالة القومية، فهذه تتشكل وتتكون وتنعقد شروطها وصفاتها بصورة قد تتفاوت من مكان لآخر ومن مرحلة لأخرى، فيقول : " وعلى نقيض الوضع في إنكلترا أو فرنسا حيث كان التوجه السياسي لأمة قد تحقق فعلاَ بشكل أساسي عندما طرح التصور الاقتصادي للرأسمالية، مسألة الثورة الديمقراطية البورجوازية (القومية) على جدول الأعمال. ولكن تطور ألمانيا قد انطوى على تناقض، وهو أن المجتمع البورجوازي الناشئ كان عليه أن يحقق الوحدة القومية أولاَ وأن تحقيق الوحدة القومية أصبحت المسألة المحورية من ثورتها الديمقراطية البورجوازية ".
وحول المسألة القومية أيضاَ، وانطلاقاَ من فكرة أننا لا يمكننا أن نحكم أو أن نقيم أحداث جرت قبل ألف وأربعمائة عام بمقاييس اليوم، إذ لا بد من الأخذ بالاعتبار، الظروف الموضوعية والذاتية لتلك الأزمنة، والأمر كذلك فعلاَ، فيقول الأستاذ البريطاني (اللبناني الأصل) البرت حوراني، إن فكرة القومية العربية الحالية اكتسبت قوة سياسية في القرن العشرين ولكن: " إذا ما توغلنا في الماضي نجد أن العرب كانوا دوماَ يحسون إحساساَ فريداَ خاصاَ بلغتهم، وأنه كان حتى لما قبل الإسلام إحساس عرقي، أي نوع من الشعور بأن وراء منازعات القبائل والعائلات وحدة تضم جميع الناطقين بالضاد والمنحدرين من القبائل العربية ".
كيف نتوصل إلى مقاييس وأحكام معاصرة، والأهم أنها ممكنة التحقيق(feasible) في ظروفنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة والمستقبلية، والتي هي بالطبع أعقد من الظروف التي عاصرت الدولة الراشدية، أو الأموية أو العباسية وما بينهم من تجارب صغيرة (الفاطمية والأغالبة، والأموية في الاندلس) وكيانات السامانيين والطاهريون، وغيرهم ... الكيانات العائلية في فارس وما وراء النهر (لاحظ الجدول)...!

ببساطة شديدة نتوصل إلى حقيقة موضوعية، أن الدولة الإسلامية كانت تشهد محاولات إنشقاقية متوالية لإسباب شتى، في مقدمتها العامل القومي. والانشقاقات لذلك نجد الانشقاقات المهمة تركزت في مشرق الدولة العباسية، وكانت تهدف في جوهر الامر الأنفصال السياسي والاقتصادية والثقافي، رغم بقاء الاسلام كدين رسمي للدولة. بخلاف الانشقاقات في المغرب كانت تبقي الكيان تحت جناح الدولة العباسية بدرجات متفاوتة. ما عدا الدولة الفاطمية كانت أنشقاقا مذهبياً وخروجا صريحا عن الخلافة.
يبدو لنا واضحا، أهمية العناصر التي تقف وراء حركات الأنشقاق. ففي مشرق الامبراطورية، هناك في اواسط آسيا خليط من القوميات والديانات القديمة، والجنوح للأنشقاق شأن مورس بكثرة، وفي مبكر الدولة العباسية وفي اوج قوتها. كما عاد الاختلاط دون حدود وقيود بالأقوام الغير عربية، إلى نشوء مجتمع هجين فشاعات العادات والتقاليد التي لم يكن العرب يعرفونها. وخلق وسط ثقافي يشجع الدعوة للأنشقاق. وبالفعل فإن أحدى أولى الكيانات المنشقة كانت قياداته مقريبة من ابو العباس السفاح، وأبو جعفر المنصور (ابو مسلم الخراساني)، والبرامكة الذين ثبت خيانتهم للثقة التي منحها لهم الرشيد، وكذلك كان مؤسس الدولة الطاهرية (طاهر بن الحسين) مقربة من السلطة العباسية (للمأمون).
في مشرق الدولة كان الجموح لتأسيس كيانات قومية، هو المحرك الاساس، رغم أن عصر الدول القومية لم يكن قد حل تماماً بعد، وإضافة لفكرة الدول القومية، لم يكن الأمر يخلو من تأثيرات طائفية، وخلافات عقائدية، لأن تاريخ الشرق حافل بالبدع والانحرافات العقائدية. تشع بالتأثيرات على سلامة الفكر والعقيدة الاسلامية.
الأغالبة(800م ـ 903م)/ الطولونيون(868م ـ 905م)/ الفاطميون(912م ـ 1171م)/ الدولة الاموية في الاندلس(756م ــ 1031)/ دول الموحدون(1121م ــ 1269م)/ وكيانات الخوارج(كيانات وحركات لم ترتقي لمستوى الدولة).
دول الاغالبة والطولونيون، والفاطميون، والدولة الاموية في الاندلس والموحدون، كانت كيانات أسرية، ولكنها لم تفتقر للبواعث الآيديولوجية، وتفاوتت هذه الأنظمة والكيانات بدرجة ولائها للخليفة العباسي, ولكن حتى في ظل وجود علاقة، فإنها كانت شكلية لا تتعدى الولاء المعنوي لخليفة المسلمين(الدعاء بأسمه في المنابر)، دون أن يرتب هذا الولاء أي التزمات مالية أو عسكرية.
الكيانات الخارجة عن الدولة المركزية، علنا أم ضمناً قضية هامة جداً، تشير لنا أن الدولة الدينية الصرفة لم تتوجد إلى في ظل الدولة الراشدية وتصدعت في نهايتها قبل ان تكمل الثلاثين عاماً. وبتقديري، الاحوط والاسلم هو تنظيم علاقة بين الدول الاسلامية الحالية على أختلاف مناهجها السياسية ورؤيتها إلى القضايا الاجتماعية والسياسية، على أن تكون هناك مصالح يرعاها تنسيق سياسي / اقتصادي بدرجة عالية من الدقة، عبر منظمات عمل وتنسيق توفر حدا كبيرا من العمل الجماعي وتبادل المنافع المشتركة، تضمن مصالح المسلمين في كافة الاقطار بدرجة متكافئة.
ولكن هذه ليست قضية نزاع، رغم ان البعض يحاول أن يجعلها كذلك، فليس هناك تناقض يستحق هذا العناء، فكل من يعيش على أرضنا هو مواطننا، اي كانت قوميته وديانته، وخاصة ليس هناك تناقض بين الاسلام والعروبة، فمن المؤكد أن لا إسلام بلا عروبة، والموقف من العروبة يحدد الموقف من الاسلام بدرجة كبيرة، فلنجد نقاط الالتقاء لا نقاط الاختلاف، وفي النهاية سيحدد دستور الدولة ملامح المجتمع ونظام الحكم وأبعاده.

فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
875 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
تابعونا على الفيس بوك