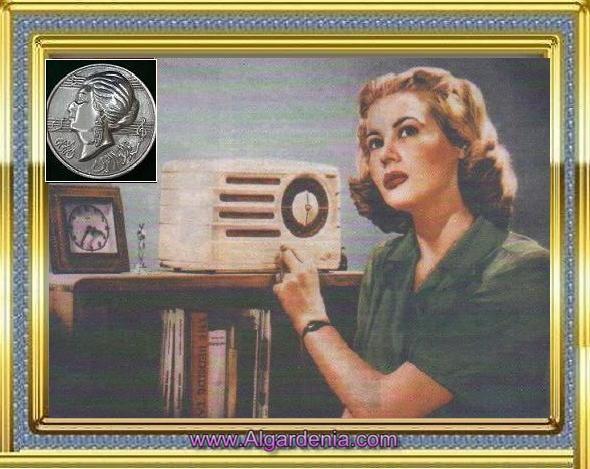بين الشيخ والمختار: طبائع المكانات واختلال البيئات
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 24 تموز/يوليو 2025 15:39
- كتب بواسطة: ابراهيم فاضل الناصري
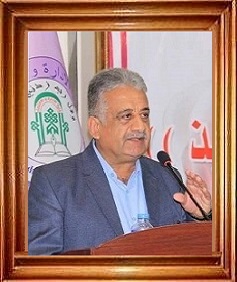
إبراهيم فاضل الناصري
بين الشيخ والمختار:طبائع المكانات واختلال البيئات
لكل بيئةٍ طبائعها، ما يجعلها تولّد أنظمتها الاجتماعية وأساليبها في القيادة والإدارة، فليست السلطة في المجتمعات البشرية قالبًا يُصبّ على الجميع، بل هي تجلٍّ للوجدان الجمعي، مرآةٌ للعلاقات، وانعكاسٌ لطبيعة المكان. ومن هنا:
فإن الريف والبادية، بما فيهما من امتدادٍ أفقي للقرابة وعمقٍ راسخ للعُرف، يُنبتان نمطًا من القيادة يقوم على المشيخة والزعامة، حيث يتقدّم الجماعة رجلٌ يُحكم لا بمرسوم، بل بهيبةٍ تُبنى على النسب والحكمة وسداد الرأي.
أما المدينة، فهي بنت القانون، ونتاج التنوع، وميدان التعاقد المدني، حيث تتعدد الانتماءات وتتشابك المصالح، فلا يصلح لها شيخٌ ينطق باسم الجميع، بل مؤسسات تُمثل الجميع. هناك، يتجلى دور المختار وعميد الأسرة في تنظيم الحيّ، لا في فرض الهيمنة عليه، وتنشأ السلطة لا من الدم بل من النظام.
غير أنّ التداخل بين هاتين المنظومتين، في حاضرنا المعاصر، أنتج مشهدًا مشوّشًا، اختلطت فيه الأدوار، وتقمّص فيه بعض أبناء المدينة شخصياتٍ قبلية أو زعاماتٍ موروثة، توهّمًا أن في ذلك عودةً إلى الأصالة، أو اقترابًا من القوة. فوقع المحظور: مدينةٌ تنسلخ عن مدنيتها، وريفيّةٌ مستنسخة في غير تربتها.
هذه المقالة ليست دعوةً للفصل أو القطيعة، بل وقفة للتأمل والتفريق، لتبيان أن لكل بيئةٍ نظامها الذي يليق بها، وأن الخلل لا في التراث، بل في إساءة استخدامه حين يُنقل خارج سياقه.
وفي كل مجتمع بشري تنشأ مع الزمن منظومة من العادات والأعراف، لا تعبّر فقط عن طريقة الناس في العيش، بل تشكّل أيضًا أساسًا لطريقة حكمهم وإدارتهم وتنظيم علاقاتهم. ومن بين أبرز ما يتمايز به البشر، هو أسلوب القيادة، إذ تختلف أنماطها باختلاف البيئات، وتتكيّف مع الواقع الثقافي والاجتماعي والمعيشي لكل محيط.
فالريف والبادية — وهما بيئتان تتسمان بالبساطة والاستقرار النسبي والروابط القَبَلية أو العائلية العميقة — تُدار وتُقاد منذ قرون بمنظومة "المشيخة" أو "الزعامة". وهنا لا يكون القائد موظفًا رسميًا أو منتخبًا، بل هو شخصية كارزمية ذات مكانة نابعة من العُرف، يتقدم الناس بالحكمة والمروءة وسعة الصدر والنسب، ويُطاع لا بسيف القانون، بل بسلطة التاريخ الاجتماعي. فشيخ العشيرة أو زعيم القرية هو مرجعٌ لحل النزاعات، وحَكَمٌ في الخصومات، وضامنٌ للسِلم الأهلي.
أما في المدينة، فهي كائنٌ آخر تمامًا. المدينة، بتعقيدها وتنوعها وتعدد مصالحها وهوياتها، لا تقوم على رابطة الدم بل على "العقد المدني". لذا تنشأ فيها أدوات قيادة وإدارة تختلف في جوهرها ومنطقها؛ فـ"المختار" هو ممثل الحيّ، لا وصيّ عليه، و"عميد الأسرة" هو مرجعٌ داخلي في دائرة البيت، لا في الحارة بأكملها. القيادة هنا تنبع من النظام، وتتغذى من القانون، وتخضع للمساءلة المؤسسية، لا لموازين العُرف والولاء الشخصي.
غير أن ما نشهده اليوم في كثير من المدن العربية — والعراقية خاصة — هو اختلالٌ في هذا التوازن الطبيعي بين البيئة وأسلوب إدارتها. فبعد موجات النزوح من الريف والبادية إلى المدن، وتكاثر الأحياء الحضرية ذات الطابع العشائري، بدأت المدينة تفقد شيئًا فشيئًا طبيعتها المؤسسية، وراحت تستعير منطق الريف دون أن تُعيد تكييفه.
تجد في قلب الحيّ المدني "زعيمًا" يُستشار كما يُستشار شيخ القبيلة، وتُقام جلسات عرفية في بيوت الوجهاء بدل اللجوء إلى المحاكم، وتُحلّ الخلافات على قواعد النَسَب لا على منطق القانون. بل إن بعض أبناء المدينة، ممن لا يمتلكون انتماءً عشائريًا واضحًا، باتوا يتقمصون شخصيات ريفية أو قبلية، ظنًّا منهم أن ذلك هو طريق الوجاهة والهيبة، وأن مظاهر القوة لا تُكتسب إلا بترديد شعارات العشيرة، ولبس رداء الشيخ، واعتلاء صهوة التقليد.
لكن الخطر هنا ليس في التقمص وحده، بل في فقدان المدينة لروحها المدنية. إذ كيف يُرجى للمدينة أن تنهض بمؤسساتها، إن كانت تنسخ في إدارتها نماذج لا تنتمي إلى نسيجها؟ وكيف يُنتظر أن يسود فيها القانون، إن كان الاحتكام يُعاد إلى ميزان العُرف بدل سلطة القضاء؟ إن الخلط بين بيئة المشيخة وبيئة المختارية يُنتج نموذجًا هجينًا، لا هو مدني ولا هو عشائري، بل واقعٌ رماديّ يسوده التداخل والالتباس وفوضى المرجعيات.
ولا يعني هذا التقابل تقليلًا من قيمة الأعراف القَبَلية أو النُظم العشائرية، فهي منظومات اجتماعية عريقة لعبت دورًا مهمًا في الحفاظ على التماسك في بيئاتها. لكنها تفقد فاعليتها عندما تُنقل خارج سياقها، تمامًا كما أن القانون المدني يفشل حين يُفرض في البادية دون مراعاة لأعرافها وتقاليدها. الخلل الحقيقي يكمن في عدم وعي الناس بهذا الفارق، وفي الاعتقاد الساذج بأن كل ما هو موروث يصلح لكل زمان ومكان.
إن المدينة لا تحتاج إلى شيخ، بل إلى مؤسسة. ولا إلى زعيم، بل إلى خدمة عامة. ولا إلى خطابات الحماسة والأنساب، بل إلى عدالة تعطي كل فرد مكانه. والمختار، إن فُهِمَ دوره، ليس شيخًا في عباءة مدنية، بل هو موظف إداري يمثل أهل الحيّ في الإطار الرسمي، لا ناطق باسم قبيلة أو عشيرة. والمجتمع المدني لا يُدار من دواوين الرجال بل من ساحات الحوار المفتوح، ومن مؤسسات تؤمن بأن السلطة مسؤولية لا امتياز، وبأن القيادة فنٌ في خدمة المجموع، لا وسيلة لتسويق الذات.
والوعي بالمكان هو أول شروط الانتماء إليه. ومن لا يُدرك طبائع مجتمعه، يوشك أن يصبح غريبًا فيه، ولو وُلِد في قلبه. والمدينة، بوصفها كيانًا حيًّا معقدًا، لا يمكن أن تُدار بمنطق غيرها، ولا أن تُختزل في رموز لا تشبهها. لذا، فإن أعظم ما يمكن أن نُهديه لمدننا اليوم هو أن نُعيد إليها وعيها بذاتها، وأن نُفرّق بين ما هو أصيل وما هو مناسب، بين ما هو تراث وبين ما هو ملائم. فليس كل ما ورثناه يصلح أن نُطبقه، وليس كل ما يلمع من ماضينا هو ذهب حاضرنا.
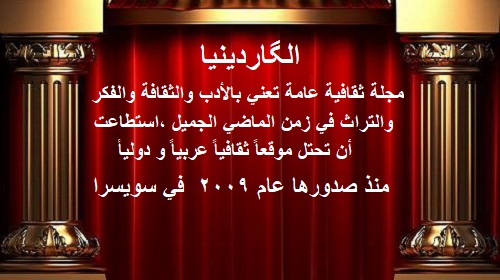
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
795 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- مسلسل_عمر - الحلقة السادسة
- طرائف رمضانية - شيطان في المسجد!!
- لماذا سمي شهر رمضان بهذا الاسم وهل له أسماء أخرى؟
- حول الإعجاز العددي للقرآن الكريم
- قصة مدفع "الحاجة فاطمة" من ميادين الحروب إلى طقس رمضاني
- العراق على حافة "حرب الإسناد": احتمالات انخراط الفصائل في صراع واشنطن وطهران
- جهاز الخدمة السرية يقتل رجلاً بعد اقتحامه محيط الحماية في منتجع ترامب بفلوريدا
- "ثلاثة أسماء في مظروف مغلق".. إيران تستعد لاحتمال مقتل مرشدها بضربة أميركية أو إسرائيلية
تابعونا على الفيس بوك