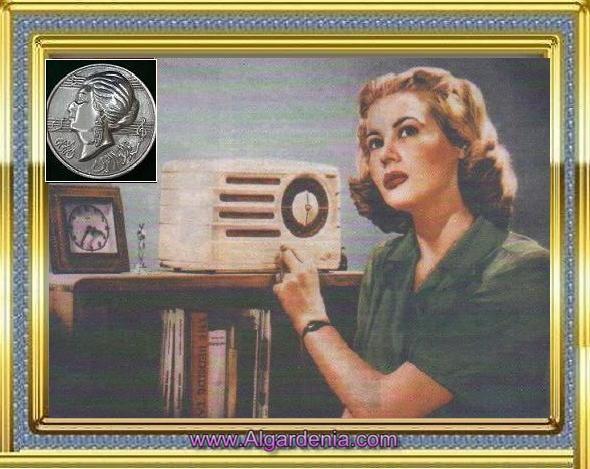بين مواكب الاحزان وبين مختبرات الذكاء بات الطريقٌ مقطوع
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 13 آب/أغسطس 2025 21:39
- كتب بواسطة: قلم باندان
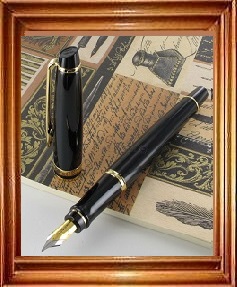
قلم باندان
بين مواكب الاحزان وبين مختبرات الذكاء بات الطريقٌ مقطوع
في مفترقٍ حاد تتزاحم عليه المواكب والمختبرات، نقف وقلوبنا تميل إلى الماضي فيما عيون العالم تحدّق في الغد. تُحلِّق أممٌ إلى المريخ وتفكّ شِفرات الخلية، وتُبرمج عقولًا إلكترونية تتعلّم وتبتكر، بينما ننفق أثمن ما نملك—الزمن والإمكان—في إعادة تدوير الانفعال. لسنا بإزاء خصومةٍ مع الدين، بل مع تحويل الطقس إلى إدارةٍ للوعي وبديلٍ عن مؤسسات التنمية. بين حزنٍ يُستَدرُّ كاقتصاد، وعقلٍ يُهمَّش حتى في المدارس والمستشفيات، تُصاغ السياسة على هيئة مواسم وتتقلّص الدولة إلى خيمة. هنا تحديدًا يتبيّن الخلل: حين تصبح الذاكرة الدينية ذريعة لإبطاء المستقبل، ويغدو الانفعالُ بديلاً عن الفعل. لذلك يبدو الطريق—بين مواكب العزاء ومختبرات الذكاء—مقطوعًا بسوء الأولويات لا بضيق الإمكانات.
في الوقت الذي نحيا في زمنٍ تتسابق عبر اواره الأمم نحو الفضاء، وتُهندس الجينات، وتُذهلنا الروبوتات بقدراتها، ويصدعنا الذكاء الصناعي بصرخاته، ننطوي نحن على سذاجاتنا الازلية، ونُعلّق مصيرنا على خطاف طقوسٍ متكررة. المشهد مفزع: مشاريع التنمية مُعلّقة، المصالح العامة متوقفة، الإبداع غائب، والعمران مُهمَل. كل شيء يتجمد إلا المآتم، وكل الموارد تُصرَف إلا على مواسم اللطم. كأن البلاد تحولت إلى ماكينة ضخمة لا تنتج سوى الحزن، تُدار عجلاتها بأموال الشعب وطاقاته فيما يشبه احتفالاً جنائزياً بلا نهاية.
لكن المسألة أبعد من كونها انشغالًا بطقوس على حساب مشاريع النهضة؛ نحن أمام صناعة كاملة، اقتصادٍ من الحزن، ومنظومة مدروسة لإعادة إنتاج التخلف عبر تدوير طقوسه.
إنها سياسة بامتياز: تحويل الذاكرة الدينية إلى منصة سلطة، وترويض الوعي الجمعي على الطاعة عبر إدمان الحزن الجماعي.
المشكلة ليست في إقامة الشعائر في المواسم، بل في جعلها المحور الوحيد للحياة العامة.
كيف لنا أن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي والمستشفيات تتداعى؟ كيف نطمح للابتكار والمدارس تَخور؟ الدولة حين تعجز عن صناعة التنمية تجد في صناعة الطقوس ملاذًا مضمونًا؛ فهي الأرخص من بناء الجامعات، والأكثر كفاءة في شلّ إرادة الناس. في كل موسم عزاء، يُعاد تعريف المواطن لا كفاعل في مشروع وطني، بل ككائن انفعالي وجوده مرهون بصفته "مستمعًا" أو "لاطمًا".
وليست الشعائر هنا مجرد ممارسة شعائرية روحية، بل باتت رأس مال سياسي. المال العام يُحوّل إلى خيم ومواكب، بينما المدارس تتساقط جدرانها والمستشفيات تئن. العقول التي يمكن أن تُحدث الفرق تُدفع إلى الهجرة، بينما يبقى الداخل سجين دورة لا نهائية من الرثاء.
الخطير أن هذه المنظومة تقتل أي احتمال لنهضة. فالمجتمع المبرمج على الحزن الجماعي يفقد حماسه للبناء، لأن الذاكرة المهيمنة تُقنعه أن المجد في البكاء على ما فات، لا في صناعة ما سيأتي. وهنا يتجلى التناقض الأليم: أن نستورد تقنيات الذكاء الاصطناعي لندير بها بثّ المجالس، بينما نفشل في بناء مختبر واحد يبتكر تلك التقنية.
الدين الحقيقي – كما في روح التشيع الأصيل حيث قال الإمام علي: "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً يُحرّر طاقة الإنسان، لا أن يسجنه في حلقة مفرغة من الطقوس. جوهر الأزمة ليس بين الدين والدنيا، بل بين العقل والخرافة، بين البناء والهدم.
الحل الجريء يكمن في تحرير الشعائر من عباءة الدولة: فلتكن حرية شخصية لا عبئاً عاماً، ومواكب تعبيرًا فرديًا لا ميزانية رسمية. الأموال التي تُنثر على الخيم واللطم كفيلةٌ ببناء جامعات تبتكر ومستشفيات تشفي. آن الأوان لأن نستلهم من تراثنا قيم العمل لا البكاء، وأن ندرك كما حذر الإمام علي: "ارحَم نفسك من خدمة من لا يرحمك".
وهنا تكمن الفاجعة العظمى:
لسنا بحاجة لاحتلال أجنبي ليشلّ إرادتنا؛ فقد أتقنّا فنّ استعمار أنفسنا. حوّلنا الدين إلى أداة ضبط اجتماعي، وصنعنا من الحزن اقتصادًا، ومن الطقوس جدارًا يحجب الضوء عن العقول. لم يعد المستعمر بحاجة لجيوش أو مدافع، فالدولة تتكفل بإدارة شعبها على طريقة "الهيمنة الناعمة": غمره بالانفعال حتى ينسى الفعل، وتخديره بالشعائر حتى يعاف التفكير، وشغله بالماضي حتى يفرّط بالمستقبل. هذا هو الاستعمار الأخطر، لأنه ينبع من الداخل، ويتجذر في الثقافة، ويتزيّن برداء القداسة، حتى إذا أردت مقاومته، وُصِفت بالخيانة. وإذا لم نكسر هذه الحلقة بأيدينا، فسنظل نكتب تاريخنا بدموعنا، بينما يكتب الآخرون مستقبلهم بعقولهم.
ليس الخلاص في إلغاء الشعائر، بل في ردّها إلى مقامها الروحي وإخراجها من دفتر الإنفاق العام؛ فالدولة تُبنى بجامعةٍ ومختبرٍ ومستشفى، لا بسردق ومِكبّر صوتٍ. لنجعل الذاكرة وقودًا للعمل لا إقامةً دائمة في الرثاء والاحزان، ولنحوِّل المواسم إلى منصّات خدمةٍ ومعرفة: تبرّعاتٌ للبحث العلمي، بعثاتٌ للطلبة، ومبادراتٌ لإحياء المدرسة والشارع والمستشفى.
عندها فقط نكسر هيمنة «الانفعال» ونحرّر «الفعل»، فنستعيد من الدين قيمته العملية: كرامةُ الإنسان، وعدالةُ الفرص، وواجبُ الإعمار. إن كنا قد أتقنّا استعمارَ ذواتنا بالحزن، فآن لنا أن نحرّرها بالعقل والعمل. ولن يصل ما انقطع من الطريق إلا إذا عُدِّلت البوصلة: من إدارة الحشود إلى بناء الإنسان، ومن بكائيات الأمس إلى مختبرات الغد. حينها، لا يبقى الطريق مقطوعًا… بل مفتوحًا على مستقبلٍ نصنعه بأيدينا.
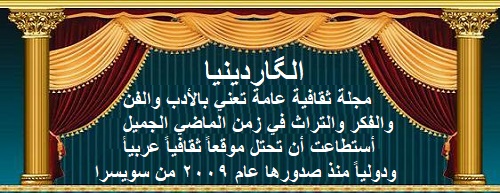
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1232 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- طرائف رمضانية من التراث العربي
- كلمات على ضفاف الحدث العراق والارقام يكحل العين ...!!
- لماذا ستصعّد إيران الضربات العسكرية الأميركية وخطر الغرق في مستنقع نِيت سوانسون / اللواء الركن علاء الدين حسين مكي خماس
- عودُ الثقاب في إقليمٍ مكدّس بالوقود هل نحن أمام حربٍ
- الدهرُ يومان ... يومٌ لك ويومٌ عليك
- كتاب معسكر بعقوبة / الجزء السابع و الأخير
- من ذكرياتي " مذكرا عبد العزيز القصاب " - الحلقة الثانية
- بغداد تكشف تجنيد آلاف العراقيين للقتال مع الجيش الروسي وتوقف شبكة متورطة
تابعونا على الفيس بوك