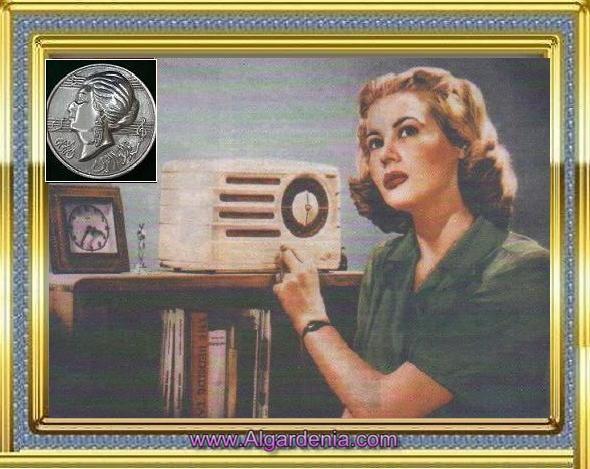الزمن المصلوب: العراق بين طقوس الهدر وحلم التنظيم
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 03 أيلول/سبتمبر 2025 15:33
- كتب بواسطة: ذو النورين ناصري زاده
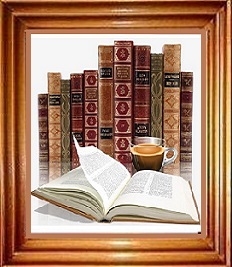
ذو النورين ناصري زاده
الزمن المصلوب: العراق بين طقوس الهدر وحلم التنظيم
في التاريخ الطويل لبناء الأمم، لم يكن الذهب ولا النفط هو العامل الحاسم في صعود الدول، بل الوقت. فالزمن ليس مجرد إطار لحركة الحياة، بل هو المعيار الأول لجدّية المجتمعات وقدرتها على التنظيم والإنتاج والتقدّم. في الدولة الحديثة، يُقاس احترام الإنسان بمدى احترام وقته، وتُقاس قوة المؤسسات بقدرتها على ضبط إيقاع الزمن وتوجيهه نحو الأهداف الكبرى. ومن المؤسف أن بعض الدول، رغم امتلاكها للموارد والثروات، تُبدّد أثمن ما لديها: الوقت. وبين تلك الدول، يبرز العراق كمثال صارخ على هذه المفارقة؛ بلد يمتلك تاريخًا عريقًا وموارد هائلة وطاقات بشرية واعدة، لكنه يفرّط بمنهجية مؤسسية في قيمة الزمن، ويخضعه لمزاج الطقوس والمجاملات السياسية، في ما يشبه الانتحار البطيء للدولة.
في المجتمعات الحديثة، يُعدّ الوقت من أثمن الموارد التي تملكها الدول والمجتمعات. فمستوى تحضّر أي دولة لا يُقاس فقط بما تمتلكه من ثروات طبيعية أو موارد بشرية، بل بقدرتها على إدارة هذا المورد الثمين واستثماره في بناء الحاضر وصياغة المستقبل. ومن هنا، يعيش العراق مفارقة مؤلمة: بلد غني بالموارد، فقير في إدارة الوقت. لقد تحوّلت المناسبات الدينية والطائفية في العراق إلى محطات شلل مؤسسي، وذريعة لتعطيل الدولة عن أداء وظائفها، في طقس سياسي مغلّف بغلاف ديني، لكنه في جوهره انتهاك ممنهج لقيمة الزمن وإنتاجية المجتمع. فالعطل الرسمية أو الجزئية التي تُعلن مع كل مناسبة دينية، لا تُدار بعقلانية الدولة، بل تُمنح كـ"غنائم رمزية" لترضية هذا المكوّن أو ذاك، ضمن لعبة مجاملات سياسية طائفية تُنهك ما تبقى من فاعلية الدولة وهيبتها.
ويُشكّل تعطيل الدوام دون مبرر منطقي نزيفًا اقتصاديًا غير مرئي، إذ إن كل يوم تُغلق فيه مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص، تتوقف حركة المال والإنتاج والخدمات. ووفق تقديرات غير رسمية، فإن يوم العطلة الواحد في العراق قد يُكلّف مليارات الدنانير من الناتج المحلي، تشمل الأجور المدفوعة دون عمل، وتوقف الأنشطة الحكومية والتجارية والاستثمارية. في وقتٍ يحتاج فيه العراق إلى تسريع العجلة الاقتصادية لا إيقافها، نجد أن هذه العطل تُفرض على الجميع، دون تمييز بين من يرغب فيها ومن يتضرر منها. وفي المقابل، نجد أن الدول المتقدمة تُخطط للعطل مسبقًا وتحتسب تكلفتها بدقة، بينما تُعلن في العراق أحيانًا بقرارات مرتجلة تُتخذ في الليلة التي تسبق المناسبة، ما يعكس فوضى إدارية واستهانة واضحة بالتنظيم والتخطيط.
لقد تحوّلت مؤسسات الدولة العراقية إلى كيانات مترهلة، تفتقر إلى الانضباط الزمني والالتزام المؤسسي. ومع كل إعلان عطلة، تتراجع الكفاءة الإدارية، ويترسخ لدى الموظف والمواطن تصور مفاده أن الدوام أمر ثانوي يمكن تعطيله بسهولة لأسباب دينية أو سياسية. وهذا التعطيل المتكرر لا يشوّه فقط فكرة الانضباط، بل يُضعف من مصداقية الدولة في أعين مواطنيها، ويؤدي إلى تراكم البيروقراطية وتأجيل المعاملات والقرارات، مما يزيد من معاناة المواطن اليومية. كما أن المؤسسات التعليمية والفنية والثقافية تتعرض بدورها إلى شلل متكرر، يبدّد آلاف الساعات من وقت الطلبة والمبدعين والموظفين، ويقوّض من جودة النظام التربوي والثقافي برمّته.
اجتماعيًا، تُكرّس هذه الممارسات نمطًا ذهنيًا خطيرًا يُشجّع على الكسل والاعتياد على التعطيل، بدل ترسيخ ثقافة العمل والانضباط. كما تساهم هذه العطل الطائفية في تعزيز الانقسام المجتمعي، إذ يشعر بعض المواطنين بأن الدولة تُفضّل مناسبات طائفة دون أخرى، مما يُرسّخ حالة من التمييز الرمزي ويُربك العلاقات الاجتماعية، ويُضعف من دور الدولة كضامن للوحدة الوطنية. وعلى المستوى السياسي، تعكس هذه الظاهرة ضعف الدولة المركزية وهيمنة الولاءات الجزئية على القرار العام. فعندما تُقرّر الحكومة أو الحكومات المحلية العطل تحت ضغط جماهيري من تيار ديني معين، فإنها تمارس شكلًا من أشكال الابتزاز السياسي المقنّع. وغالبًا ما تُتخذ هذه القرارات لا بناءً على المصلحة العامة، بل استجابة لضغوط فئوية تُوظف لأغراض انتخابية أو تكتيكية، مما يُحوّل الدولة من كيان محايد إلى طرف في النزاع الرمزي بين الطوائف، ويُضعف شعور المواطنة، ويُرسّخ منطق المحاصصة الزمنية بدل سيادة القانون والكفاءة.
معالجة هذه الظاهرة لا تقتصر على سن القوانين، بل تتطلب ثورة ثقافية وإدارية تُعيد الاعتبار للزمن كمورد وطني لا يجوز التفريط فيه. ويتطلب ذلك تشريعًا وطنيًا موحّدًا يُنظّم العطل الرسمية، ويُحدّد المناسبات الوطنية الجامعة فقط، مع تقليص العطل الدينية والطائفية إلى الحد الأدنى، وإتاحة المجال لمن يرغب بإجازة خاصة دون أن يُفرض التعطيل على الجميع. كما يستوجب الأمر إصلاح الجهاز الإداري للدولة، عبر مراجعة نظام الخدمة المدنية وربطه بالإنتاجية والانضباط الزمني، وإطلاق حملات توعية وطنية تبدأ من المناهج الدراسية وتصل إلى الإعلام والخطاب الديني، بالإضافة إلى فصل الدين عن القرار الإداري والسياسي، بحيث يُحترم الدين كمجال خاص، دون أن يُستخدم لتعطيل مؤسسات الدولة أو مقايضة الولاءات.
إن الدولة التي تفقد قدرتها على إدارة وقت الناس، تفقد تباعًا احترام الناس لها. فالزمن ليس مجرد ساعات تمر، بل هو مقياس لجدية الدولة والمجتمع في بناء الحاضر وصياغة المستقبل. والمجاملة الطائفية على حساب الزمن ليست سوى وجه آخر من أوجه الفساد واللامسؤولية. وما لم نُعِد الاعتبار للزمن كأصل وطني ثمين، سنبقى عالقين في دوامة التخلف الرمزي والتراجع العملي. فلا نهضة بلا وقت يُحترم، ولا دولة تُبنى على المجاملة. (الزمن هو هوية الأمم).
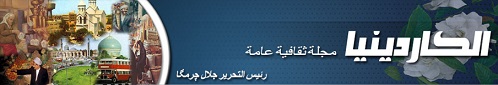
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
979 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- قصارى القول - لماذا أسس صدام حسين مجلس التعاون العربي؟
- ابتكار غير مسبوق .. الحمام يتحول إلى "طائرات مراقبة"
- آليات تركية تشق طريقاً عسكرياً بالمتفجرات في دهوك.. صور وفيديو
- أفكار شاردة من هنا هناك/١١٨
- التمديد المتوقع والانسداد الدستوري في العراق
- فيديو / فشل عملية سطو هوليودية نفذتها عصابة محترفة بإيطاليا يشعل المنصات
- إرشادات مهمة لحماية الأطفال في منصات الذكاء الاصطناعي
- ما هي أقوى جوازات سفر في العالم؟ ... وما هي أضعفها؟ ... وما هو ترتيب الدول العربية؟
تابعونا على الفيس بوك