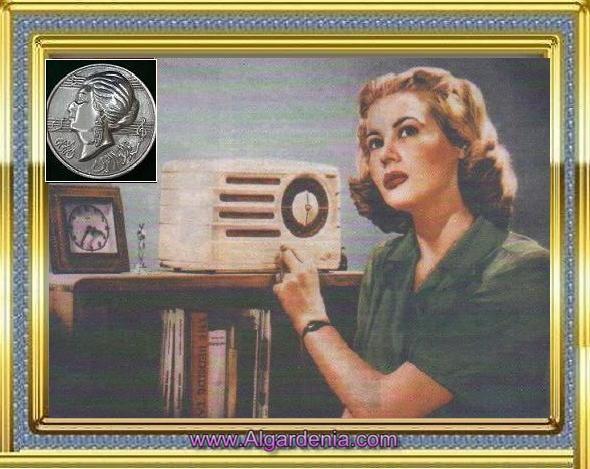الحج وشعائره وعلم المحاكاة
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 26 أيار 2025 06:44
- كتب بواسطة: د.باسل يونس الخياط
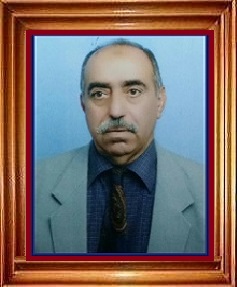
الأستاذ الدكتور باسل يونس ذنون الخياط
أستاذ مُتمرِّس/ جامعة الموصل

الحج وشعائره وعلم المحاكاة
الحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع؛ (قصد مخصوص، إلى موضع مخصوص، في وقت مخصوص، بشرائط مخصوصة)، وقد عرّفه الشيخ أحمد الدردير بقوله: (وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة، وطواف بالبيت سبعا، وسعي بين الصفا والمروة كذلك على وجه مخصوص بإحرام).
لقد ثبت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) حج حجة واحدة وهي حجة الوداع سنة عشر، بعد ما فُرض الحج، واعتمر (صلى الله عليه وسلم) أربع عُمر: عُمرة في ذي القعدة وعُمرة الحديبية وعُمرة مع حجته وعُمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين.
قرعة الحج:
بعد النمو السكاني الكبير الذي شهده عالمنا المعاصر، أصبح أمر الحج حلم صعب المنال، حيث تم تحديد أعداد الحجاج لكل بلد من قبل السعودية. ونتيجة لذلك فقد قامت الحكومات بتسمية جهات رسمية تتولى اختيار الحجاج لكل موسم وفق سياقات معينة.
والمبدأ العلمي المعمول به في مثل هذه الحالة في العالم أجمع، والذي يحقق العدالة، هي القرعة Lottery. وللقرعة تاريخ قديم في الحضارة البشرية. وفي ديمقراطية أثينا القديمة، كانت القرعة هي الطريقة التقليدية والأساسية لتعيين المسؤولين السياسيين، وكان استخدامها يُعتبر سمة أساسية للديمقراطية.
والقرعة أساسا هي مبدأ علمي سليم وطريقة إحصائية للاختيار تحت فرض أن جميع المشاركين في القرعة لهم حظوظ متساوية في الاختيار. ومما لا ريب فيه، وعلى الرغم من أن القرعة هي مسألة عشوائية Random، فإن الإرادة الإلهية تلعب الدور الحاسم في خيارات القرعة.
يُحدثنا التاريخ كيف نجّى الله تعالى (عبد الله بن عبد المطلب) والد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) من الذبح عندما نذر عبد المطلب إذا تم أبناؤه عشرة لينحرنّ أحدهم قربانا لله عند الكعبة. فلما أصبح أولاده عشرةً جمع قريشاً وأخبرهم بنذره، وكان عبد الله والد النبي (صلى الله عليه وسلم) هو الذبيح المقصود.
أقبل عبد المطلب بولده الحبيب عبد الله عند الكعبة ليذبحه، فمنعته قريش؛ سيما أخواله من بني مخزوم وأخوه أبو طالب، فقال عبد المطلب: ماذا أفعل بنذري؟ فأشارت إليه امرأة أن يقرع بينه وبين عشرة من الإبل (أي يعمل قرعة)، فإن خرجت على عبد الله يزيد عشرا من الإبل حتى يرضى الله به.
فقام عبد المطلب وأقرع بين عبد الله وعشرة من الإبل؛ فوقعت القرعة على عبد الله، فلم يزل يزيد حتى بلغت مائة إبل.
وهكذا كانت القرعة هي الأداة التي نجّت عبد الله من الذبح، وكانت الإرادة الإلهية وراء تلك القرعة، ولولا ذلك لما أشرقت الدنيا بنور الحبيب محمد (صلى الله عليه وسلم). وبذلك حمل النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) صفة "ابن الذبيحين"، وتعني أنه ابن شخصين كانا على وشك أن يُذبحا، وهما جده إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وعبد الله ابن عبد المطلب الذي كان على وشك أن يُذبح أيضًا.
وللقرعة حضورها في موضعين في القرآن الكريم، في سورة آل عمران وفي سورة الصافات:
قال تعالى: (ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ) (آل عمران: 44)؛ أي يقترعون من أجل كفالة مريم.
وقال تعالى: (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ* إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ * فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ * فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) (الصافات: 139-144).
(فَسَاهَمَ) أي (قارع)، أي عملوا قرعة ليحددوا الشخص الذي يرموه بالبحر لتخفيف وزن الفلك المملوء بالركاب، فوقعت القرعة على سيدنا يونس عليه السلام لثلاث مرات، فكانت القرعة ليست مصادفة بل هي أمر إلهي ليونس عليه السلام بالنزول إلى البحر حيث ينتظره الحوت ليلتقمه لأنه خرج من نينوى غاضبا من غير إذن من الله تعالى.
وهكذا لو كانت قرعة الحج تُجرى بضوابط عادلة، تكون الخصوصية فيها فقط لكبار السن بعيدا عن الامتيازات الوظيفية والخاصة، فستكون قرعة عادلة مباركة من الله تعالى يرضى عنها الجميع.
علم المُحاكاة Simulation:
علم المُحاكاة من العلوم العصرية، وهو علم مُهَجَّن يرتكز على علم الرياضيات في أصوله، وعلى علم الاحتمالية Probability في أدواته، وعلى الحاسوب في تنفيذه. أما تطبيقاته فتشمل شتى المجالات المختلفة، وبخاصة المجالات التقنية والهندسية والعسكرية.
وعلى الرغم من أن علم المُحاكاة محسوب على العلوم الإحصائية، إلا أنه يختلف عنها، كما أن اتجاهه معاكس لها تماما: فالعلوم الإحصائية تبدأ بالبيانات Data لتنتهي بالنموذج الرياضي Mathematical Model، في حين يبدأ علم المُحاكاة بالنموذج الرياضي لينتهي ببيانات ذات مواصفات مُحددة من قِبل المُستفيد.
ومن تطبيقات علم المُحاكاة المهمة استخداماته في المشاريع الاستراتيجية الضخمة مثل إنشاء السدود وشبكات الطرق والمواصلات، كما يُستخدم في إدارة العمليات العسكرية. ومن خلال المحاكاة يمكن الوصول إلى حلول آمنة مدروسة بموضوعية.
شعائر الحجّ وعِلْمُ المُحاكاة:
يرجع تاريخ الحجّ في الإسلام إلى عهد النبي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. والحجّ ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو فريضة على كل مُسلم يقوم بها (مَن استطاع إليها سبيلاً). وتؤدى مراسم الحجّ من الثامن إلى الثالث عشر من شهر ذي الحجّة كل عام في التقويم الهجري، ويتخللها مراسم عيد الأضحى في العاشر من ذي الحجّة.
الابتلاء العظيم:
قصة إبراهيم الخليل عليه السلام ورؤياه بذبح ابنه من قصص القرآن المثيرة، والقضية المحوريّة في هذه القصة هي قضية (الابتلاء) أي (الاختبار).
لقد رأى إبراهيم عليه السلام في الرؤيا الأمر بذبح ولده، ورؤيا الأنبياء وحي من الله تعالى، وكان ذلك في اليوم الثامن من ذي الحجّة. فتروى ولم يُنفذ الأمر. وفي اليوم التالي رأي إبراهيم الرؤيا نفسها؛ فعرف أنه أمر من الله تعالى، وكان ذلك اليوم التاسع من ذي الحجّة. وفي اليوم الثالث؛ وهو يوم العاشر من ذي الحجة، رأي الرؤيا نفسها، فبادر في ذلك اليوم إلى تنفيذ أمر الله تعالى.
شعائر الحجّ وعلم المُحاكاة:
إن شعائر الحجّ هي عبارة عن مُحاكاة (تقليد) لأحداث حدثت في زمن خليل الرحمن (عليه السلام) الذي عاش في بحدود (2000- 1700 ق. م) لتعيدها الأجيال جيلا بعد جيل استذكارا لأحداث تلك القصة المثيرة وما تتضمنه من دروس بليغة وعِبر.
يبدأ الحجّ بالنيَّة والإحرام، وتعقب ذلك شعائر الحجّ والتي تتسلسل وفق مجريات الأحداث في القصة الواقعية التي عاصرها خليل الرحمن والسيدة هاجر وولده إسماعيل عليهم السلام.
وتبدأ شعائر الحجّ بالسعي بين الصفا والمروة؛ والذي هو عبارة عن مُحاكاة (تقليد) لما فعلته السيدة هاجر عليها السلام عندما قامت تبحث عن ماء لوليدها إسماعيل عليه السلام والذي تركته في موضع زمزم. وقد سعت السيدة هاجر سبعة أشواط ذهابا وإيابا، وفي المرة الأخيرة عندما وصلت إلى وليدها وجدت الماء في زمزم يتدفق بين يدية (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) (البقرة: 158).
يُعد يوم عَرَفة من المواقف والمشاهد العظيمة حيث تقف جموع الحجيج في وقت واحد، وفي مكان واحد، وفي لباس واحد، في مشهد يُحاكي يوم القيامة حيث يقف الناس حفاة عراة ليتذكر الحاج بذلك كله يوم القيامة.
ويوم عَرَفة أكمل الله تعالى فيه الدِّين، وأتمّ نعمته على الأُمّة الإسلاميّة حيث نزل قوله تعالى (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) (المائدة: 3).
وتنتهي شعائر الحجّ بالنحر؛ وهو مُحاكاة لما فعله سيدنا إبراهيم عندما صدق الرؤيا وأراد تنفيذ ما رآه فيها بذبح ابنه ثم فداءه الله تعالى بذبح عظيم (وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) (الصافات: 107).
واليوم العاشر من ذي الحجّة يُسمّى بيوم النَّحر، حيث تُنحر الأنعام في مُحاكاة لقصة إبراهيم عليه السلام عندما همَّ بذبح ابنه بعد تصديقه وابنه للرؤيا (وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) (الصافات: 107).
وتُختتم مناسك الحج بعملية مُحاكاة أخرى لِما حدث مع سيّدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته وابنه. وقد ذكر هذه القصة الإمام الحاكم في المستدرك والإمام ابن خزيمة في صحيحه عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما والذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
فعندما همَّ سيدنا إبراهيم عليه السلام بتنفيذ رؤياه بذبح ابنه اعترضهم إبليس في ثلاث مواضع ليصدهم عن تنفيذ العملية. فرَمت هاجر الشيطان بسبع حصوات لتطرده في موضع الجمرة الصغرى، ثم رماه إسماعيل بسبع حصوات ليطرده في موضع الجمرة الوسطى، ثم رماه إبراهيم بسبع حصوات عند موضع الجمرة الكبرى، فانصرف الشيطان ويئس أن يطاع. ففي كل من هذه المواضع يقوم الحجاج برمي الجّمرات بعملية محاكاة لما حدث في قصة إبراهيم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام.
تقبل منّا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.
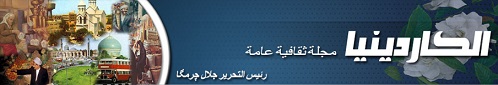
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1078 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- نَسَمَاتُ الصَّبَّاحِ
- والأنضباط العسكري والسيطرات وعسكرة المجتمع
- خواطر مواطن عراقي ساذج
- الحرامية .. تاريخها وكيف هي الان في عراق حاميها حراميها
- دفنت الآلاف تحت الأرض .. سر الحاسوب الذي حاولت أبل إخفاءه من التاريخ
- الجيش العراقي يعلن انسحاب القوات الأميركية من قاعدة عين الأسد وتسلم إدارتها بالكامل
- ترامب: حان وقت إنهاء حكم خامنئي!
- ليلة غزو الكويت .. وثائق تكشف كيف "كذبت" تاتشر وتركت ركابها "دروعاً" لصدام
تابعونا على الفيس بوك