الكتابة ضد السجن والرصاص من طه حسين إلى بختي بن عودة
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ السبت, 31 آب/أغسطس 2024 09:19
- كتب بواسطة: ابراهيم مشارة

إبراهيم مشارة
الكتابة ضد السجن والرصاص من طه حسين إلى بختي بن عودة
بقدر ما كان القرن العشرون قرن النهضة الأدبية والفكرية والدينية في حياتنا العربية الحديثة، ازدهرت حينا وخبت نارها حينا آخر، انبسطت تارة وانكمشت تارة أخرى، شهدت حياتنا الأدبية الحديثة محاكمات كثيرة بسبب اقتراب أو مقاربة أصحاب تلك الكتابات الأدبية أو الفكرية لمنطقة اللامفكر فيه أو مستحيل التفكير فيه، أو منطقة المقدس أو التابو ، فتأطير فضاء التلقي وتوزيع الجماعات البشرية يخضع لما يسميه محمد أركون بالسياج الدغمائي، وذلك يعني إحاطة هذه الجموع بسياج لحمته وسداه تدابير قانونية أو أحكام دينية تخضع لسلطة المقدس، سواء أكان المقدس سماويا (الوحي)، أو وضعيا سياسة الحاكم الذي هو واحد، وبالتالي لا يجوز الاقتراب من هذا السياج ناهيك عن الخروج عليه، لأن في ذلك إثارة للقلاقل وخلخلة للمجتمع ولبنيته وتراتبيته، والذي يعد استمرارا لنظام طبقي تراتبي ،تقليدي ذي بنية هرمية حيث تضيق الطبقات كلما اتجهنا إلى الأعلى ويحيط بهذا الهرم ذلك السياج الدغمائي الذي يبقي الحال على ماهي عليه تحت مراقبة دينية وسياسية صارمة ،وتحييد وعزل كل محاولة لخلخلة هذه البنية تحت طائلة قلب الهرم أو زعزعته بغرض إدخال التحديث والعصرنة على هذه البنية ومواكبة التطورات الفكرية والعلمية والاجتماعية كما شهدتها المجتمعات الحديثة المتطورة . ولأن كل نهضة أساسها الفكر ورسوله الكلمة المجنحة، كان لزاما على المثقفين والكتاب أن يخوضوا مسؤولية الكتابة والتزاماتها من أجل التنوير والتحديث، فالأزمة فكرية في الأساس والوعي وليد المعرفة ،وما الانتكاسة السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلا تمظهرات لأزمة فكرية ،أزمة وعي الذات لنفسها ولمحيطها وعصرها.
وإلى وقت قريب من رحيله كان محمد أركون يلح على الكتابة في الممنوعات الثلاث : الله والجنس والسياسة، لأن تناول هذه التابوهات بطريقة تقليدية شوش حياتنا وفكرنا وسلوكنا ،كما أن عدم وضوح الرؤية وغياب النظرة العلمية من دون معالجة الإفرازات والإحباطات تبقي دار لقمان على حالها وتحرم المجتمعات العربية من فرصة الحداثة والأنوار، مادام تناول هذه المسائل لا يخضع للموضوعية والروح العلمية والتاريخية.
وبالرغم من الكم الهائل من المؤلفات التي أخرجتها المطابع العربية منذ بداية القرن وكثير من الكتب الجادة والخالدة التي أحدثت نقلة في حياتنا الفكرية والأدبية والعلمية ،وقليل منها ما كان مزلزلا وإشكاليا وثوريا كذلك.
فمن هذه الكتب الثورية والتي أثارت زوابع وتوابع بسبب اقترابها من دائرة الممنوع ومقاربتها لمحاور منطقة المقدس بكل جرأة كتاب (في الشعر الجاهلي )لطه حسين 1926 وقد سبب الكتاب للكاتب شهرة وصداعا معا.
وصل إلى درجة فصله من الجامعة عام 1932 في وزارة إسماعيل صدقي ولم يعد طه حسين إلى الجامعة إلا عام 1936 في حكومة الوفد ،ووصل الأمر إلى تكفير الكاتب مادام ينكر وجود الشعر الجاهلي إلا القليل الأقل منه والذي لا يصلح لأخذ صورة صحيحة عن الحياة في العصر الجاهلي ومعظم ما يتداول منه منحول وضعه الرواة لأسباب سياسية أو دينية أوعصبية ،وأن ما يدل على الحياة العربية في العصر الجاهلي هو القرآن ، وبإنكار الشعر الجاهلي يحرم النص المقدس (الوحي) من مرتكز لفهم المراد من اللفظ ودلالته وطرق تداوله في ذلك الوقت ومجمل دلالاته وقد انقسم المثقفون في أزمة كتاب في الشعر الجاهلي إلى قسمين بين مؤيد للحرية الفكرية ومعارض لها لتجاوزها الخطوط الحمراء ،فمن المؤيدين المدافعين عن حرية التفكير العقاد وأحمد لطفي السيد ومحمد حسين هيكل ، ومن المعارضين الذين وقفوا للكاتب بالمرصاد وألفوا كتبا هم كذلك في تفنيد وجهة نظره واتهامه بالسرقة والسطو على أبحاث المستشرقين الرافعي وكتابه (تحت راية القرآن) وزاد في تهكمه من الكاتب في قوله المأثور (إسفنجة جاءت لشرب البحر، وشمعة تتصدى لشمس الظهر، وطه في نقد الشعر)، ومنهم محمد الخضر حسين ومحمد أحمد الغمراوي ومحمد لطفي جمعة ،وتحت وطأة الهجوم والتكفير اضطر الكاتب إلى حذف الفصول الإشكالية في الكتاب وإعادة طبعه تحت عنوان ( في الأدب الجاهلي)، ومازال هذا الكتاب منارة للحرية الفكرية والتحول الثقافي الخطير في الحياة الفكرية والأزمة التي تطال كل من يفكر ويبحث بحرية ويثير الأسئلة ويخرج على الشائع والمتداول والإجماع أو السياج الدغمائي بتعبير محمد اركون.
وفي عام 1925 خرج الشيخ علي عبد الرازق بكتاب صادم وإشكالي معا هو كتاب (الإسلام وأصول الحكم) ألح فيه على مدنية الدولة ورفض فكرة الخلافة مما أدى إلى إخراجه من زمرة العلماء وإقالته من منصبه كقاض شرعي ،وكان الملك وراء هذه الحملة لأنه كان يستعد لتنصيبه خليفة للمسلمين بعد سقوط الخلافة في تركيا الكمالية ،ورد على عبد الرازق محمد الخضر حسين (نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم) ومحمد الطاهر بن عاشور، وتعرض الشيخ علي عبد الرازق لمحنة كبيرة استمرت إلى ما قبل وفاته بقليل وكالعادة وقف إلى جانبه من يدافع عن حرية الفكر وحرمة الكتابة كالعقاد وهيكل وأحمد لطفي السيد وسلامة موسى وجدير بالذكر أن الشيخ علي عبد الرازق هو أخو الشيخ مصطفى عبد الرازق أستاذ الفلسفة الإسلامية وشيخ الفلاسفة العرب في العصر الحديث.
وفي بيروت صدر عن دار الطليعة عام 1969 كتاب( نقد الفكر الديني) لصادق جلال العظم واتهم الكاتب بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية وتمت محاكمته مع الناشر وسجن لفترة قصيرة ثم أفرج عنه وقد وقف للشهادة لصالحه ميخائيل نعيمة عن المسيحيين والشيخ عد الله العلايلي عن المسلمين مدافعين عن حقه في التفكير والكتابة مبرئين إياه من تهمة ازدراء الدينين الإسلامي والمسيحي معا وأن هدف الكاتب هو ممارسة فضيلة النقد والتأمل في الواقع العربي بعد نكسة حزيران 1967 مستنتجا أن الطابع الغيبي وسيطرة الماضوية كانا وراء الهزيمة الفكرية التي أدت إلى الهزيمة الحضارية والإستراتيجية والحربية كذلك ، وفي الطبعة التالية ألحق الكاتب بالكتاب وثائق المحاكمة كالقرار الظني والاستجواب وقرار المحكمة.
وفي عام1992تقدم إلى جامعة القاهرة نصر حامد أبو زيد ببحث أكاديمي لنيل رتبة أستاذ في أطروحته المشهورة( نقد الخطاب الديني) أحدثت ثورة في التأويل والعدة المعرفية والمنهج والحفر المعرفي في مقاربة الممنوع أو باحة المقدس ،مما عد تجاوزا للخطوط الحمراء وصل الأمر إلى درجة اتهام الكاتب بالردة أو الكفر حسب اتهام عبد الصبور شاهين له الذي رأى في البحث تجاوزا لمنطقة الإيمان بالغيبيات والتجني على الصحابة وعدم الخجل من الاستهانة بمشاعر المسلمين في الدفاع عن سلمان رشدي، وأخطر ما في الكتاب إنكار اللوح المحفوظ والقول بأن القرآن هو نتاج للبيئة العربية في القرن السابع الميلادي تفاعل معها وتأثر بها وأن الله كان ينتظر الوضعيات الإشكالية ليقترح الحلول وقد اشتدت الحملة على نصر حامد وصلت إلى حد رفع دعوى قضائية للتفريق بينه وبين زوجته تحت طائلة الردة والكفر وترك مصر للعيش في هولندا أستاذا بإحدى جامعاتها إلى ما قبل وفاته بقليل.
وفي مجال السرد صدرت خارج مصر في عام 1962 رواية (أولاد حارتنا) لنجيب محفوظ عن دار الآداب ولم تنشر في مصر إلا عام 2006 عن دار الشروق وقد نوهت لجنة نوبل بهذه الرواية ،وأدان الشيخ عمر عبد الرحمن هذه الرواية وكاتبها عام 1989 بدعوى أنها رواية كفرية إلحادية وهي الفتوى التي تسببت في محاولة اغتيال الكاتب عام 1994 لولا لطف الله وعاش الكاتب حياته بعد ذلك تحت وطأة هذه الحادثة وتداعياتها ،ورواية أولاد حارتنا كتبت بأسلوب رمزي عوض الأسلوب الواقعي الذي عرف به نجيب محفوظ وفحوى الرواية هي النظرة الكونية والإنسانية العامة وقد كتبها بعد ثورة يوليو منبها إلى انحرافاتها وهي كذلك نظرة التوق إلى المعرفة والعدالة والسعادة ،وأساس ذلك العلم والدين معا وامتد النقد إلى أسماء شخصيات الرواية كالجبلاوي الذي يرمز إلى الذات الإلهية وأسماء الشخصيات التي تشير إلى الأنبياء كإدريس ،آدم ، فالعلم الذي ترمز إليه شخصية عرفة هو الطريق إلى النهضة ولكن العلم وحده غير كاف وغياب النظرة العلمية كذلك في حياتنا سببت تراجعنا .
كما عرفت رواية (وليمة لأعشاب البحر) للروائي السوري حيدر حيدر الصادرة عام 1983 نفس المصير وقد اتهمها جابر قميحة بتجاوز حدود الدين الإسلامي متخطية آداب القول واحتوت على فاحش اللفظ وهي تحكي قصة مناضل شيوعي هرب إلى الجزائر ليلتقي بمناضلة قديمة بعد مرحلة انهيار الثورة والخراب الذي عم بعد ذلك.
دون أن ننسى قائمة الاغتيالات التي طالت كتابا ومفكرين كيوسف السباعي (1978) والعالم الموسوعي جمال حمدان(1993) ومهدي عامل (1987) فرج فودة (1992)وحسين مروة (1987) وبختي بن عودة (1995)وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن للكلمة شأنا خطيرا وبإمكانها التأثير تنويرا أو تثويرا وخلخلة كل بنيات المجتمع خاصة السياسية والدينية ، وأن الكتابة بكافة أنواعها وأجناسها والفكر بمختلف حقوله يجعل الكاتب أو المفكر قد يدفع حياته ثمنا لذلك بعد أن أنفق عمره في التفكير والنقد الوظيفي والكتابة والتأليف.
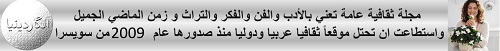
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
مختارات
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
653 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- تركيا تنفى طلب مخابراتها من بريطانيا حماية الرئيس السورى إثر محاولة اغتياله
- اسرائيل تكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال المرشد الايراني
- ثري إيراني متهم ببناء إمبراطورية عقارية في لندن لمصلحة نجل المرشد
- الحرب على إيران تشعل الأسواق العراقية تحسبا للحصار
- بذكريات الحصار .. أدوات التسعينيات "اللالة" و"الچولة" تعود إلى منازل العراقيين
- بعد الحرب على إيران .. ترامب يكشف عن وجهته التالية
- الحرب بلا حليف أمرها مخيف ايران نموذجا
- برنامج ألأمثال البغدادية ( "يد وحدة ما تصفك" )
تابعونا على الفيس بوك




















































































