ألسامقة الغائبة في دير الشهيد مار بهنام العجائبي
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 08 تشرين2/نوفمبر 2016 21:25
- كتب بواسطة: يعقوب أفرام منصور
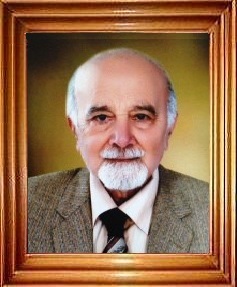
يعقوب أفرام منصور
أربيل

قاصد( دير مار بهنام الشهيد) من مدينة الموصل أو من بلدة قره قوش (باخديدا)، أو من جهة الطريق المؤدية إلى كركوك (كرخ سلوخس)، كان يلمح على بعد بضعة أميال من الدير، وقبل بلوغه إلى المنعطف الأيسر نحو السبيل المبلّط إلى الدير، كان يلمح قمّتَي شجرتين سامقتين حتى عام 1995 ، إحداهما وهي الأعلى ـ شجرة (يوكالبتوس)ـ يناهز عمرُها أنذاك خمسين عامًا، تتوسط الباحة الأولى المحاذية لمدخل الكنيسة العتيقة، والأخرى ـ دونها إرتفاعًا ـ أثَلَة غامقة الخضرة، كثيفة الأفنان.
هذه (الأثَلَة) محاطة بأشجار زيتون في جنينة مربّعة في الباحة الداخلية للدير، التي كانت في أواسط القرن المنصرم مخصّصة لإقامة الرهبان. ولبثت حجراتهم المربّعة الصغيرة حتى العقد الأول من القرن الحالي قائمة برغم خلوّها منهم منذ زهاء سبعة عقود. ويحدّ الجنينة آنئذٍ جنوبًا مكتبة الدير، وشرقًا قاعة الإجتماعات والمحاضرات والإحتفالات في الطبقة الأرضية، وصالة الأستقبال وغرفة رئيس الدير ومكتبه وخمس غرف للزائرين والضيوف في الطبقة العلوية من هذا الجناح الشرقي. في الباحة الثانية الداخلية.
منذ زيارتي الدير عام 1989 وحتى زيارتي عام 1994، ألِفتُ مشاهدة هذة (الأثَلَة) الظريفة. كانت مَجمعًا ومَهجعًا ومأوىَ مفضّلاً لكثير من فصائل الطير: الزرازير والعصافير، الحمائم واليمائم، الهزارات والقنابر، العنادل والخطاطيف وغيرها. حتى (الدرّاج) كان يحوم حولها في أوقات متباينة من النهار من غير أن يحطّ عليها، مفضّلاً الحومَ حولها، والإجتياز وربما الإغتباط بالأغاريد والزقزقات الصادرة عنها. أمّا طير (البوم)، فهو ينعب بصوته القبيح بين حين وآخَر عليها أو قربها في أثناء الليل، وربما يقتنص في هدأةٍ منه بعضًا من عصافيرها وقُبّراتها.
مع الأصيل، وقبل الغَسَق تتقاطر صفوف الطير الشادية والمزقزِقة والنائحة لتؤلَف جوقة إنشاد عجيبة غريبة، كأنها جوقة ضخمة تعزف ألحانًا سمفونيّة من سمفونيات الطبيعة في أوان الغروب، تماثلها ثرثرات ألف طفل، وخرير مئة ساقية، وحفيف آلاف من أوراق الشجر. ومبعث الغرابة والدهشة أن المُصغي إلى كل هذه الأصوات لا يشعر بنشاز أو تنافر. إنها أنغام توافقية ذات انسجام خاص، لا نظير له في قواعد الموسيقى البشرية. أمّا إيقاعها، فهو كذلك إيقاع خاص لا مثيل له في جميع المدوّنات الموسيقية المعروفة في الشرق والغرب أو أفريقيا. سبحنك اللهمّ ! ما أبدعّ خلقك، وما أجمل قدرتك !
وإذا كان مرهفو الإحساس من الأدباء أو الشعراء إو الموسيقيين يلمسون بعض الشَجَن في نبرات أنغام الغروب هذه، فهم حتمًا لا يشعرون بما يحاكيها في ما يصدر من تراتيل عن جوقات تلك الطيور وقت السَحَر والفجر والشروق؛ إذ هي مفعمة بالبهجة، زاخرة بالطرب، مغمورة بالحبور، طافحة بالأمل والسعادة والإنتشاء بميلاد يوم آخَر، وبزوغ ضياء مبين، وانبلاج صبح جديد. وهنا يحضرني بيتٌ شعري يقول:
قُم، لقد قامتِ الطيورُ تغنّي لا يكون الحمامُ أطربَ مِنّا
وهذا البيت من أغنية قديمة، لم أسمعها يومًا من إذاعات الصباح !
وفي نيسان 1996 قصدتُ الدير المذكور للإستجمام والتأمّل، يحدوني الأمل المنشود بأن أُصغي كل يوم إلى سمفونيَتَي (الأثَلَة) في الشروق والغروب، ولكن واحسرتاه! فما إنِ ارتقيتُ الدرج المؤدّي ألى الرواق حيث حجرتي، حتى ألفَيتُ جذعَ (الأثَلة) السامقة مكسورًا ـ بعضه مُنطرِح على أرض الجُنينة، وبعضه مرتكز على المِظلّة الخشبيّة، وقد قصفته ريح ساهِجة عاتية كعتوّ صاروخ مدَمِّر بتّار. وهكذا إنصرمت أيامي هذه المرّة في الدير بدون أن تكون صلاتي بعد الغروب مصحوبة بسمفونية المساء من تلك (الأثَلة)، ومن دون أن أتلو صلاتي في الفجر مصحوبة بسمفونية الصباح التي كانت تنبعث من تلك (الأثَلة) في الأعوام السالقة.
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1128 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- تنويه الى الأخوة والأخوات كتاب وقراء مجلة الگاردينيا المحترمين
- تحت المجهر - (من العصر الحجري إلى عصر الذكاء الاصطناعي)
- بابل … ذاكرة حضارة وشعور فخر
- من اجل وحدة المسلمين : يا شيعة تسننو!ا
- الامير عبدالاله وهو يقلد الرائد عبدالكريم قاسم بنوط الشجاعة لدوره في حرب الشمال - منطقة برزان .
- تهاني وتبريكات لمناسبة عيد الحب المصادف يوم ١٤ شباط
- "شيبس المشاهير" يشعل الترند والأسواق في العراق
- حلم الولاية الثالثة يبتعد عن المالكي: ترامب قال لا مجدّدا
تابعونا على الفيس بوك




















































































