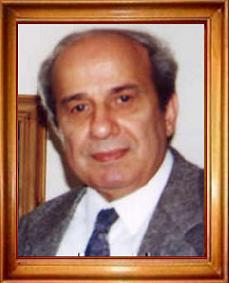العلمانية ركن أساسي في إرساء نظام ديمقراطي
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ السبت, 24 آب/أغسطس 2013 15:15
عادل حبه
العلمانية مفردة مشتقة من كلمة "سكولوم" اللاتينية، وتعني الدنيا والحياة الدنيوية، أو الحياة على الأرض. ولقد استخدم تعبير العلمانية لأول مرة في أوربا في معاهدة "وستفالي" عام 1648، التي أكدت على انتقال الأراضي التي كانت تحت سلطة ووقف الكنيسة إلى ملكية سلطة المجتمع المدني.
وبعد ذلك جرى تداول مفردة العلمانية على نطاق واسع للتعبير عن مبدأ الفصل والتمييز بين ما هو ديني ومقدس وبين ما هو دنيوي. وهكذا أصبحت مفردة العلمانية تعبر عن موضوعة فصل مؤسسات الدولة عن المؤسسات الدينية. وعلى هذ المبدأ اعتمد المشرِّعون في تشريع القانون الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن الهيمنة البريطانية. كما سارت فرنسا منذ ثورتها عام 1789 على مبدأ العلمانية. كما استُخدِمت مفردة "لائيزم"، أي الدنيوية، في أثناء الصراع الذي خاضه الشعب الفرنسي في القرن التاسع عشر من أجل الفصل بين المجتمع المدني والمجتمع الديني. ويعتبر كلا المفهومين الآن، أي العلمانية واللائية، مفهوماً حقوقياً وتشريعياً وسياسياً واحداً.
لقد أصبحت العلمانية جزءاً مهماً من أركان الديمقراطية والحرية، بل هي جزء لا يتجزأ من الأثنتين. ففكرة العلمانية أكدت على أن تشكيل الحكومة والتشريع وسن القوانين هو حق الشعب الذي لا ينازعه فيه أحد. فالحكم ينبثق من الشعب ولخدمته، ويعتمد مشروعيته على إرادة الشعب وحده وليس على قوة ليست على تماس مع المواطن وغير معروفة. ولم يعد التشبث بالدين أو بأية حجة أخرى غير إرادة الشعب وخياره أي تأثير في الحكم طبقاً لمفهوم العلمانية. ومكنت الديمقراطية، التي تحققت على مراحل في أوربا والولايات المتحدة، العلمانيين من تحديث مختلف مؤسسات الدولة القضائية والتعليمية وأضفوا عليها هوية غير دينية وأبعدوا سلطة الكنيسة عن هذه المؤسسات. وهذا ما لعب دوراً مؤثراً في تطوير وترسيخ العملية الديمقراطية في هذا الجزء من العالم.
بالطبع لا يمكن اعتبار أي نظام ديكتاتوري قمعي غير ديني بمجرد إعلانه فصل الدين عن الدولة نظاماً علمانياً ولائياً. فالأنظمة الفاشية التي استقرت في أوربا في النصف الأول من القرن العشرين وعشرات الانقلابات العسكرية التي جرت في بلدان العالم الثالث، ومنها العراق، رغم كونها انظمة غير دينية وأحياناً معادية للدين، إلاّ أنها أنظمة اعتمدت ايديولوجيا معادية للديمقراطية ولا يمكن اعتبارها انظمة علمانية. فالعلمانية لا تعني العداء للدين وإلغاءه، ولا تحرم المواطن من حرية الايمان والعقيدة ولا تفرض قسراً ايديولوجية بعينها على المجتمع على خلاف الأنظمة الفاشية والديكتاتورية.
إن العلمانية هي الحل الأمثل والحاسم لممارسة الحرية الدينية وحرية المعتقد وخاصة بالنسبة للتعامل مع مشاكل الاقليات الدينية والمذهبية، لأنها تضمن أمن وحرية الأفراد في المجتمع بغض النظر عن دينهم ومذهبهم. فالعلمانية تحد من طموح وسلوك أي تيار ديني أو مذهبي لفرض رؤياه وفكره وسلطته على الآخرين، أو التمييز أو القهر ضد اتباع التيارات الدينية أو المذهبية الأخرى بذريعة الأكثرية التي يتمتع بها هذا التيار أو المكون الديني أو المذهبي في المجتمع. فهذا النمط من الإكراه المخالف حتى للنص الديني نراه الآن في السعودية، التي تعتمد المذهب الوهابي وتمارس التمييز والقهر ضد المذاهب الأخرى مستخدمة شرطة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" لفرض رؤياها على المجتمع. كما نراه هذه الإيام في إيران حيث ينص الدستور الإيراني صراحة على هوية الدولة المذهبية، الشيعية، ويجري ملاحقة المكون المذهبي البهائي أو التمييز ضد المذاهب الأخرى بذريعة الانتماء المذهبي للأكثرية السكانية. وربما نرى محاولات مماثلة تجري الآن في العراق، ومن ملامحها ما جاء في مقدمة الدستور العراقي من ديباجة ملتبسة ترمز إلى ملامح مذهبية وطائفية. كما يحاول المتطرفون في البلاد تشكيل منظمات إرهابية وتنصيب أمراء أشبعوا العراقيين بفتاواهم المختصة بنشر العنف والارهاب وسلب حريات المواطنين العراقيين وإزهاق أرواحهم ودق أعناقهم، أو تشكيل ميليشيات مسلحة تفتي بقطع رؤوس مخالفيهم وتهجيرهم أو تهاجم المقاهي والمطاعم وأماكن لهو المواطن العراقي وتخرق القوانين بدعوى الحفاظ على نقاوة الدين!!! وأي دين، ناهيك عن فرض طقوس مكون مذهبي معين على المجتمع بذريعة كونه يتمتع بالأكثرية في المجتمع!. إن فصل الدين عن الدولة، كما تدعو له العلمانية، تزيل هذا التمييز ضد الاقليات الدينية والمذهبية، لأنها تنظر بعين واحدة وبحياد صوب كل المذاهب والمكونات الدينية مهما بلغ حجمها في المجتمع. فمؤسسات الدولة يجب أن لا يحتكرها أي مكون ديني أو مذهبي وهي ملك لجميع مواطني الدولة. وإن اتباع جميع الأديان هم مواطنون لهم نفس الحقوق ونفس الواجبات سواء أكانوا مسلمين أو مسيحيين أم يهوداً أو سنة أو شيعة.
وتتبنى العلمانية مبدأ فصل المؤسسات القضائية عن المؤسسات الدينية أو المذهبية. فطبقاً للعلمانية يجري سن القوانين وتشريعها والمصادقة عليها من قبل المؤسسات التي ينتخبها الشعب، وليس من مراجع دينية. فليس من حق المؤسسة الدينية ورجال الدين الافتاء بصلاحية أو بطلان القوانين المشرعة من قبل البرلمان أو الجهات المنتخبة من قبل الشعب. كما يُمنع رجال الدين في ظل العلمانية الديمقراطية من التدخل في الشأن القضائي واصدار الفتاوى بالجهاد والقتل والدعوة للثورة. ففي المجتمعات الديمقراطية يجري الفصل بين الواجب أو الجرم الدنيوي وبين التكليف الشرعي أو الذنب الديني أو المذهبي، ويلاحق أي رجل دين أو مؤسسة دينية تدعو إلى غير ذلك. فالمؤسسة الدينية تنظر إلى الفرد كمُكلف شرعياً ومتلقي، وليس صاحب حق وصاحب رأي وصاحب مصلحة. فالحكم المذهبي في إيران، على سبيل المثال، يقوم على مبدأ ولاية الفقيه، أي على التكليف، حيث يسطو رجل الدين أو المرشد الديني يتحكم بجميع مرافق الدولة ليتحول إلى قاضي في المحاكم وجنرال في الشرطة والجيش والمخابرات ومسؤول في السلطة التشريعية والتنفيذية، ولا قيمة للمؤسسات المنتخبة من قبل الشعب. في حين تقوم المجتمعات الحديثة على فلسفة جديدة قائمة على حقوق المواطن ورأيه واحترام المؤسسات المنتخبة، وعلى احترام حقوق الانسان والعدالة والسلام وسعادة البشر على الأرض.
إن من الأركان الأصلية للديمقراطية والعلمانية هو فصل التعليم العام عن التربية الدينية. وقد جرى العمل بهذا المبدأ لأول مرة في فرنسا عام 1881 عندما رفع شعار تطبيق المدارس العلمانية المجانية والاجبارية في سائر انحاء فرنسا، وجرى تثبيت ذلك في القانون الأساسي للجمهورية الفرنسية الثالثة في عام 1905. ويعود السبب إلى الفصل هو وجود تباين وتعارض أساسي بين العلوم الطبيعية التي تدرس في المدارس وبين المفاهيم والمسلمات الدينية وبين العالَم الطبيعي وبين العالَم الديني، أي ما بين علم الطبيعة وما بين أفكار ما وراء الطبيعة. وهكذا جرى في الغرب تغيير في منابع المعرفة الانسانية والاهداف التعليمية وفصلها عن منابع الشريعة ورجال الدين التقليديين. فلا يمكن على سبيل المثال الجمع في نظام تعليمي ديني وعلماني واحد نظرية داروين حول التطور والنظريات الجيولوجية الخاصة بالمتحجرات وتعاقب الأحقاب الجيولوجية وما رافقها من تطور في الأحياء وتكوين المجرات والأرض وما جاءت به الفيزياء الحديثة والنظريات الفوتونية مثلاً وبين النصوص الدينية حول الخليقة المنصوص عليها في جميع النصوص الدينية على اختلاف مشاربها. كما لا يمكن اعتماد مذهب واحد في التعليم في ظل وجود 53 مذهب وفرقة وطريقة اسلامية وعشرات من المذاهب المسيحية واليهودية وغيرها على سبيل المثال في عالم اليوم. ومن غير المفهوم هذا العدد الكبير من الفرق الاسلامية في حين أن جميعها تؤمن بالأركان الأصلية للإسلام وهي الصوم والصلاة والحج والزكاة. وينطبق الأمر أيضاً على تشكيل الأحزاب الدينية المنتشرة كالفطر الآن في العراق والعالم العربي والاسلامي، والتي ليس هناك أي داع لتشكيلها أساساً، والتي بلغ عددها المئات تتصارع فيما بينها وتتنازع بعضها مع بعض على الغنائم والجاه وتشن حروباً دموية ضد بعضها وهي التي تؤمن بخالق واحد وقرآن واحد. فما معنى أن يوجد في العراق حزب مثل حزب الدعوة الاسلامي أو المجلس الاعلى الاسلامي او الحزب الاسلامي أو حزب الفضيلة وحزب الله وجند الإمام ومنظمة بدر ...الخ؟؟. فإلى ماذا تدعو هذه الأحزاب في بلد تؤمن غالبيته بالدين الإسلامي ولا تدين بالبوذية ولا بالوثنية!!. أوليس من الأجدى تشكيل أحزاب تجمع مختلف مكونات الشعب وتتعامل مع الناس على وجه الأرض وحل مشاكلهم وليس الدعوة إلى الدين الذي هو من مهمة رجال الدين والوعّاظ والمدارس الدينية. إن فصل المدارس الدينية عن المدارس العامة في أوربا والغرب عموماً فتح الباب أمام انتشار التعليم المدني ومهد الأرضية لأن يقفز الذهن البشري قفزات هائلة إلى الأمام على طريق الاكتشافات والاختراعات العلمية المذهلة التي شهدتها المجتمعات الغربية منذ أكثر من قرنين وحتى الآن، إلى جانب فتح الأبواب أمام ترسيخ الديمقراطية وتوسيع الحريات الشخصية وتنامي الفكر العقلاني والمعتدل والتنوير في هذه المجتمعات، في حين خيّم الركود في مختلف جوانب العلوم وانتشرت الخرافات والتخلف في المجتمعات الشرقية التي التزمت بمبدأ عدم الفصل بين التعليم الديني والتعليم العام، باستثناء اليابان والصين أخيراً وهي مجتمعات لا تدين بأي دين بل تلتزم بتعاليم فلسفية دنيوية .
إن العلمانية ليست ايديولوجيا، بل هي طريقة في إدارة الدولة ونهج في سن القوانين على أساس الفصل بين الدين والسلطة. وهي ليست بديلاً عن الدين، وليس هدفها ونهجها العداء للدين ولا تحريم المتدينين من المشاركة في السياسة. فالعلمانية الديمقراطية تعتبر الإنسان معيار كل شيء. وحسب قول آلبرت ممي:" العلمانية هي عقد اجتماعي لا يلغي دور أحد، ويعترف بالتنوع ويحترم حقوق كل فرد. فهي لا تحتاج إلى فرض إيمان معين لتخريب إيمان الآخرين، لأنها لا تربط نفسها بأي معتقد ديني". فالعلمانية الديمقراطية تلتزم بحماية الأديان والمذاهب وحرية ممارسة أتباعها طقوسهم على خلاف ما هو جار في الدول الثيوقراطية الدينية في بعض بلدان الشرق الأوسط التي تطارد وتقمع حملة المعتقد الديني غير الرسمي. ويشير المفكر الفرنسي الكسي دو توكويل في معرض حديثه عن البناء السياسي الأمريكي قائلاً:"عندما يسعى المذهب الاستناد إلى المنافع الدنيوية، فهو سيضمحل على شاكلة كل السلطات الأخرى الزائلة. فالدين لوحده يمكن أن يكون أزلياً في حالة عدم الاستناد إلى السلطة أو الحياة الدنيوية. ولكن عندما يرتبط الدين بالدنيا الفانية، فإنه سيصبح شريكاً في هذا الفناء ويتجه نحو الأفول. وعندما يرتبط المذهب بالقوى السياسية المختلفة، فإن هذا الارتباط سيكلف الدين خسارة باهضة". إن هذه الحقيقة يمكن أن نستدلها بما آل إليه الدين في أوربا بعد أن تسلطت الكنيسة على الحكم خلال القرون الوسطى، وما آل إليه ربط الدين بالحكم في السودان بعد الانقلاب العسكري الأخواني وفي إيران بعد الثورة الإيرانية، والركود الاجتماعي في بلدان الخليج وخاصة في العربية السعودية، وما آلت إليها المواجهات بين التيارات السياسية الدينية من كوارث وضحايا هائلة في العراق، وما نراه اليوم من تكرار تلك الضحايا والخراب والكوارث في سوريا، ونتائج حكم الأخوان في مصر في السنة المنصرمة حيث كان الخاسر الأول الدين نفسه والإيمان الديني. لقد أدى ربط الدين بالسلطة والحكم في هذه البلدان إلى انقسام ومواجهات دموية خطيرة وعداء مستحكم بين أفراد الشعب في ظل إلغاء وتهميش الهوية الوطنية وتشرذم مكونات الشعب في هذه الدول.
وعلى العكس من ذلك، فإن العلمانية يمكن أن تلعب دوراً في إرساء الاستقرار السياسي ووحدة البلاد والمصالحة الوطنية بين مختلف المكونات الدينية وغير الدينية في بلداننا، بدلاً من اعتماد الأصولية الدينية والمذهبية والمواجهات المذهبية والدينية المدمرة الجارية منذ سنوات في العديد من البلدان حالياً. ويشير الفليسوف الإيراني داريوش شايگان إلى أن "الأصولية لا تُحيي الإسلام فحسب، بل تحوله إلى مومياء محنطة من الرؤى والخرافات، وتقود الدين الإسلامي إلى أخطر التحديات والمنزلقات".
إن بلدنا العراق في مأزق الآن جراء هذا الخيار في دمج الدولة بالدين وتسلط التيارات الدينية على زمام الأمور في البلاد. فهو لم يجلب الاستقرار للبلاد ويهددها بحروب طائفية، ولم يتم معالجة الفساد الذي ورثناه عن النظام السابق بل زاد سوءاً بحيث أصبح العراق في مقدمة الدول التي تعاني من الفساد والرشوة والمحسوبية بشهادة المؤسسات الدولية، في حين أنه في مقدمة الدول التي تلتزم بالدين كما أشارت المصادر الدولية نفسها. كما لم يؤد هذا الخيار إلى دفع عجلة التنمية وإزالة التخلف في الصناعة والزراعة والتعليم، كما أنه لم يشيع ويعمق القيم الأخلاقية والأنسانية في البلاد بدليل تفاقم هذه النزعة من التوحش التي أصابت جيل من العراقيين وانتشرت في جميع أنحاء العراق. إن بلداً مثل السويد يقع في قمة الدول المستقرة والتي لا يستشري فيها الفساد وتشاع فيها القيم الإنسانية والأخلاقية بعد أن فصلت الدين عن الدولة، في حين أن الدول التي تتاجر بالدين وما أكثرها الآن تعاني من أمراض أجتماعية خطيرة ومن فساد ينخر في المجتمع، ومنها العراق حالياً الذي يقف في مقدمة الدول التي يطغي عليها الغلو الديني بإرهابه وبميليشياته وبطقوسه المذهبية "المليونية" التي تعطل كل الحياة العامة والدوائر والمدارس والامتحانات خلالها، وتبعاً لذلك يتحول التجارة بالدين إلى بيئة للفساد المستشري في جسم الدولة العراقية.
إن أمام المأزق الحالي الذي يعيشه العراق يتطلب جملة من التدابير الواجب اتخاذها. وفي مقدمة هذه التدابير تشكيل لجنة من رجال القانون المتخصصين من أجل التدقيق وإعادة النظر في الدستور العراقي الذي يحتوي على تناقضات ويتحمل تفسيرات متناقضة، بحيث تسترشد هذه اللجنة بمبدأ فصل الدين عن الدولة وسن القوانين التي يجري تعطيل تشريعها عمداً من قبل مجلس النواب العراقي المشلول بحيث تتناسب مع القوانين المدنية الحديثة. فمن الضروري مثلاً تشريع قانون الأحزاب، وأن تنص أحد فقراته على عدم السماح بتشكيل أحزاب دينية على غرار ما هو جار في مصر وعدد من الدول العربية. وفي هذه اللحظات الحرجة التي يعيشها العراق وشعبه، فعلى أهل الحكمة والبصيرة والحريصين على مستقبل البلاد التوجه نحو تشكيل حكومة تنكنوقراط ومن أهل الخبرة والنزاهة ومحايدة من المختصين لإعادة بناء البلاد التي خربت من قبل النظام السابق وأهملت من قبل التيارات الدينية والطائفية التي أمسكت بزمام الأمور بعد انهيار نظام العسف والظلم السابق. إن تشكيل حكومة تكنوقراط تشرع بعملية ترميم الخراب الذي أصاب البلاد هي مهمة وطنية ملحة لبعث الاستقرار والأمل في البلاد بعد أن فشلت التيارات الدينية والمذهبية والطائفية فشلاً ذريعاً في تحقيق مطالب الشعب العراقي.
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
532 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- ظاهرة القرقوز المؤسسي .. حين يتسيّد المهرّج على الكفاءة
- مسلسل_عمر - الحلقة السادسة
- طرائف رمضانية - شيطان في المسجد!!
- لماذا سمي شهر رمضان بهذا الاسم وهل له أسماء أخرى؟
- حول الإعجاز العددي للقرآن الكريم
- قصة مدفع "الحاجة فاطمة" من ميادين الحروب إلى طقس رمضاني
- العراق على حافة "حرب الإسناد": احتمالات انخراط الفصائل في صراع واشنطن وطهران
- جهاز الخدمة السرية يقتل رجلاً بعد اقتحامه محيط الحماية في منتجع ترامب بفلوريدا
تابعونا على الفيس بوك