جراح الغابة - الجزء السابع
- التفاصيل
- المجموعة: ثقافة وأدب
- تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 08 حزيران/يونيو 2022 10:16
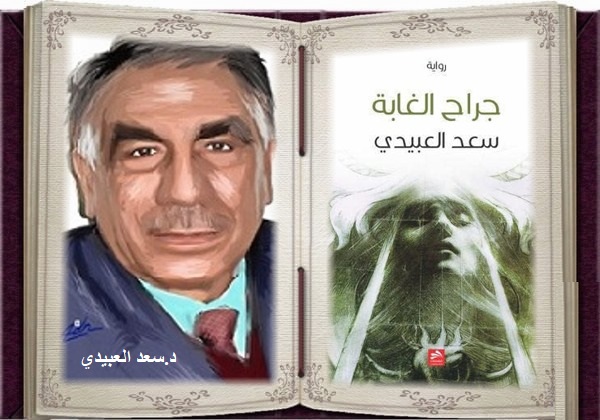
جراح الغابة: الجزء السابع/ د.سعد العبيدي
بانت الحياة في لندن العاصمة البريطانية ذات وقع سريع، تمشي في شوارعها الناس بشكل سريع، كل شيء يمر ويعبر ويبدأ وينتهي بوقت سريع، إلا هذه الغابة، فالإحساس بزمنها بطيء، والمشي في نياسمها بوقع لا يهم القادم هارباً من الشرق ان كان بطيئاً أو سريع، لأن الوقت لا يعنيه، وسرعة المشي لا تهمه، أكدت الدقائق التي انقضت مرة أخرى أن لون البشرة، وتقاسيم الوجه، وردود الفعل لهذا العراقي الموجود قريباً من وجوده مطمئنة تجمعهما روابط محسوسة لا يمكن تجاوزها.
فكر لحظة، توقف عن التفكير لحظة أخرى، أحس أن ما يجمعهما مشاهد حياة في البلد الأم تفوق الروابط التقليدية التي تجمع غريبين، بينها التشابك بالأيدي والهراوات والبنادق والمفخخات، وتبادل السباب بين الأشقاء الذين استبدلوا المودة بالحقد، والمصافحة بالرصاص، وسلام الله بالطعن تحت الحزام، وصور بأبعاد ثلاثية لمن ينهشون لحم بعضهم بعضاً، ولمن تركوا الشيمة والرفعة والرحمة، لينساقوا أفواجاً خلف أهواء النفس وفتن السياسة، ولمن استبدلوا الدعاء لأن تمطر السماء مطراً يغسل القلوب، بأعمال الضرب والقتل والتهجير، رضوخاً لأهواء الغريزة، وتنفيذاً لأوامر تأتي من سياسيين، وبعض رجال دين، وتجار حروب مستفيدين، حنّوا أياديهم بالدماء، وبينها مشاعر کره مشتركة لأولئك الذين يقفون ذلاً بين أيدي الملوك والرؤساء والأمراء، يستجدون السلطة، والمال من أجل مجد خاص بهم، وذبح الشريك الماشي معهم وسط الطريق... هناك الكثير من المشتركات، في هذه الغابة، وكذلك في العراق، الا ما يتعلق بوقع الزمن، ومتعة القصص التي رواها همساً السيد أندرو عن فرار أجداده من وسط ألمانيا، وبنائهم القرية شمال أسكوتلندا، ثلاثون بيتاً بترتيب حماهم من الملاحقة آنذاك، وإلحاحه على زيارتها، والعيش فيها لأغراض النقاهة، وإعادة ترتيب الأفكار، التي يراها ارتباطا بالماضي الأصيل.
بات يكلم نفسه، قال لها بصمت لو حدث الذي أنت فيه الآن، بتلك الأيام التي تمني نفسك بالحنين إليها، أيام الشباب، وقد استوقفك أحدهم دقيقة واحدة، وسألك عن فكرة التواجد في هذه الغابة، وترك الوظيفة، والبلد الذي أحببت، الا تقول له وأنت منفعل بشدة، انك مجنون؟ ربما يكون فعلاً مجنون، ومن قال غير ذلك؟
مجنون مع سبق الإصرار، ومن يصدق حكاية الغربة التي أخترتها مرة أخرى؟
مجنون أنت، والأصدقاء في هذا البلد، وأولئك الذين وافقوك مجانين، وهذا الظل العراقي الذي يخيم على الجميع، ويفزعهم دوماً، مجنون مثلكم.
أنا، أنت، هو، هن، هم، مجانين.
الكل مجانين.
ألم تلحظ في عراق التغيير هذا، حضور الشاب الليبي مفتاح التاورغي من أقاصي المغرب العربي إلى مشرقه الأقصى بغداد الرشيد، حاملاً تاريخه وحاضره ومستقبله، لتفخيخ نفسه بالديناميت، بقصد التفجير، وسط جنود تطوعوا لخدمة الوطن حديثاً، وكسب لقمة عيش كريمة، هرباً من عوز، وفقر، وجوع؟
لم يسأل نفسه قبل الشروع عن أسباب قيامه بقتلها والأبرياء، ولم يندم، وبدلاً عن الندم يبرر بالقول (أنه سيتناول طعام الغداء مع الرسول، وصحبه الكرام).
فهل يصدق هذا؟
من يصدقه بالطبع، مجنون.
ماذا تسمي ظهور السيد صالح عبد الحميد، ذلك السياسي المعارض، الذي سجل مواقف بالضد من صدام حسين على أرض الجنوب العراقي، وقاتل بشراسة في أهوار الناصرية، وفي الانتفاضة الشعبانية عام (١٩٩١)، ونشط في أجهزة الإعلام، وساحات السياسة الدولية بعد لجوئه إلى رفحة، واستقراره في أميركا، ودعوته لإقامة مجتمع العدل والمساواة بأمانة في العراق الذي دخل عاصمته بغداد منتصراً مع كثير من السياسيين المعارضين بعد (٩/٤/٢٠٠٣)، داعياً الى إعادة بناء العراق الجديد وتعميره، ناهياً نضاله في حضن زوجة أستسلم سريعا لأطماعها، قبل الشروع بالخطوات الأولى للبناء، سامحاً لها الاستحواذ على الموجودات، والمساعدات المالية للحزب التي حصل عليها طوال فترة المعارضة وما بعدها، لتصرف منها على تمائم سحر تحميه من عيون الآخرين، تبعد نساء الغفلة عن طريقها الجديد، وبالمرة تقربه لرجال السياسة المهمين، وتبقي الزملاء السائرون معه في العربة غافلون، يتفرقون بين الميسورين، يفتشون عن عون مادي لحزبهم الوطني، قبل الأفول بسبب شحة التمويل... ألم يكن هذا نوعاً من الجنون؟.
ماذا تقول عن اتفاق جرى بين النقيب هاني محمد سعيد من الشرطة الاتحادية وبين إرهابيين يرومون تدمير بغداد، وقتل نسائها وأطفالها، على إيصال سيارتهم المليئة بالأسلحة، والمتفجرات، تحت حراسة دوريته من بوابة بغداد قريباً من الكاظمية، حتى اللطيفية مثلث الموت، لقاء ألف دولار، وزع نصفها على أفراد الدورية، واحتفظ بالنصف الآخر رزقاً حلالاً... ألم يكن من الانصاف، وصف هذا النوع من التردي بالجنون؟
ومن يصدق هذا في الزمن هذا، وباقي الأزمنة غير المجانين.
زمن بائس عقيم، فيه الكثير لو أخبرك أحدهم عنه في اجتماع سياسي، أو في مناقشة بحث علمي، أو جلسة سمر على ما تبقى من شواطئ دجلة عند (أبو نواس)، التي غادرها أولئك الجالسون الحالمون، فهل تصدقه؟
وإن صدقت اللامعقول فيه وفي غيره، ستكون إما مجنوناً حتماً، أو مرشحاً للجنون، لكنك وعلى الرغم من هذا الوصف بالجنون، كنت شاهداً عليه، يوم عدت بعد السقوط حالماً، ويوم حزمت حقائبك بعد الإحتراب الطائفي هارباً هذه المرة بسيارة إسعاف، لجزعك من أن سقوط صنمها سيعيد الى حلمك الحياة، هذا الحلم الذي تغربت من أجله سبع سنين عجاف قبل السقوط، وأخرى مثلها بعده، وما زال طريق الغربة أمامك مفتوحة، ما زال يكلم نفسه: الجزع هنا لا ينبغي أن يكون وارداً، والوداع في مستشفى همر سمث له طعم خاص، انتهى وكأنه لم يبدأ، والشقة المقصودة لغرض السكن ليست بعيدة، وسيارة التكسي جاهزة، والوقت المستغرق للوصول يكفي لتذكر تفاصيل السقوط السريع لبغداد، والفرص السانحة، ما ضاع منها، وما لم يضع، المهم مسك إحداها، أو تركها لتمسك بك، لا فرق، والأهم هو أن المحاولة كان يجب أن تبدأ من بغداد، في أول أيامها من الزمن الجديد الذي تم انتظاره طويلاً، ورسمت له الخطط كثيراً، وتم تأمل فجره الجديد وأحلامه الوردية، الفرص التي أردت أن تمسك بها قد انتهت، وفجر بغداد الذي حلمت به، مع بقية الحالمين من أهل السياسة والمعارضة، وطالبي الحرية، سيكون بعيداً جداً، أبعد من تلك البلدان التي توزع عليها القوم لاجئين، ومهاجرين، العيب الوحيد عدم إدراك الحقيقة، التي كان من السهل إدراكها حال الوصول إلى بغداد، أثناء العودة إليها من سفر الهرب الأول يوم (24/ 4/ 2003)عبر العاصمة الاردنية عمان، بعد الانتشاء بالسقوط، يوم التوقف إلى جانب سيارة حمل كبيرة، لعطل فيها، أو رغبة من سائقها في إثارة أزمة طريق أمنية، أو سياسية، أو لتفجيرها عن بعد لأغراض إرهابية.
لا أحد يعرف النوايا في أيام الفوضى والاضطراب.
ولا أحد في هذ الموقف الشائك، يفهم أسباب التوقف الكلي للسير على سكة القطار التي تقطع طريق بغداد - الرمادي، قريباً من حي اليرموك، وتشابك السيارات بجميع الاتجاهات، ولا أحد يصدق أيضا قيام ذلك الشاب الأسمر رفع مسدسه، وإطلاق إطلاقتين في الهواء، قبل توجهه إلى سائق سيارة الحمل، ليفتح بابها ويسحبه خارجاً، من دون الاهتمام بهيئته (سائق سيارة مسكين، أو إرهابي مريب)، ومن دون الالتفات إلى تاريخ صنع سيارته، الذي يرجع إلى نهاية الخمسينيات، وما يعنيه من احتمالات عطلها في كل متر تسيره على الطريق العام، وما تفسير قيامه بضرب السائق المسكين بقبضة مسدس عراقي الصنع(طارق)، على الرأس الأشيب، لينزف الدم بغزارة، يعده انتصاراً له في معركة كانت غير متكافئة، وشعور بالعظمة الجوفاء، دفعته لأن يسأل بحماقة:
- لماذا تسد الطريق؟
سكت السائق الكهل، سكوتاً فيه كم كبير من الذهول، زاد من العتمة وحال دون إدراك الحقيقية، التي تدور حول عدم إمكانية تحقيق الأحلام في القريب کما کان متصوراً، وحصول الاعتداء السافر على هذا السائق المسن، بحضور جمهور خليط من المبتهجين بإزاحة الدكتاتور، والمتوجسين من حصوله، صعق نفوس الجميع، وأفصح عن حقيقة مؤلمة تنبئ بالمزيد، وأزاح في ذات الوقت وشاح الغشاوة عن كم الأنانية الفردية، ومقدار الايثار المفقود من هذه النفوس المتعبة... مشهد، وعلى الرغم من قسوته، وكم الظلم الحاصل فيه لم يحرك الضمائر، ولم يدفع أحداً للوقوف مع السائق الأشيب المظلوم، وهو يتلوی من وطأة الضرب على رأس مكشوف، وكأنه منبوذ في بداية عهد بَشْرَ أصحابه انه سيكون خال من الظلم.
هل ان الضمائر ماتت، أو أن الحضور مذهولون، أو يتلذذون بمنظر الدم الذي صبغ شعر الرأس ولحيته البيضاء، وغطى الثياب الصفراء العتيقة بلون أحمر داكن؟
جميعها أسباب وارد في هذا المشهد المنفر.
أنت الحالم بالفجر الجديد كنت معهم، لم تفکر مثلهم بالوقوف مع الضحية، وحلمك مازال معلقاً على سطح الذاكرة المشوشة.
الموجودون في موقف الاعتداء المهين، متفرجون مثلك، أشبه بالمشلولين، لا يفهم سكوتهم عن الظلم المفضوح، واحتجاجهم المستور، ولا يفهم تبعثرهم الحاصل بعد سماع الهتاف المدوي من الشاب قاطع الطريق، بعد إتمام رغبته الجنونية في إسقاط الضحية مغشياً عليها(تسقط الديكتاتورية).
لقد سقطت مع سبق الإصرار في موقف الفرجة الحاصل عتبات الدكتاتورية، وسقطت معها معاني الحرية، واختلت مفاهيم الديمقراطية، وتشوشت الآمال لحظة قيام الشاب بإطلاق العيارات النارية، وابتعاد المتأملين بفجر بغداد الأصيل عن الضحية، ومنظر السيارات القادمة، والذاهبة على نفس الجانب من الطريق، وتدافعها لفتحه سهلاً لمعْتَدٍ وسط الزحام، ما يقرأ من صفحتها المشبعة بالدم: أنها بداية شؤم واضحة المعالم، لا يفترض بمن شاهدها أن ينتظر تحقيق حلم كبير بغد أفضل.
انفض الجمع الغفير سريعاً مثلما تجمع سريعاً قبل دقائق معدودات، وكأن شيئا لم يكن، وما زال يكلم نفسه: السائق المجني عليه ممدود جسده، فاقد الوعي وسط الشارع، تريد أن تحسب إسهامك في نقله إلى الرصيف مع بعض الشباب الذين تطوعوا، حسنة، قد تقلل من وطأة السيئة التي سجلت لمجرد الاكتفاء بالفرجة.... لكن أية حسنة هذه؟
إنك ومن تطوع من المتعاطفين المؤيدين للعهد الجديد، ومن حاول إقناع نفسه داعماً للديمقراطية، داعياً لحصولها، والمشاركين بسقوط الديكتاتورية، والذين أبدلوا ثيابهم القديمة بأخرى جديدة، جميعكم لم تدركوا حقيقة عدم بزوغ الفجر الجديد، أما من حاول التطوع لنقله إلى الرصيف لمجرد الرغبة بتجنب الآلام التي قد يسببها الضمير قبل موته تماماً، أو لفتح الطريق أمام سيارته التي حشرت مع باقي السيارات سعياً منه لحضور محاضرة عن النظام الديمقراطي الجديد، أو بلوغ موعد غرام قريب، فجميعهم لا يهتمون بالفجر الجديد إذا ما بزغ ثانية، أو غاب إلى أبد الآبدين.
لا أمل في بلوغ المرام، وبزوغ فجر بغداد الجديد مجرد أوهام، وسيارة التكسي التي تقلك من باب المستشفى اللندني، لم تتأخر في الوصول إلى باب العبارة التي تسكنها، لكنك تأخرت حقاً في الهرب، وفي إدراك الحقيقة، مع ذلك لا تبتئس مما حصل لك في عملك، وفي رقودك بمستشفى النعمان، لأن الذي حصل للسيد سامر، المستلقي على العشب قريباً منك، لا يمكن تخيله إلا من المجانين، ولا تيأس من التأخر في الهرب، ولا ينبغي الاهتمام لشأنه في بلاد، ستبقى طاردة لأهلها حتى بزوغ الفجر الجديد.... متى؟
لا أحد يعلم.
قد يعلم، ولكن بعد حين.
للراغبين الأطلاع على الجزء السابق:
https://algardenia.com/2014-04-04-19-52-20/thaqafawaadab/53653-2022-04-24-17-59-09.html
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1286 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- فيديو / أغرب الأسواق على الحدود الصينية الأفغانية ..
- جديد الدكتور ضرغام الدباغ / القوات الخاصة : تاريخ وتاكتيك من اعمالي صدر عن دار ضفاف
- ثمن الثقة
- التفكك الأسري ظاهرة تؤرق العراقيين!
- كلام من ذهب عيار ٢٤ قيراط - ١٦٠
- الكورد… وطنٌ يولد في القلوب قبل الخرائط
- صورة لصدام حسين أمام ترامب تشغل العراقيين .. ما القصة؟
- طائرة تزويد وقود بوضع استنفار.. سيناريو الهجوم الجوي يقترب من إيران
تابعونا على الفيس بوك




















































































