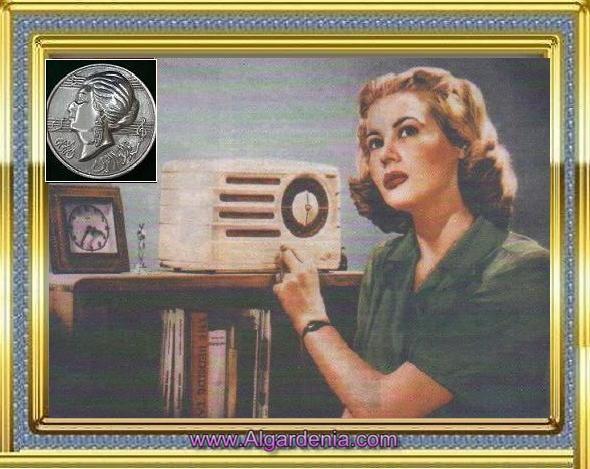مجموعة بلاد ما بين النهرين في متحف السليمانية
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 28 نيسان/أبريل 2025 08:02
- كتب بواسطة: د.أسامة شكر محمد أمين
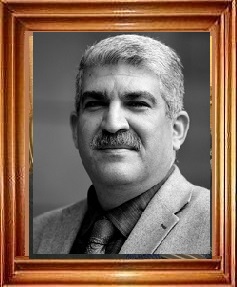
د.أسامة شكر محمد أمين
مجموعة بلاد ما بين النهرين في متحف السليمانية

هذا العنوان يمثل أحد مؤلفاتي الصادرة باللغة الإنكليزية عن إحدى دور النشر في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة في فبراير ٢٠٢٤. كانت زيارتي الأولى لمتحف السليمانية في أوائل عام ٢٠١٠، وتجددت في نهاية مارس ٢٠١٣ بالتزامن مع افتتاح قاعة "تاريخ الكتابة – في الكتابة" الجديدة، ضمن مشروع تطوير وإعمار المتحف برعاية اليونسكو. في ظل إغلاق المتحف العراقي في بغداد منذ الغزو الأمريكي عام ٢٠٠٣، مثلت زياراتي المتكررة لمتحف السليمانية نافذتي الوحيدة لاستنشاق عبق تاريخ بلاد الرافدين العظيم، دجلة والفرات. وقد حظيت بتعاون ودعم كبيرين من صديقي العزيز، مدير المتحف آنذاك، السيد هاشم حمه عبد الله، الذي سهّل لي الكثير من الأمور المتعلقة بتصوير وتوثيق الآثار الموجودة في المتحف.
لطالما شغفت بتصوير الآثار والمتاحف والمواقع التراثية داخل العراق وخارجه، حيث أمتلك أرشيفًا ضخمًا يضم ملايين الصور عالية الدقة التقطتها على مدى عقود باستخدام كاميرات احترافية وعدسات متنوعة. في كل زيارة للمتحف، كنت أحرص على التقاط صور فوتوغرافية. وبمرور الوقت، تراكم لدي آلاف الصور التي توثق المتحف ومقتنياته. قمت بإنشاء صفحة متكاملة لمتحف السليمانية على موسوعة ويكيبيديا باللغة الإنكليزية في ١٦ يناير ٢٠١٥، مزودة بالصور، كما عملت على توثيق آثار المتحف وآثار بلاد ما بين النهرين الموجودة في متاحف إقليم كردستان العراق ومواقعه الأثرية من خلال نشر صور فردية مشروحة أو ضمن مقالات في موسوعات عالمية في الغرب. منذ ٢٠١٣.

عندما تعرضت محتويات متحف الموصل للتدمير على يد عصابات داعش الإرهابية (على الرغم من عدم تحديد تاريخ التخريب بدقة، إلا أن التنظيم بث مقطع فيديو للعملية في ٢ فبراير ٢٠١٥)، تفاعل العالم الغربي بحزن وغضب إزاء هذه الجريمة النكراء بحق التاريخ. لكن سرعان ما اتضح النقص الحاد في الأرشيف الصوري لهذه المحتويات، بما في ذلك التوثيق الاحترافي والعلمي لقاعات العرض في متحف الموصل والمواقع الأثرية والتراثية في محافظة نينوى. هنا، تبلورت لدي فكرة توثيق محتويات قاعات العرض في متحف السليمانية في كتاب مصور بالألوان مخصص لهذا الغرض.
تعود فكرة تأسيس متحف للآثار في مدينة السليمانية إلى عام ١٩٥٩ على يد عالم الآثار الراحل طه باقر. افتُتح متحف السليمانية في ١٤ يوليو (تموز) ١٩٦١، في مبنى صغير (منزل) مستأجر في منطقة العقاري/شورش وسط المدينة. قام المتحف العراقي (ومتحف الموصل) بإعارة دائمة للمتحف الجديد لمجموعة بلغت ٦٠٢ قطعة أثرية تعود إلى عصور مختلفة من تراث وادي الرافدين. تم تسليم سجلات هذه القطع للمتحف في سجلين (فُتحا في ٢ و٣ أكتوبر ١٩٦١) كان من المفترض أن يكونا متطابقين، إلا أن تدقيقي كشف عن بعض الاختلافات وعدم التناسق والأخطاء في التوثيق بينهما. تم اختيار السيد رفيق فتح الله، مدرس التاريخ للمرحلتين الإعدادية والثانوية، كأول مدير للمتحف. في منتصف السبعينات، ومع توفر ميزانية مالية كبيرة للدولة العراقية، وضعت الحكومة خططًا لإنشاء متحف جديد كبير بمواصفات ومعايير عالمية. تم اختيار أرض بمساحة ٦٠٠٠ متر مربع في قلب شارع سالم، بالقرب من المتحف القديم. انتهت الأعمال الإنشائية في أواخر السبعينات وافتُتح المتحف رسميًا في عام ١٩٨٠، قبيل اندلاع الحرب العراقية الإيرانية. أُغلق المتحف أمام الزوار طوال فترة الصراع، ثم افتُتح لفترة وجيزة في عام ١٩٨٩ (بقرار من إدارة المتحف دون ابلاغ أو موافقة بغداد التي اغضبتها الخطوة)، ليُغلق مرة أخرى امام الزوار (المصدر: مقابلة خاصة مع مدير متحف السليمانية في ذلك الوقت).
لحسن الحظ، لم يتعرض المتحف للتلف أو الدمار خلال عملية عاصفة الصحراء (حرب تحرير الكويت من الغزو والاحتلال العراقي) في يناير وفبراير ١٩٩١، ولم يُنهب أو يُحرق خلال انتفاضة الشعب العراقي في مارس ١٩٩١، حيث حماه أهالي المنطقة. ظل المتحف مغلقًا طوال فترة التسعينات. افتُتح المتحف رسميًا مرة أخرى من قبل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني آنذاك، السيد جلال الطالباني (رحمه الله)، في ٨ أغسطس ٢٠٠٠، ولم يُغلق خلال الغزو الأمريكي للعراق في مارس وأبريل ٢٠٠٣، وظل مفتوحًا للزوار حتى الآن، مع الدخول المجاني للمواطنين والأجانب.

على مدى عقود، وخاصة بعد عام ٢٠٠٤، أصبح المتحف يضم حاليًا قرابة ٩٠ ألف قطعة أثرية وتراثية (معظمها محفوظ في المخازن وغير متاح للجمهور، ولكنه متاح لطلاب الدراسات العليا)، وذلك من خلال بعثات التنقيب والتبرعات والمصادرات وعمليات الشراء وفقًا للقوانين المعمول بها. وقد أصبح المتحف، بمبناه الجديد والكبير الذي افتُتح قبل ٤٥ عامًا، ثاني أكبر متحف أثري في العراق بعد المتحف العراقي في بغداد.

بسبب أعباء عملي كطبيب استشاري للأعصاب في المؤسسة العسكرية وظروف شخصية أخرى، لم أتمكن من البدء في كتابة مسودة الكتاب إلا في نوفمبر ٢٠٢٣، بعد أن تفرغت بشكل كبير من العمل في القطاع الطبي الحكومي والخاص. قمت بمراجعة أرشيفي الصوري للمتحف منذ عام ٢٠١٠ وقمت بزيارات متكررة ومكثفة لتصوير وإعادة تصوير المعروضات والقاعات (بالإضافة إلى عدد قليل من الآثار الموجودة في المخازن، بما في ذلك المصادرة منها، لإدراجها في الكتاب). كان المتحف متعاونًا للغاية ومشكورًا، وفي كثير من الأحيان، كانت تُفتح خزائن العرض خصيصًا لي لإخراج الأثر وتصويره من زوايا متعددة. كانت معظم خزائن العرض خشبية وقديمة بزجاج عاكس للضوء، مما جعل الحصول على صور عالية الوضوح أمرًا صعبًا في كثير من الأحيان، لكن كاميراتي الحديثة وعدساتها المتطورة تغلبت على هذه المشكلة. قمت بتحديث العديد من الصور بإعادة التقاطها.

على مدى أربعة أشهر، ليلاً ونهارًا، وفي ليالٍ عديدة بقيت حتى الساعة الرابعة فجرًا للكتابة وتحرير الصور وقراءة ومراجعة المصادر القليلة المتاحة حول الموضوع. بصفتي مصورًا محترفًا، أمتلك العديد من برامج تحرير الصور المدفوعة الاشتراك، حيث لا يمكن إدراج الصور في الكتاب كما هي، بل يتطلب الأمر تحريرًا احترافيًا لجميع الصور، القديمة والحديثة. أما التصميم الداخلي للكتاب (تنسيق النصوص مع الصور وشروحها)، فقد أنجزته بجهودي الذاتية على الرغم من اعتراض دار النشر في البداية. توليت تصميم غلاف الكتاب بنفسي، حيث استلهمت اللون البني الداكن والخافت من تراب وطين السهل الرسوبي لبلاد ما بين النهرين الذي حافظ على هذه الاثار لألاف ومئات السنين. أما الصورة المركزية، فهي تجسد يد كائن أسطوري حامٍ يُعرف باسم "أبكالو" في اللغة الأكدية (حكيم)، وهو يحمل دلوًا صغيرًا يُعتقد أنه يحتوي على ماء مقدس (ربما من ثلوج جبال شمال العراق) كان يُستخدم في الطقوس الدينية. وتزدان هذه اليد بنقش مسماري يعود إلى عهد الملك الآشوري آشورناصربال الثاني، بينما يقف الحكيم أمام الشجرة المقدسة. هذا التفصيل مقتبس من لوحة جدارية كانت تزين احدى غرف القصر الشمالي الغربي للملك الآشوري آشورناصربال الثاني في عاصمته النمرود، الواقعة في محافظة نينوى، والذي شُيّد في القرن التاسع قبل الميلاد ومعروض في متحف السليمانية (ثمة رواية مفصلة حول كيفية وصول هذه الالواح الاشورية، وعددها ٨، إلى متحف السليمانية في العام ١٩٨٦ او ١٩٨٧، وقد استقيتها مباشرةً من السيد معتصم رشيد، الذي كان يشغل منصب مدير المتحف وكالة آنذاك و نشرتها في مقال مفصل وحصري في الموسوعة التاريخية العالمية في المملكة المتحدة في أكتوبر ٢٠١٦).

وثق الكتاب بدقة تاريخ متحف السليمانية وقاعات عرضه للآثار من الداخل بصور عديدة ومتنوعة تاريخيًا ومتسلسلة لتوضيح التغيرات التي طرأت على المتحف من عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠٢٤. توزعت محتويات الكتاب على خمسة فصول، تبدأ بالتصميم الداخلي (وفقًا لمسار الزيارة، بما يشبه الزيارات الافتراضية)، يليها عرض للمقتنيات حسب القاعات والتحديثات الزمنية والتطوير، ويختتم بفصل خاص عن المسكوكات و (حصريًا) بعض القطع غير المعروضة والمصادرة والمزيفة.
عند كتابة مسودة النص، واجهتني معضلتان. الأولى كانت الغياب التام للشرح لمعظم المعروضات وعدم ذكر مكان العثور على الأثر أو مصدره (المعثر). والثانية كانت كيفية الوصف والشرح (في ظل غياب الشرح، كان هناك في أحسن الأحوال سطر واحد فقط لعدد قليل من القطع المعروضة)، فالكتاب ليس أكاديميًا بحثيًا موجهًا لطلاب الدراسات العليا أو الباحثين أو فرق التنقيب الأثرية، بل هو موجه لعامة الناس، لذلك كان يجب أن تكون لغة الكتاب الانكليزية سلسة وسهلة الفهم.

لدي خبرة عقدين من الزمن في كتابة مقالات تاريخية وأثرية في موسوعات عالمية غربية باللغة الإنكليزية، وأنا شخصيًا معروف في الأوساط الأثرية (أو الاثارية) الغربية. فقد استُخدمت صوري (ومنذ سنوات عديدة) التي تزيد على أربعين ألف صورة (مع شروحها المفصلة) المنشورة في الموسوعات وعلى الإنترنت لآثار بلاد ما بين النهرين وبقية الحضارات (بعد الحصول على إذني وذكر اسمي بجانب الصورة) من قبل مؤلفين لكتب مختلفة الأغراض، ومقالات، وبرامج تلفزيونية ووثائقية، وطلاب دراسات عليا في أطروحاتهم، ومعارض مختلفة، ومدارس، وكليات، وملصقات دعائية لمؤتمرات (مع ملاحظة أن جهات رسمية حكومية مركزية عراقية في بغداد وحكومة أربيل وجهات خاصة من كتاب ومقالات ومطبوعات عربية وكردية استخدمت العديد من صوري دون إذني ودون ذكر اسمي وحتى دون توجيه الشكر لي).
نظرًا لأن معظم الآثار المعروضة في القاعات هي تلك التي وردت من المتحف العراقي (ومتحف الموصل) في الستينات والسبعينات، فقد أمكن العثور عليها في مطبوعات عراقية أو في دوريات أو كتب غربية، خاصة إصدارات فرق التنقيب من سنوات الثلاثينات إلى الثمانينات من القرن الماضي. تمكنت من العثور على هذه المصادر، في أحيان قليلة بعد دفع رسوم اشتراك أو شراء، حيث إن أرشيف متحف السليمانية الورقي والإلكتروني لم يكونا عونًا كبيرًا لي لخلوهما من معلومات عديدة وشح الشروح.
يضم المتحف حوالي ٩٠ ألف قطعة أثرية تعود إلى العصر الحجري القديم الأوسط (٣٠٠ ألف - ٥٠ ألف سنة مضت) وحتى أوائل القرن العشرين الميلادي. ويتضمن كتابي ما يقرب من ٩٨% من القطع الأثرية المعروضة في المتحف. لم أتمكن من معرفة من اختار المجموعة الأولى التي شكلت نواة المعروضات في عام ١٩٦١، إلا أنني وجدت أنها، على الرغم من صغر حجمها، تحتوي على رسائل وخصائص رائعة وتفاصيل رافدينية مميزة (مع التذكير بغياب الشرح بجانب القطع للزوار، حتى ولو كان بسيطًا، وهي سمة قد تكون شبه موحدة في جميع المتاحف العراقية).

يعرض متحف السليمانية بعض القطع الرافدينية التي لا تقدر بثمن، كاللوح الخامس من ملحمة كلكامش، وأحد الفؤوس الحجرية الذي يعود إلى العصر الآشولي (حوالي ١٠٠ ألف سنة قبل الميلاد)، أو مجموعة من عاجيات النمرود، أو قطع من برونزيات اللورستان، والأحجار المنقوشة بالخطين الفرثي والفارسي الأوسط من المبنى (أو البرج) الاحتفالي في ممر بايكولي للملك الساساني نارسيه، والعديد من الفخاريات والألواح الطينية والأختام الأسطوانية. يعرض المتحف مجموعة رائعة (ولكنها متفرقة العرض) لبعض التماثيل السومرية (التي تعود إلى عصر فجر السلالات في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد) بالإضافة إلى بعض الأختام الأسطوانية ورؤوس الصولجانات التي تعود إلى عصر جمدة نصر (حوالي ٣٠٠٠ سنة قبل الميلاد). بعد البحث والتقصي في المصادر التاريخية، تمكنت من العثور عليها في تقارير بعثة التنقيب (المعهد الشرقي في شيكاغو، في ثلاثينات القرن الماضي)، التي عثرت عليها فيما يسمى بالمدن السومرية في وادي ديالى (تل أسمر، خفاجة، تل أشجالي، وتل أجرب). بعد بحث طويل، وجدت أن هذه الآثار موجودة في قوائم على موقع إلكتروني يتبع المعهد الشرقي لمفقودات المتحف العراقي عندما تم نهبه في أبريل ٢٠٠٣، في حين أن هذه الآثار موجودة في متحف السليمانية منذ عام ١٩٦١، مما يدل على وجود خلل كبير في التوثيق والاتصال والتعاون بين المتحف العراقي والمعهد المذكور، وقد نشرت انا النتائج مع الصور التوثيقية في مقال كبير باللغة الانكليزية في إحدى الموسوعات الأثرية في ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ وأدرجتها في كتابي أيضًا.

يُعد كتاب "مجموعة بلاد الرافدين في متحف السليمانية: رحلة عبر آلة الزمن" أول كتاب يُنشر على الإطلاق باللغة الإنجليزية، يتناول متحفًا أثريًا عراقيًا بشكل خاص، مُفصّلًا محتوياته باستخدام ١٠٤٦ صورة ملونة. ويأتي الكتاب في المرتبة الثانية (بعد ٥٢ عامًا) بعد كتاب "كنوز المتحف العراقي" للدكتور الراحل فرج بصمه جي عام ١٩٧٢ (باللغة العربية)، والذي تضمن ٢٩٦ صورة بالأبيض والأسود. تجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب لم يتلقَّ أي دعم أو تمويل أو تكليف أو رعاية من متحف السليمانية أو أي جهة أخرى. يعكس الكتاب حب المؤلف وشغفه ببلاد الرافدين وشغفه بمفهوم الخلود، وقد كُتب بدافع التطوع دون أي مقابل وبجهود ذاتية بحتة.
صدر الكتاب يوم السبت، ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ في أمريكا وأصبح متاحًا للشراء في جميع أنحاء العالم عن طريق دار النشر هناك. أعلنت عن الكتاب عبر حساباتي الشخصية على فيسبوك ولينكد إن وإنستغرام. من المتعارف عليه، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم، أن يقوم المتحف و/أو دائرة آثاره بالاحتفاء بالكتاب الذي أوصل إلى العالم محتويات المتحف الرافديني في مدينة السليمانية في كردستان العراق، عن طريق كتاب فاخر الطبع متاح لكل دول العالم (مجاني التكلفة بالنسبة للمتحف ودائرة آثاره وتراثه، إذ لم يتم الصرف عليه بفلس واحد أو أي جهد من قبل حكومة إقليم كردستان). بعد طلب مني، نشر المتحف على صفحته على فيسبوك منشورًا قصيرًا متواضعًا عن الكتاب حينها، فيما التزمت دائرة آثار وتراث السليمانية الصمت. لم ينبس ببنت شفة ولليوم، إعلام السليمانية الحكومي والخاص والحزبي. على النقيض، كانت صحيفة الزمان الطبعة الدولية سباقة في إخبار القراء عن الكتاب في ٣ مارس ٢٠٢٤، تبعها موقع المسرى في ٢١ مارس ٢٠٢٤، والحالتين أعلاه يعود الفضل فيهما للأخ الفاضل الإعلامي والصحفي جمال الفياض، مستشار رئيس جمهورية العراق الأسبق. بدعوة كريمة من المنتدى الثقافي العراقي في المملكة المتحدة، من قبل الزميل الفاضل وطبيب الجلطة الدماغية الكفء د. عامر هشام الصفار، قدمت محاضرة عن كتابي وكواليسه في ٣١ مايو ٢٠٢٤. كان بين نشر الكتاب وحفل توزيع جوائز وتكريم للمبدعين من قبل مؤسسة كبيرة تمول حزبيًا من الحزب الأكبر في السليمانية حوالي الشهرين. لذلك تم وعدي بأن أكون في قائمة المكرمين (عن مجمل أعمالي للتوثيق ونشر التاريخ والتراث عالميا، على الرغم من كوني طبيبا) في السنة التالية (٢٠٢٥) ولم يحدث.
كان مؤسس المتحف البريطاني في لندن في القرن الثامن عشر طبيبًا باطنيًا ورئيسًا لكلية الأطباء الملكية في لندن في ١٧١٩، ومن جهة أخرى، كان طبيب أمراض النساء والولادة جيمس سيمبسون نائبًا لرئيس جمعية الآثار الإسكتلندية وله مساهمات عديدة في علم الآثار. لذلك، ليس غريبا على الاطباء الانغماس في حب التاريخ و الاثار.

لمدة عام تقريبًا، بيع عدد كبير من الكتاب لقراء من أنحاء متفرقة في العالم ووصلت رسالة العراق ورافديه لهؤلاء. ملاحظة أخيرة أود ذكرها وهي أن العائد المادي من بيع الكتاب يكاد يكون لا شيء (تقريبا دولار ونصف للنسخة الواحدة المباعة)، لتكلفة الطباعة العالية (٨٧ دولارًا أمريكيًا، طباعة فاخرة ملونة على ورق فاخر وتجليد ممتاز الدرجة) والتوزيع والشحن العالية (يصل مع الشحن حوالي ١١٠ دولارات). صدرت حديثا النسخة الإلكترونية (بصيغة المستندات المنقولة) وبسعر أرخص بكثير (٣٩ دولار امريكي)، اذ يمكن تنزيل الكتاب مباشرة وقراءته بعد الشراء. يحتوي الكتاب على ٣٩٠ صفحة.

ختامًا:
إلى بلاد ما بين النهرين العظيمين، دجلة والفرات، سومر وأكد، نينوى وبابل، التي ما برح شعاع نورها يسطع على الكرة الأرضية منذ فجر البشرية
إلى والدتي الحبيبة، الاستاذة غريبة عبد الله علي الجاف، التي غرست فيّ حب اللغة العربية والنحو العربي والشعر العربي والتاريخ العربي، ونحن لسنا عربًا
إلى زوجتي العزيزة وبناتي الحبيبات، شكرًا لهن على صبرهن بمنحي الوقت الكافي لأتم عملي وأنا بكامل راحتي
إلى شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس لكي نحيا نحن وأبناؤنا وأحفادنا بأمن وأمان
الى كل هؤلاء، أهدي هذا العمل
الدال أسامة شكر محمد أمين
استشاري امراض طب الاعصاب وزميل كليات الأطباء الملكية في ادنبرة وغلاسكو ودبلن ولندن
ملاحظة: جميع الصور محفوظة للمؤلف ومأخوذة من محاضرتي في المنتدى الثقافي العراقي في المملكة المتحدة باللغة العربية
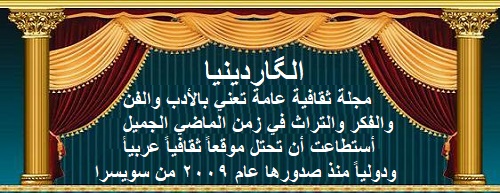
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1326 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- نَسَمَاتُ الصَّبَّاحِ
- والأنضباط العسكري والسيطرات وعسكرة المجتمع
- خواطر مواطن عراقي ساذج
- الحرامية .. تاريخها وكيف هي الان في عراق حاميها حراميها
- دفنت الآلاف تحت الأرض .. سر الحاسوب الذي حاولت أبل إخفاءه من التاريخ
- الجيش العراقي يعلن انسحاب القوات الأميركية من قاعدة عين الأسد وتسلم إدارتها بالكامل
- ترامب: حان وقت إنهاء حكم خامنئي!
- ليلة غزو الكويت .. وثائق تكشف كيف "كذبت" تاتشر وتركت ركابها "دروعاً" لصدام
تابعونا على الفيس بوك