ليلة عيد عراقية
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 14 شباط/فبراير 2025 13:08

ليلة عيد عراقية

خيالات من الماضي
انتهت فترة الطواف المقررة في بغداد وبابل والبصرة، قالت ها قد استحق الأمر عودة إلى الديار، فكانت الوجهة مطار بغداد، طريقًا سالكةً لها أو الوطن البديل، هذا المطار الذي يُشعر من تعوّد السفر منه وإليه في هذه السنة، وكأنّ ذرات الغبار التي علقت فوق أقواسه الأندلسية، على مرّ السنين بدأت تزال تدريجيًا، وأنَّ أهله، أو بعضهم أدركوا ضرورة محو الترسبات الراكدة في العقل عن أهوال السياسة والكسل، وشرعوا بالتنفيذ.

درجتْ على أرضه الإسمنتية طائرة الخطوط القطرية متجهةً صوب الدوحة، ومنها إلى لندن، وَقَفَت بداية المدرج، أقلعت مرتفعة قبل بلوغها نصفه الأول، وكأنّ طيّارها يستعجل الارتفاع، لرحلة له هي الأولى من بغداد، أو لبقايا قلق قديم من إرهاب استهدف المطار علق في قعر بوصلته الشابة لم تمحُه أيام تتجه فيها بغداد الى الهدوء، قالها الرجل الجالس على الكرسيّ المجاور، فأجاب آخر، أو لأن الريح في الواجهة استعجلت الاقلاع.

دارت نصف دورة لتأخذ طريقها باتجاه الجنوب، انخفض جناحها الأيمن قليلًا لإكمال نصف الدورة الآخر، بانت من تحته بغداد صورة عروس تشكو أهلها قبل الزفاف، موكب عرسها وساحة الاحتفال، وباحة بيتها، والجيران انحسرت من حولهم الخضرة، وأنْبِتَ بَدل النخيل وأشجار الرارنج بيوتًا تشبه حاويات رصت قبل الشحن، وبان من بعيد وحش التصحر كمن يريد التهامها عروسًا لم تهنأ بليلتها بعد.
لقد تغيرت الصورة، وتبدلت شكوى العروس، صارت عتبًا على العريس وأهله، وسؤال مع دمعة نزلت غصبًا عن الجنائن المعلقة، والنهرين، وقلق من غد تعتقده سَيُغيّر من طعم الحياة بعد العرس، أمّا أنا فبت أنتظر استقرار الطائرة عائمة في أجواء خريف هي الأحلى في العراق، لاحظت من تحتها دجلة العملاق نصف نائم، هدأ الشخير في مجراه، وتكاثرت وسطه جزر الرمل، وعلى حافاته حزم القصب تحرس غفوته والمنام.
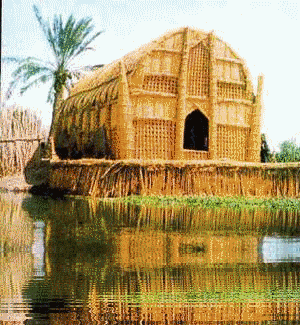
قلت سأترك دجلة نائمًا، وأغادر خوفي من الغد والتصحر، وعراقيل البناء، وأفعال السياسة، وَشحتُ بنظري صوب الأهوار، سألت عن موقعها، وهل بقيت متعامدة على خط الطيران لأقارن صورها مع صور في رأسي عن قصبها والأكواخ
وسومرية تجوب مياهها بـقارب خشبي (مشحوف)، يوم كنت طيارًا أحلّق بطائرتي السمتية فوقها مستمتعًا بالخضرة وزرقة المياه وأكواخ القصب، وفحول الجاموس في ثمانينات القرن الماضي. مازلت أتخيل الماضي، وأنا كذلك أتخيل لاح لي التواء النهر جليًا، وقد اتسعت رقعة مجراه وانتشرت بقع مياه تسربت من حوله، ابتعدت عنه مرة واقتربت إليه في أخرى، كأنها تريد احتضانه قبل موت محتوم. جلت بنظري يمينًا وإلى الشمال، غيّرت موقع جلوسي في الطائرة إلى الجهة الأخرى، وصفت المشهد بقايا هور، سألتها بلسان محموم أين القصب والبردي وخضرة كانت يانعة؟
أين المشاحيف وفوانيسها، وأسراب الطيور المهاجرة، والصيادون بفخاخ تركها الأجداد؟

أين ذاك التنّور ودخان الساجور برائحة الخبز المطعم بأنفاس الأمهات؟

أين النسوة اللواتي حملن جمال الطبيعة في وجوههن السومرية السمراء، وعباءات لُفَتْ وسطهن وقوفًا حول التنّور؟
ماذا حلَّ بحورية الهور، وحامل الفالة، وبقايا الأجداد؟
لم تجب على أي من أسئلتي الوهمية، لأنها وغالبية المسافرين مشغولون بهموم ليس من بينها الهور.
تركتُ الأسئلة، حاولت إعطاء عينيَّ استراحة إجبارية، لم تنفع عندما لاحت في الأفق بقعة ماء لا حدود لها، ألزمتني إعادة الحملقة قسريًا، وفتحت الأسارير، ودفعتني إلى الالتفاتة صوبها لأقول :
"هكذا كان الهور مسطح ماء أبعد من أن تحدد حافاته العين، يوم كان مركزًا لهذا الكون". نشوة فخر لم تدم، إذ ظهر من بعد جرفًا مقوسًا، وممرًا، وباخرة تدخل وأخرى تغادر وجزيرة تخنق المسار، ألزمتني هي الأخرى معاودة الالتفات اليها لأقول: "هذا ليس الهور.. إنه الفاو ساحل العراق على الخليج، وأرضه الجرداء، وبداية الماء المالح ليس فيه من روائح الهور". بسببها وصدمة هروب الهور أغلقت نافذة الشباك ورحت أفتش في ذاكرتي عن صورٍ لأرض الفاو يوم ملأتها حفر القنابل، ومتاريس الجنود، وطائرة سمتية هوَت بقائدها محمود، وجنود أبطال يخوضون في مملحتها معارك البقاء، وستون ألف من القرابين، وهكذا استمررت ألوك في رواسب ذاكرتي حتى أخذتني غفوة نصفها إحباط، ونصفها الآخر إحباط.
غربة عيد
حل الصباح في العاصمة البريطانية لندن، تناثرت عبر الهاتف النقال آلاف الرسائل المصممة للتهنئة الكترونيًا مثل غزارة المطر الذي ينهمر في هذه المدينة مدرارًا طوال السنة، تيقنت منها ومن لقطات عبر قنوات التلفاز أنه العيد.

تلفت يمينًا وكذلك إلى الشمال لم أحس رائحة العيد البغدادي، ولم أتأمل فطورًا من الكاهي وقيمر السدة المشهور، ولا زيارة يجتمع فيها الأولاد عند دار العائلة الكبير يلعب الأحفاد في باحته ساعين لتعزيز رابطة الدم، شعرت بقدر من الغربة، أعادتني انفعالاتها عقليًا الى رتابة لا معنىً فيها للعيد، سوى الرد على تلك التهاني التي لا تنقطع، صورًا ولقطات مستنسخة خالية من دفء المشاعر المكتوبة بأصابع اليد.

قالت بشرى مبتسمة ابتسامتها المعهودة لقد وجدت الحل سهرة مع مطربة المقام العراقي السيدة فريدة تقيمها في فندق وسط لندن يمكن الشعور في محيطها ببهجة العيد، ووجدت نفسي سائرًا في طريق الحل كمن يفتش عن مبتغاه.
دخلت المطربة قاعة أحتل فيها جمع غفير من الراغبين في إيجاد حل لغربة عيد، وعشاق المقام العراقي الأصيل أماكنهم حول طاولات مدورة. مشت ببطء واثقة من نفسها، ابتسمت بنكهة عراقية رافعة كلتا يديها تحية تقدير إلى جمهور صفّق لها منذ لحظة اطلالتها حتى جلوسها على كرسي في مقدمة عازفين تميزهم السدارة الفيصليّة، في مشهد لو صُوِّر بتقنيات الأبيض والأسود لانعكست على أخاديد الذاكرة صورة عملاق المقام العراقي يوسف عمر جالسًا يشدو مقام الرست أواخر سبعينيات القرن الماضي.
مرت بصوتها الرخيم من الأغنية المشهورة آه جميلة إلى (گصري زبونچ) واشكان الدلال، ومن بعدها أويلاه يابه، وغيرها أُخرْ تنقلت بينها بسلاسة واقتدار، تنظر إلى جمهورٍ لم يرتوِ من عطش الغربة، يتعالى وسطه التصفيق مصحوب بزفرات، وأنين يأخذ الحالم إلى بغداد أيام تألقها نجمة في سماء الدنيا الفسيحة.
في استراحة عشاء وجبة طعام غلبت عليها النكهة العراقية سأل البعض بعضًا عن آخر زيارة له إلى بغداد كأن سلسلة الذكريات في عقولهم قد تقطّعت، وفقدت منها وصلات، أو أنهم يرومون إجابات وصفية تعينهم على تجميع صور تنعش ذاكرة أخذ العمر منها مأخذًا كبيرًا، إلّا شيخًا وقورًا إلى جانبه سيدة مُسنّة تسايره مثل ظله، يتكئ عليها وتتكئ عليه، سأل عن أحوال بغداد وعن حي البتاويين بلهجة موصلية فقدت من نصوصها بعض كلمات، قدم نفسه داوود وزوجته ڤيوليت، يهوديان هاجرا وأولادهما الأربعة من بغداد عام ١٩٦٣ إثر عملية دهم بيتهما بعد انتصاف الليل، فسراها خيارًا بين الهجرة، أو الذهاب بعيدًا في غياهب المجهول، فتركا الدار محبوسة في ألقها ومجد بغداد، سكنا لندن على أمل العودة إليها أم حنون يومًا من الأيام، لم تفارقهما العراقية، عادات، ولهجات تخاطب، وغناء، ونوع طعام وأمنيات عن أمل الموت في تلك الدار الموروثة ومواراة الثرى في بغداد بين قبور الأجداد، وعندما وجدا ودٍ في الاجابة عن كثير من الأسئلة التي تشغلهم، وعن ما جرى ويجري في بغداد، تقدما برجاء تغلب عليه لغة التوسل بالحصول على صورة حديثة عن قرب للدار، قالا إنها مازالت موجودة يتابعان وجودها من موقع (گوگل أيرث).
أنهت السيدة وصلتها الغنائية الثانية بتألق كما بدأت، هَمّتْ ملوحةً بتحية الجمهور، وتقديم الشكر لحضوره، أنعشها التصفيق فعاودت الغناء ثانية سلطانة طرب حتى الساعة الواحدة بعد انتصاف الليل.
في طريق العودة إلى البيت وسط زخات مطر خفيفة ودرجات حرارة تقترب من الخمس عشرة درجة، تيقنا حقًا أنه العيد.
**********

من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
مختارات
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1044 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- برنامج الأمثال البغدادية ( الشبعان ما يدري بالجوعان )
- لوريل وهاردي - عمل صالح واحد (١٩٣١)
- غارات على الحشد الشعبي غرب وشمال العراق .. وقتلى في القائم
- فاتورة "الأيام الستة" ١١,٣ مليار دولار تكلفة حرب واشنطن على إيران
- مسجد عمرو بن العاص .. معمار أصيل وروحانية في قلب مصر
- اعتراف إيراني أول لـ "رويترز" بإصابة المرشد الجديد مجتبى خامنئي
- مسلسل_عمر - الحلقة ٢٣
- امريكا .. الصين .. وحرب النفط الخفية في طهران وكراكاس
تابعونا على الفيس بوك





















































































