الحضارة المتنحية والحضارة المتفوقة / الجزء الخامس والأخير
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2024 15:42
- كتب بواسطة: نزار السامرائي
نزار السامرائي
الحضارة المتنحية والحضارة المتفوقة / الجزء الخامس والأخير
ولنأخذ عدة نماذج من فتاوى صدرت في أوقات مختلفة في البلدان الثلاثة أو في غيرها، كي تتضح لنا صورة ما عاشه الوطن العربي والعالم الإسلامي من صراع بين التجديد والتمسك بما هو سائد حينذاك.
لقد تعرّض كل اختراع جديد لردود فعل بعضها ساخط والآخر حائر والثالث موافق على استحياء، وعلى سبيل المثال في عام 1848م تم تركيب أول صنبور للمياه في مسجد "محمد علي" بالقلعة في العاصمة المصرية القاهرة، مما أثار جدلا حول صحة الوضوء منه، وتم استفتاء عدد من علماء الأزهر، فتحفظ بعض أتباع المذاهب، ولكن أتباع مذهب أبي حنيفة النعمان، أجازوا الوضوء، فأطلق العامة على الصنبور اسم "الحنفية" وهو ما زال مستخدما حتى اليوم.
وهناك رأي آخر يقول، إنه عندما تم مد مواسير المياه وتركيب الصنابير في منازل المواطنين في القاهرة نهاية القرن التاسع عشر، واستغنى السكان عن خدمة السقايين الذين يجلبون المياه إلى البيوت مقابل أجور، وكان عددهم كبيرا جدا، انتفضوا على هذا الانتقال، لأنه يتسبب بقطع أرزاقهم، ولكنّ من وقف إلى جانبهم لم يقل ذلك صراحة بل قال إن ذلك سيجعل طرق القاهرة مستنقعا للمياه الآسنة، لذلك توجهوا إلى أئمة المذاهب الأربعة لاستصدار فتوى منهم تحرّم استخدام الماء الخارج من مواسير المياه للوضوء، وبالفعل استجاب أئمة المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنبلية لمطالب الساقيين من منطلق ديني، لأنهم رأوا أن الوضوء من هذه الصنابير بدعة، كما أن انتشارها في الشوارع ساعد على وجود برك ماء، ولم يوافق عليها إلا فقهاء الحنفية الذين يحبذون الوضوء من ماء جارٍ، ولذلك فقد أطلق على الصنبور اسم الحنفية للمساعدة على قبول الشعب لها، وقد انتشر استعمال الحنفية بعد ذلك في باقي البلدان العربية والإسلامية.
أما في إيران التي تتبع المذهب الجعفري الاثني عشري، واقع الحال يؤكد أن رجال الدين الشيعة، يتمتعون بنفوذ كبير بين الأوساط الشعبية، ومن واجب الشيعي أن يعرف المرجع الذي يُقلده، وعليه طاعته في أوامره ونواهيه، وإلا سيعد خارجا عن الملة، وعليه أن يُقدم الخُمس للمعممين ذوي العمامة السوداء التي تتراكم أموالها لديهم، ولا يُسئلون عن الأبواب يصرفونها عليها، وما كان يحصل في إيران منذ أن فُرض عليها التشيّع بعد وصول الصفويين إلى حكم بلاد فارس عام 1500م، صاروا ينافسون الحكومات سلطتها، ولا تستطيع وقف الخُمس أو الزكاة عنهم، لأنهم قادرون على إثارة أعمال العنف بوجهها، كما حصل في مرات عديدة منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر، وحتى وصول الخميني إلى السلطة في شباط 1979/م، والذي فرض التشيّع كدين رسمي للبلاد بموجب الدستور الذي أعده ومرره في استفتاء استغل حالة الهياج الشعبي التي سادت البلاد، وأدت إلى إسقاط الشاه محمد رضا بهلوي، ولقد ظل رجال الدين في إيران يتحكمون في القرار السياسي في البلاد ولديهم القدرة على تحريك الشارع ضد الحاكم، تحت لافتة خروجه على القيم الدينية ومبادئ التشيّع، وأخطر ما في التشيّع أن الفتوى عابرة للحدود السياسية بين الدول، فأي مرجع وصل مرتبة آية الله العظمى، له مقلِدون من خارج الدولة التي ينتمي إليها، ولكن هناك نقطة لا تقل خطورة عن السابقة، وهي أن معظم رجال الدين الشيعة الذين وصلوا مرتبة عليا هم الإيرانيين، وخاصة من القومية الفارسية، أو من الآذريين الإيرانيين، وبالتالي فقد تأتي معظم فتاواهم بما يتطابق مع المصلحة الإيرانية، مع تغليف الحجة بأنها تتطابق مع مصلحة المذهب، على هذا يتوقع كثير من المراقبين أن الفتاوى التي تصدر من إيران ستجد كثيرين يلتزمون بها، بحكم تقليدهم للمرجع الذي أفتى بها.
ولكن الحال تغيّر كثيرا بعد وصول الخميني للسلطة عام 1979، إذ بدأت سلطة الخميني تكييف الفتوى الدينية بما يتناسب مع المصالح السياسية لنظام الحكم الجديد، فعلى سبيل المثال صدرت فتوى تمنع الدولة من صنع السلاح الذري، ولكن في حقيقة الأمر لو أن إيران وصلت إلى مرحلة التمكن من صنع هذا السلاح فسوف نجد أن ولي الأمر سيكون على استعداد تام لإعادة النظر بتلك الفتوى من منطلق، أن الظروف السابقة التي صدرت فيها فتوى التحريم تبدلت، وأن من مصلحة "الإسلام" تقتضي امتلاك هذا السلاح "لحماية بلاد المسلمين".
وهناك فتاوى كثيرة استجابت لمنطق بناء الدولة، حتى لو كانت على حساب فتاوى سابقة مضادة.
وفي العراق أفتى المرجع الشيعي الأعلى محسن الحكيم بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1958، وتم الاستيلاء بموجبه على ما كان يزيد عن ألف دونم من أراضي الإقطاعيين، وتوزيع الأراضي المنتزعة من الاقطاعيين على الفلاحين، بواقع عشرة دونمات لكل فلاح "الدونم الواحد في العراق يبلغ 2500 متر مربع"، فقال الحكيم في فتواه، "الصلاة في الأرض المغتصبة حرام" ويقصد بذلك الأرض التي حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي، مما أجبر الفلاحين "حتى أولئك الذين لم يصلوا في حياتهم" على ترك أراضيهم بحكم ما للمرجع الديني الأعلى لدى الشيعة من سلطة مطلقة على مقلديه، وتسبب ذلك في تدني الإنتاج الزراعي العراقي إلى مستويات مخيفة، وعندما حاول الفلاحون العمل لدى الاقطاعي أشاح بوجهه عنهم، وهو ما تسبب بهجرة الألوف من الفلاحين من الريف العراقي إلى المدن بحثا عن فرص أفضل للعمل في وظائف لا تتطلب مهارات، حتى لو بأجور زهيدة.
وعام 1959 عندما سيطر الحزب الشيوعي على الحياة السياسية والشارع السياسي في العراقي، بدعم من الزعيم "العميد" الركن عبد الكريم قاسم، أفتى الحكيم فتواه المعروفة ضد الحزب، فقال "الشيوعية كفر وإلحاد"، وبذلك يحمّله البعض جزءً من المسؤولية الأخلاقية عما لحق بالحزب الشيوعي من عمليات انتقام.
إذا أردنا أن نعمم مثل هذه الفتاوى على الاختراعات الحديثة وما تطرحه من صناعات، علينا أن نسأل، كيف سيكون رد فعل رجل دين تشبع بأفكار وقوالب جاهزة أخذها عمن سبقه، ولم يحاول أن يختار لنفسه مسلكا خاصا في الاجتهاد، على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى حث على التدبر والتفكير بكل ما يحيط بالفرد من ظواهر، ونبذ فكرة "وَجَدنا آبَاءنا كذلك يَفْعَلُونَ".
وهناك فتوى لا تقل غرابة في مقاومة التجديد، تقول "كيف تتركون حمير الله وتركبون الشمندفر، أي القطار" ويذهب البعض للقول إنها تركية عثمانية، حرّمت ركوب القطارات الحديثة لأنها اعتبرتها بدعة لا يجوز استخدامها للتنقل، ويقول آخرون إنها فارسية عندما بدأ تشغيل أول قطار في بلاد فارس بداية القرن الماضي.
وبعد الاحتلال الأمريكي طفت على السطح فتاوى في غاية الخطورة على فرص تطور العراق اقتصاديا وعلميا، تقول إن الثروات الطبيعية التي لا دور للإنسان في صنعها، مثل النفط، ومناجم الحديد والذهب والنحاس والفوسفات والكبريت وغيرها من المعادن الأخرى شأنها شأن المطر، لا يمتلكه أحد وبالتالي، فهو ثروة ليس من حق الدولة التصرف بها، وبالتالي هي تحت تصرف ولي الأمر، ولما كان مصطلح ولي الأمر ينصرف إلى المرجع الشيعي الأعلى، فيجب أن يُحصر به التصرف بأموالها، وهناك شعور كبير بأن أصل الفتوى جاءت من عناصر إيرانية هدفها التحكم بالثروة النفطية الثمينة وتحويلها إلى المراجع داخل إيران أو على الأقل السيطرة على خُمسها.
لماذا لم تُطرح مثل هذه الفتاوى في إيران بعد وصول الخميني للسلطة بل وحتى قبل ذلك؟ الجواب واضح وضوح الشمس، وهو أن الخميني صادر سلطة رجال الدين، وحصرها بمرجعيته التي فرضها بقوة السلطة التي امتلكها بعد وصوله للحكم، أما في عهد الشاه محمد رضا بهلوي، فإن السلطة كانت من القوة بحيث لم يجرؤ أحد على منازعتها صلاحياتها وسلطاتها، أما إذا سألنا لماذا لم يُفتِ أحد من رجال الدين بإصدار مثل هذه الفتوى قبل الاحتلال، فإن الجواب عن هذا السؤال لا يتأخر كثيرا، وهو أن الدولة التي نشأت عام 1921، كانت دولة مدنية ولم تتبنَ خيارا آخر، ثم إن الحكم لم يطرح نفسه ممثلا لأي من المذاهب الإسلامية، وأخيرا يمكن القول إن قوة النظام السياسي، وحدها هي التي تحدد طبيعة التعامل معه من الجميع.
أما في المملكة العربية السعودية، التي تعتبر نفسها مركزا معنويا عالي التأثير على معظم الشعوب الإسلامية، فقد تقلبت في مواقفها في مجال الإفتاء من الشيء إلى ضده، في غضون سنوات قليلة، ولو عدنا إلى عهود ملوك آل سعود منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، إلى عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، لوجدنا أن "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" كانت تتشدد إلى حدود بعيدة في رصد سلوك مواطني المملكة والمقيمين، وتعاقب المخالفين لتعليماتها، ومن بين الفتاوى التي أصدرتها "عدم جواز قيادة المرأة للسيارة" وكثير مثل تلك الفتوى، ولكن بعد وصول الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حصلت تغييرات كثيرة، وتحول تحريم قيادة المرأة للسيارة من موضوع رأي عام بسبب الحظر السابق، إلى إباحة مطلقة لاحقا، إذ تمت إباحة ساحات كانت مغلقة بوجه المرأة، وغير ذلك مما يجري في المملكة العربية السعودية، من إقامة مهرجانات فنية مختلفة وفتح دور السينما.
فهل كان الانفتاح الجديد هو عن إيمان طارئ نزل على المشرّع الرسمي، فاقتنع به المُشرِّع الفقيه، علماً بأن أحداً لم يجرؤ حتى الآن على إعطاء توضيح عن سبب هذا الانقلاب في مسارات الفتوى، صحيح أن الفتوى تعبر عن بيئة وزمان الإفتاء بها ومكانه، ويمكن أن تتغير بتغير الزمان والمكان، ولكن ليس على هذا النحو الفجائي الذي ترك المسلمين في حيرة من أمرهم.
من حق المسلمين أن يعرفوا حيثيات الموقف الفقهي للسعودية الجديد في هذا المفصل، أي بالتعامل مع قضية المرأة، هل كانت الفتوى السابقة نابعة من موقف ديني، أم عن تقليد اجتماعي مستمد من قناعة اجتماعية تعود بأصولها إلى مجتمع البداوة الذي عاشه العرب قبل الإسلام في جزيرة العرب؟ يجب أن نعرف أي الموقفين هو الصحيح، أليس ذلك من حق المسلمين؟
وأخيرا علينا أن نجد الجواب عن هذا السؤال الأكثر أهمية، هل كان للفتوى الدينية دوراً في تأخر الدول العربية والإسلامية؟ أم أن أي تطور هو منظومة منسجمة ومتكاملة الخطوات، وتأتي من خلال استيعاب المعارف في مجال التكنولوجيا، وتوظيفها التوظيف الصحيح ولا تخرج من فراغ، ذلك أن غياب المشروع الاقتصادي المستند على أسس علمية، هو الذي يلعب دوره في إقامة المصدات أمام أي نهوض علمي واقتصادي؟ أم أن تفشي الأمية والجهل في المجتمع هي التي لعبت الدور الأخطر في الإبقاء على حالة التخلف وبطء التحولات المطلوبة؟ أم أن غياب النظام الديمقراطي في الحكم يتحمل المسؤولية كاملة، في إبقاء مجتمع ينتمي زمنيا للقرن الواحد والعشرين، ولكنه في تقاليده وعاداته وقيمه السائدة، ما زال يعيش في الفترة المظلمة؟ ربما عانى مجتمعنا العربي كثيرا من عقبة الفتوى الدينية المتسرعة، والمُقيدة لامتلاك أدوات التطور، والتي ستتحول إلى إرث مقدس مع التكرار، لأنها لا تصدر عن فقهاء محل إجماع من المسلمين، ولم يسأل أحدٌ إن كان هؤلاء يلتزمون بفتواهم في سلوكهم وفي بيوتهم قبل أن يحاولوا فرضها على الناس أم لا؟.
في العراق الذي نراقب الأوضاع فيه من كل الجوانب، فالحكم فيه هو استنساخ لتجربة الحكم في إيران، ويبدو فيها العراق مثل بابٍ من جزئين، أحدهما مفتوح عن آخره، والآخر مغلق بإحكام، فبعض المسؤولين الدينيين والسياسيين فيه، لا يقبل أن يَمد يده لمصافحة سيدة، لأنه يعتبر الأمر حرام، في حين أنه لا يطهر يديه من المال العام ولا من الدم الحرام، ولا يحاول التصدي للظلم الواقع على أوسع قاعدة شعبية إلا إذا كان من اتباعه السياسيين أو المذهبيين، وهناك من اكتنز المليارات من الدولارات، بعد أن كان بلا ماضٍ لا في عالم المال ولا في عالم السياسة.
إن العالم يسير بسرعة كبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتسخيرهما في خدمة الإنسان، على الرغم من أن الدول الكبرى لا تفكر بالأمر على هذا النحو، بل تُسخر كل إنجازات العلماء في كل مكان، لخدمة مشاريعها السياسية وأمنها القومي وحماية مصالحها الاقتصادية، لكنها لن تستطيع الاستمرار باحتكار أسباب التطور، ومنع انتقالها إلى الدول والمجتمعات التي توصف بأنها متخلفة، وما كان هذا التخلف إلا واحدا من نتائج سيطرة الدول المتقدمة تكنولوجيا على مستعمراتها والحرص على سد كل أسباب التطور بوجهها.
إنّ من حق المواطن العربي والمسلم أن يسأل، لماذا تتعرض دول إسلامية كثيرة لحروب أهلية تعصف بأمنها واستقرارها وأمن الدول المجاورة لها؟ ولماذا نرى أن معظم الدول التي تعاني من الجوع هي دول عربية أو إسلامية؟ ولا نلاحظ مثل ذلك في أوربا وأمريكا والشرق الأقصى على سبيل المثال؟ هل يتعلق ذلك بنقص الموارد الطبيعية؟ أو بميلٍ غريزي نحو "الكسل" وعدم استغلال الأرض لإنتاج ما يكفي من الغذاء؟ ولماذا يميل العربي والمسلم لحل مشاكله مع الآخرين بالعنف ولا يركن إلى منطق الحوار؟
هل يتعلق الأمر بالتاريخ أو بالجغرافيا؟ أو أنه يتصل بالبيئة المناخية أو بالبيئة الاجتماعية؟ أو أن الفتوى الدينية لعبت دورها في تقييد قدرات الإنسان على الابداع؟ أو تضافرت كلُها أو بعضها على تحديد طبيعة السلوك الإنساني؟
وأخيرا لماذا يقدّم إنسان هذه البيئة أفضل ما عنده، عندما يهاجر من وطنه ويُقيم في مجتمع أوربي أو أمريكي، فلم يحصل كل هذا؟ أله علاقة بالفتوى الدينية؟ أله كان الجواب على هذا النحو لرأينا الكثيرين من الذين هاجروا، قد اتخذوا موقفا معاديا للدين، لكننا نلاحظ كثيرا من المنتمين لتيارات إسلامية، مثل الإخوان المسلمين فضلوا الإقامة في بلدان أوربية بذريعة أنها تمنحهم حرية الاعتقاد الديني والسياسي، وتتيح لهم فرصة العمل التنظيمي من دون رقابة أمنية.
وهل له علاقة بالقمع السياسي الذي تعيشه معظم دول الشرق الأوسط، بحيث ينعكس الخوف من المجهول، على قدرة الإنسان بالابتكار والإبداع؟
أرى أن حصر الموضوع في سبب واحد ربما هو قمع فكري من أخطر ما يتعرض له الإنسان الباحث عن حرية التعبير عن رأيه ومعتقده وأفكاره بحثا عن التغير السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
بخصوص كل المخترعات التي تدخل ميدان الاستخدام العام، وتنطلق التساؤلات، هل هذا حلال أو حرام، وأحيانا تصدر مثل هذه التساؤلات ليس بهدف تجنب الدخول في الحرام بقدر ما يكون الهدف منها إثارة زوابع يراد منها صرف النظر عن قضايا سياسية ساخنة، أو يراد تمرير مواقف لا يمكن أن تمر في الظروف الطبيعية، وغالبا ما تصدر تلك التساؤلات عن أناس لا يتحرجون من عقد صفقات مالية أو سياسية ولا يسألون أنفسهم أو لا يستفتون عالم دين عن حليّتها أو حرمتها.
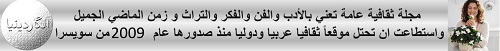
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1017 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
تابعونا على الفيس بوك





















































































