صدّام حسين؛(يا محلى النصر بعون الله)!!
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 05 أيلول/سبتمبر 2024 14:54
- كتب بواسطة: أحمد العبدالله

أحمد العبدالله
صدّام حسين؛(يا محلى النصر بعون الله)!!
لقد كان الذي جرى في سنة 1991, هو جرس تنبيه صاخب جدًا, ولكن تم تجاهله, وصمّ الآذان عن سماعه, وأصيبت بصيرة من بيدهم مقاليد الأمور بالعمى والتبلّد. وكان على الرئيس صدّام حسين أن يعيد النظر بالكثير من سياساته وطريقة إدارة الدولة, بعدما رأى ما وقع من أحداث الشغب والتخريب سنة 1991, وانقلاب فئات كثيرة عليه, كانت تظهر له الولاء المطلق, بالشعارات والعهود والوعود الفارغة, وتبطن له غير ذلك, بمجرد ضعف الدولة وانكسارها. وكما قال شاعر العرب الأكبر معروف الرصافي؛(لا يخدعنّك هتاف القوم بالوطن *** فالقوم في السرّ غير القوم في العلن)!!.
فقد رأى صدّام حسين؛ شيوخ قبائل بايعوه(بالروح والدمّ)!!, ثم نكصوا وصاروا مع الغوغاء, وعسكريّين؛ومن بينهم ضباط برتب عالية, يرتدّون ويخونون بلدهم ويقاتلون مع الإيرانيين, وكانوا لحد أيام قليلة, يهتفون له ويبيعونه كلامًا فقط, وبمجرد اختلال الموازين ظهروا على حقيقتهم, نازعين أسمال(التقيّة)!!. وأعضاء فروع ومكاتب حزبية, بل وأعضاء قيادة قطرية وقومية, يتوارون عن الأنظار, أو يتخاذلون ويرفضون القتال والصولة على المخربين. ثم بعد استقرار الأوضاع, يتم إعادة هؤلاء الجبناء لمواقعهم السابقة, أو تتم ترقيتهم وتكريمهم بالأوسمة والأنواط, وكأنك؛(يا بو زيد ما غزيت)!!.
والغريب جدًا إن صدّام حسين يرى ويلمس كل ذلك وغيره, ويتم تشخيص الأخطاء والخطايا, ولا تحصل محاسبة وإعادة نظر بكل شيء, بل يتم اجترار الأخطاء نفسها!!. وبدلا من إيجاد المعالجات والحلول السياسية الناجعة لمشاكل العراق الداخلية والخارجية, والإقلاع عن الاستعراضات العسكرية, اتّجهوا للتصعيد والتحدي, وإعادة تدوير الأخطاء, مثل إنشاء(جيش القدس), والذي صُرفت عليه موارد مادية وبشرية لو وُجّهت للجيش(الأصلي), لكان أجدى وأنفع بكثير, وهو تكرار لتجربة فاشلة سابقة في حربنا مع إيران؛(الجيش الشعبي وألوية المهمات الخاصة). وكما قال(أينشتاين)؛من الحماقة أن تعتقد أنك ستحصل على نتيجة مختلفة, وأنت تكّرر الشيء نفسه!!.
وأذكر إنه في يوم 6-2-2000, ذهبتُ في مهمة رسمية إلى لواء المشاة الآلي(14)قيادة قوات المدينة المنورة/الحرس الجمهوري, ومقرّه في المسيّب, وفي طريق العودة إلى بغداد ركب معي أحد ضباط مقر اللواء وهو برتبة رائد ركن, لقضاء إجازته الدورية, وكان منقولا منذ فترة قصيرة من أحد التشكيلات المدرعة في قاطع العمارة, فسألته عن أحوال وحدته السابقة في الجيش, فقال:إنها كانت في حالة يُرثى لها, ففي كتيبة الدروع التي كان يخدم فيها, كانت جميع الدبابات عاطلة ولا تعمل, باستثناء دبابة واحدة, والطريف؛ إنه يتم استخدامها أحيانا لجلب الأرزاق من المذخر لعدم توفّر سيارة لنقلها!!. فكيف نتوقع من جيش وصل لهذا الحال المتهرّئ, وجنوده يتسوّلون أجرة المواصلات في مرائب السيارات وعند أبواب المساجد, يتمكن من مواجهة أمريكا؟!.
فقد كان على الرئيس صدّام حسين أن يغيّر من سياساته السابقة التي أثبتت التجربة المرّة فشلها في أول اختبار جدّي, ومغادرة لغة الشعارات غير الواقعية, والانكباب لإصلاح الداخل العراقي بما يكتنفه من أدران وأمراض متراكمة, وأن يعتمد على الرجال المخلصين, وليس على الانتهازيين المتذبذبين. ولكن الذي حصل والمثير للاستغراب, هو التشبّث أكثر بتلك السياسات الفاشلة وشخوصها والإصرار عليها, والتمسك بأن؛(أم المعارك مستمرة)!!. وإن؛(العبور واقع ولو بعد حين)!!.
وبينما كانت البلاد تئنُّ وتتوجّع من تبعات هزيمة(أم المعارك الخالدة), فإن صدّام حسين اعتبرها(انتصار تاريخي)!!, ويحتفل في كل عام بذكراها, ويلقي خطابًا طويلا يختمه بإهزوجته الشهيرة؛(يا محلى النصر بعون الله)!!!. كما أوصى وفده المفاوض في(خيمة صفوان)؛(تعاملوا مع الأمريكان كمنتصرين)!!. وعندما قامت وزارة الثقافة والإعلام بإنتاج فيلم(حفر الباطن)عام 1999, لتوثيق الجريمة الأمريكية بدفن مئات من الجنود العراقيين وهم أحياء داخل مواضعهم الدفاعية بجرافاتها الضخمة في منطقة(حفر الباطن)الحدودية في أواخر شباط 1991, ولأن هذا الفيلم يناقض الخطاب الدعائي للنظام بنصره المزعوم, فقد صدرت(أوامر عليا)بمنع عرضه!!. وربما تم اتلاف نسخه, لأنه الآن مفقود.
وكلما مرّت السنون تضاءلت فرص الخروج من المأزق. بسبب مزيج من الأوهام والتصوّرات غير الواقعية, والتقديرات والقرارات الخاطئة, والسياسات غير الرشيدة, وتقريب المنافقين, ونفي أهل الخبرة والناصحين الصادقين, والعنجهية الفارغة, والجهل السياسي, والمراهنة على الزمن, وفشل في التوقّع والاستشراف. فكان الحصاد بمنتهى المرارة؛ ضياع البلاد, وتشريد وقتل الملايين من أهلها, وتدمير المدن وتسليم مقدّراتنا لأحقر الخلق وحثالة الحثالات.
لقد وصل(نظام صدّام)في سنواته الأخيرة قبل الغزو والاحتلال, لمرحلة الترهّل والتخشّب, وتفشّى في القيادات العليا ومن دونهم في الدولة والحزب؛ الكذب وإعطاء العهود والوعود الفارغة, وعدم نقل الحقائق, والاتكالية. وكانت الدولة كأنها في حالة(موت سريري),وتحتاج لثورة من داخلها للإصلاح والتغيير. وفي ظل التهديدات والضغوط والحصار, وخشية النظام من انفلات الوضع الداخلي بشكل أكبر مما حدث سنة 1991, فلا يمكن تصوّر حصول ذلك. فاتسع الخرق, واستعصى على الراتق. وقادت كل تلك العوامل مجتمعة في النهاية إلى الكارثة الكبرى. والعجب؛من التفكير الساذج للقيادة السياسية العليا للبلاد, وهي تصمّ آذانها بإصرار غريب وتجاهل مريب, وتبقى تقود البلاد بالأساليب القديمة البالية نفسها, والتي ثبت فشلها في 1991, حتى وقعت الكارثة الكبرى في 2003, ولا زالت مستمرة, ولا زلنا ندفع الثمن.. وأيّ ثمن!!.
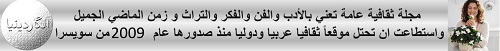
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
مختارات
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1312 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- ماذا نعرف عن "ريتا" التي أحبها محمود درويش، ورحلت عن ٧٩ عاماً؟
- مستقبل الحرب بعد تنصيب المرشد الإيراني المتشدد/ اللواء الملاح الركن المتقاعد فيصل حمادي غضبان
- أضغاث حـروف
- هروب تاريخي للاعبات إيران في أستراليا .. وترامب يطالب باللجوء فورًا!
- لقاء مع عازف الجاز الدنمركي الشهير الراحل جون تشيكاي ١٩٣٦- ٢٠١٢ في الذكرى الرابعة عشرة لرحيله
- من أعلام الكورد الفيليين في المهجر
- حمدان البغدادي و لغتنا العربية الجميلة - معنى أسم رمضان
- الثامن من اذار
تابعونا على الفيس بوك




















































































