عبدالستار ناصر وشيركو بكه س في حكاية الرحيل
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 14 آب/أغسطس 2013 19:26
هاشم شفيق
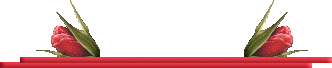
حكاية أولى
لم أنسَ تلك اللحظة، من ضحى أحد الأيام الخريفية في أواسط السبعينات، عندما دخلت القاصة بثينة الناصري الى مقهى البرلمان في شارع الرشيد وقالت لنا نحن الجالسين من الأدباء، سبعينيين وستينيين وحتى خمسينيين، ألم تسمعوا باعتقال عبد الستار ناصر، تحرّكوا، قولوا شيئاً؟... بالطبع الكلّ كان يعرف بالخبر، خبر اعتقال عبد الستار بسبب نشره قصة «سيدنا الخليفة» في مجلة «الموقف الأدبي» السورية التي كان يرأس تحريرها آنذاك القاص زكريا تامر، ولكن من كان يجرؤ على الاحتجاج، لأنّه سيلاقي حتماً المصير ذاته، إن لم يكن أسوأ من ذلك.
مكث عبد الستار ناصر في زنزانة البعث قرابة العام، ولم يخرج إلا بفعل الأصوات العربية التي ارتفعت في لبنان وسورية ومصر، ولعبت حينذاك مجلة «مواقف» دوراً رائداً في إثارة الرأي العام العربي حول مسألة الحريات والقمع المنظّم الذي يواجهه الكاتب والاديب العربي من الدولة التوليتارية في العالم العربي. حمل ذاك العدد من «مواقف» ملفاً عن القاص والروائي العراقي عبد الستار ناصر، وكان في طليعة الكتّاب أدونيس - صاحب المجلة ومؤسسها - فضلاً عن كوكبة من الكتاب العرب الذين رفعوا أصواتهم احتجاجاً وإدانة وشجباً للعمل اللاإنساني الذي يواجهه المبدع العراقي عبد الستار ناصر.
خرج عبد الستار ناصر من السجن منكسراً، لم يتحدث البتة عن حالته وعن وضعه السابق في أقبية مخابرات البعث، بل طوى المسألة كلها، والتفت الى كتابته مستأنفاً حياته الجديدة، مواصلاً نشره وسفره، باحثاً عن آفاق ومنافذ أخرى له خارج العراق.
حين ساءت الظروف السياسية في العراق تماماً وطورد الحزب الشيوعي حتى يصبح خارج البلاد، زار عبد الستار ناصر بيروت، بعد عام تقريباً، بهدف النشر وطلب المتعة والحرية التي باتت تضيق أفقها في العراق. فالتقيته في بيروت، تسكعنا في شارع الحمراء وجلسنا في مقاهيه الكثيرة. كان مسروراً، وضحوكاً، ومبتهجاً، وهو بطبيعته هكذا، فكيف وهو بين أحضان البحر وهواء الجبل؟ بعدها اصطحبته الى الفاكهاني، وجلسنا في مقهى «أم نبيل» و «التوليدو» وعرّفته إلى الجانب المتواضع من حياتنا المتقشفة، فسهر معنا في بيوتنا البسيطة وأعطاني قصتين لأنشرهما له في منشورات الحزب الشيوعي باسم «أبو هيمن». وبالفعل تمكنت من نشر القصتين الجميلتين، واحدة في مجلة «البديل»، التي كان يرأس تحريرها سعدي يوسف، والناطقة باسم «رابطة الكتاب والصحافيين العراقيين»، والثانية في «الثقافة الجديدة»، مجلة الحزب الشيوعي العراقي الشهرية.
كانت تلك المحاولة مغامرة أخرى منه، لكنّه كان يأتمنني، فلم أبح باسم الكاتب مطلقاً، الا بعد أن خرج من العراق قبل التغيير وسقوط النظام بسنوات. خرج متعباً، مهزوزاً، وحزيناً نتيجة انكساراته وخيباته وتعثّره في الأمور السياسية، ونتيجة المرارة التي لحقته جراء مساهماته الكثيرة في كتابة القصص والخواطر وتمجيد الفعل الحربي العراقي تجاه الحرب بين العراق وإيران، بينما كانت الحرب تحصد أرواح الآلاف من الشباب العراقي الذي ترك عمله وجامعته وأهله ليلتحق بحرب كانت من صنيعة الديكتاتور ومن فوقه، وحين كان في الخارج نهائياً أحسّ بفعله هذا وبالوطأة الثقيلة التي كانت ترزح على كتفيه وتجعله انساناً غير سوي، فأعدّ حينها كلمة تشي بحسه الإنساني العميق ككاتب، وأدرك فداحة خطئه، فاعتذر من الشعب العراقي في تلك الكلمة الحزينة.
آخر مرة رأيت فيها عبد الستار ناصر كانت في أربيل قبل ثماني سنوات في «مهرجان المدى الثقافي»، فوجئت حقاً حين رأيته يسحب خطاه بصعوبة، ترافقه في المسير زوجته ورفيقته القاصة هدية حسين. فقلت له: أكبرت الى هذا الحد يا ستّار؟ فابتسم تلك الابتسامة الناعمة وأجاب: فوق تعبي وهمومي صدمتني سيارة، وهذا الخلل الذي أنا فيه حدث لكي يزداد الطين بلّة». واسيته في الأمر، فقلت له: «نحن العراقيين، كلنا متعبون»، حينها استعدنا بعضاً من أيام بغداد وبيروت ودمشق وسفراتنا البهيجة من بيروت الى القاهرة.
كان الراحل عبد الستار ناصر، بطلاً تراجيدياً مثل كلّ أبطال قصصه ورواياته المليئة بحسّ المغامرة والسفر والترحال، كان إنساناً دونكيشوتياً يحارب في كل الاتجاهات ويعيش كل لحظات حياته وما تسكبه عليه هذه الحياة من متع وملذات وأسى وتجارب مريرة، ليكتبها قصة أو رواية، ليروي في الآخر سيرته هو، ذلك البطل الممزق بين الشك والحقيقة.
حكاية الشاعر شيركو بيكه س
التقيت أول مرة الشاعر الكردي الكبير شيركو بي كه س في بغداد، في مطلع السبعينات. أوانذاك، وكانت معظم جلساته في حدائق «اتحاد الأدباء الجميلة» إمّا مع البياتي وحسب الشيخ جعفر، أو مع سعدي يوسف وبعض الشعراء اليساريين. وهو كان معروفاً حينذاك، ويُعدّ من البارزين بعد الشاعر الكردي الذائع عبد الله كوران.
كان يتردد على بغداد مرّة في الشهر، فلا غنى عن بغداد حيث تكثر المكتبات والأنشطة الثقافية والمقاهي الأدبية والحانات الساحرة على شاطئ دجلة. فهو يتقن العربية كتابة وقراءة، وله اصدقاء وقراء، من كلتا القوميتين الكردية والعربية.
حين قامت الثورة الكردية مجدداً ضدّ طغمة البعث، وسقط اتفاق آذار بعد معاهدة الجزائر، كان شيركو أوّل المنحازين الى صفوف الثوار الأكراد «البيشمركه». هو لم يرفع السلاح بالطبع لكنه رفع ما يتقنه، رفع القلم، في مواجهة الظلم والعنصرية وحروب الإبادة التي يتفنن بها الطغاة، فكتب مئات الملاحم والقصائد الطويلة والقصيرة والأغنيات، مستفيداً من تراثه الكردي وأساطيره ومكتنهاً تراث العالم وملاحمه وفولكلوره ليدمجه مع تراث العراق الآشوري والكلداني والسرياني، ليصنع منه مخلوقاته الجمالية وإبداعاته المتميزة في شكل قصائد نادرة وثمينة قلّ مثيلها في الأدب العالمي.
بعد خروجنا من العراق التقيته في مطلع التسعينات، يومها كنت موفداً كصحافي لدى مؤتمر المعارضة الأول الذي عقد في أربيل، كانت الأمور قد استتبت بالنسبة إلى شيركو مع الاستتباب الجديد للحركة الكردية في شمال العراق، فعيّن وزيراً للثقافة في حكومة كردستان المشتركة. ذهبت اليه في مقر الوزارة في أربيل، وأذكر أنّه كان يقف على باب مكتبه حين وفدت الى المكان، أرانيه وقال: «انظر الى هذا المكتب الفاره، فأجبته على الفور: «أنت تستحق هذا المكان بجدارة»، التفت إليّ ضاحكاً وهازاً شاربه الكثيف وقال: «كاكا الشاعر لا يحتاج الى كرسي». بعدها دعاني إلى امسية شعرية أُقيمت في كبرى قاعات أربيل، وقدمني حينها إلى الجمهور الكردي والعربي بكلمة رفيعة، واختتمها بالكرم الكردي المعروف بمأدبة للعشاء.
حين غادرت كردستان عقب انتهاء مهمتي، وبعد شهور قليلة، استقال شيركو من منصبه كوزير للثقافة ليتفرّغ الى شعره. وفي تلك الفترة أنتج أهمّ قصائده «الكرسي» وأهداني إيّاها. كانت القصيدة معبّرة، مغرقة بالرموز الدلائلية والصور الفنية والخيالية، وهي تتحدّث عن الكرسي الذي جاء من الغابة الى محلّ النجار، ومن ثمّ أصبح مقعداً يتحدث يجلس عليه كبار الحكام والطغاة ومن لهم مسؤولية التحكم برقاب البشر.
قصائد شيركو تحمل معاني إنسانية كبيرة وعميقة، يشتبك فيها الملحمي مع الاسطوري مع اليومي، والسيرة اليومية هنا ليست مرتبطة بحياته وإنما بسيرة حياة الإنسان والحيوان والطبيعة والكائنات، وأحياناً يجد لحياته فيها منفذاً، فينفذ الى هنا وهناك، ولكن بصورة هامشية، فالأهمية الأولى في قصائده يوليها للمقاصد الذهبية التي يغترفها من منابع الروح الإنسانية.
شيركو بي كه س شخصية شعرية خالصة، كان يجد حياته في الشعر، أكثر من أي شيء آخر. التقيته مرات كثيرة، بعد لقاء الوزير الشاعر، كان راضياً عن نفسه، مقتنعاً بأنّ الشعر هو الحياة الثانية الحقيقية للشاعر، وخصوصاً لشاعر مثله ومن مستواه، وظلّ على هذه السجية والخصال حتى في لقائي الأخير معه قبل شهرين في السليمانية. وقتها كان التعب واضحاً عليه، لكنه وكأي شاعر محب للحياة، صبر وكابر، فقال: «كل امرىء منا في هذه السن يكون في معيته مرض ما، وإنه لأمر طبيعي»، وتطرق في حديثه معي عن ولعه بالحياة والشعر والجمال، كان يدخن بنهم، ونحن جالسان في مكتبه حيث دار «سردم» للطباعة والنشر. كان المكتب أنيقاً ورحباً ومليئاً بالكتب والأوراق التي تختص بالطباعة وشؤونها. أهداني دواوينه الأخيرة المترجمة الى العربية، وحضني على المجيء مساء الى مطعم «هورمان» البهي، فثمة سمك وعرق بانتظارنا في أروقته الرومانسية.
تُرى هل غاب شيركو حقاً؟ إن قصائده ما زالت تضيء جوانب من حياتنا، انها الاستمرارية الأزلية للإبداع الذي لا يموت.
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
مختارات
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
596 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- نشوء حركة المنشقين ودعاة حقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي / د.جابر أبي جابر
- فيديو - أجود الأصناف من المطبخ التركي على ايدي طباخين مهرة
- صفحات مشرقة من تاريخ العراق الحديث
- برنامج الأمثال البغدادية ( انت تريد وانا اريد والله يفعل مايريد )
- ديوان قَصَائِدُ ومعلقات فِي شَهْرِ رمضان الْمُبَارَكِ {إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الجزء الثاني
- خُبْزُ العباس نذر الفقراء والبسطاء.. في الموروث البغدادي!! واغنية خبز العباس صارت ترند عالمي
- جامع السليمية .. تحفة معمارية جلبت الشهرة لمدينة تركية نائية (صور)
- أردوغان في تصريح خطير.. "المخطط كبير"!
تابعونا على الفيس بوك





















































































