ليرحم الربُّ الصديقةََ دوريس لِيون أغازِرْيان
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 17 شباط/فبراير 2021 17:02
- كتب بواسطة: حسيب شحادة
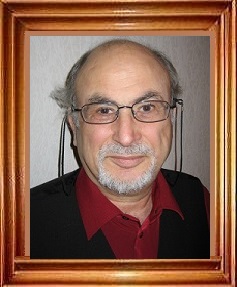
حسيب شحادة
جامعة هلسنكي
ليرحم الربُّ الصديقةََ دوريس لِيون أغازِرْيان
رحلتِ الصديقة الغالية دوريس ليون أغازريان، عن هذه الفانية مبكّرًا، في التاسع عشر من كانون أوّل عام ٢٠٢٠، أي قُبيل عيد الميلاد بحسب التقويم الغربي، ميلاد مخلّص البشر، بأيّام معدودة، وهي لم تلِجِ العقد السادسَ من العمر. ثمّ بعد مدّة قصيرة، وُوري جثمانُها الثرى في مَقبرة بلدة لِمي (Lemi) بالقرب من مدينة لپينرَنْتا (Lappeenranta)، في ظروف استثنائية فرضها وباء الكورونا الذي ما زال متفشيًا في بقاع العالم قاطبة. والدها ليون، انتمى إلى أُسرة أرمنية، نزح آباؤه وأجداده قسرًا من تركيا إلى القدس، في أعقاب محرقة الأرمن التي اندلعت في أواخر نيسان من العام ١٩١٥. يُذكر أنّ بداية الوجود الأرمني في الأراضي المقدّسة، موغلة في القِدم، فهي تعود إلى القرن الثالث للميلاد. أمّا والدة دوريس، مايا فهي فنلندية وتعيش منذ عقود في مدينة لپينرَنْتا. وهكذا، نشأت المرحومة وترعرعت أقلّه في جوّ ثنائي الثقافة والعادات والتقاليد، أرمني شرقي منفتح ناطق بالعربية وغربي فنلندي مختلف منطو.
لا يُضيف المرءُ أيَّ جديد إذا قال بأنّ اللغةَ، أيّة لغة مهما علا شأنها، واتّسع معجمُها وعمُق كالعربية مثلًا، ستظلّ صاغرةً لاهتةً عن وصف دقيق كامل وعميق لفداحة الحسرة والأسى اللذين حلّا، على حين غِرّة، بأهلها وذويها وأصدقائها وزملائها في العمل. في مثل هذه المواقف الحزينة المحزنة، قد يكون اللوْذ أحيانًا إلى الصمت والتأمّل، خيرًا من تدبيج الكلمات والعبارات والأقوال المأثورة الممجوجة في الغالب الأعمّ. ولكن، لا بدّ لنا نحن البشر من كلمات ميّزتنا عن سائر المخلوقات الحيّة غير الناطقة، لنفرغ فيها بعض ما يجيش في أعماقنا من أفكار وأحاسيس.
يعود تاريخ تعرّفي على والدَي المرحومة دوريس، ليون ومايا، وعليها، إلى بضعة عقود من الزمن. آونَتها كنت مقيمًا في القدس، طالبًا في الجامعة العبرية، وآل أغازريان قطنوا في بيت حنينا المجاورة. أذكر جيّدًا، أنّ لقاءَنا الأوّل كان حينما كانت دوريس فتاة يافعة فاتنة، ابنةَ ثلاثة عشر ربيعًا وحضرت مع والديها مراسم زواجي، الإكليل في كنيسة كفرياسيف الجليلية الكاثوليكية الملكية. كما تسنّى لي التعرّف على عمّها الدكتور ألبرت أغازريان في مستهلّ ثمانينات القرن المنصرم، في غضون تدريسي العبرية ومادّة الترجمة في جامعة بير زيت الفلسطينية المعروفة. في تلك الفترة، شغل ألبرت منصب مدير العلاقات العامّة وأستاذ التاريخ، وهو كشقيقه ليون كان متعدّد اللغات (polyglot، ذا ألسنة جمّة) كالعربية والعبرية والإنچليزية والفرنسية والأرمنية والتركية والإسبانية.
كرجت السنون بحلوها ومرّها وبما بينهما، الواحدة تلوَ أُختها، وٱلتقينا منذ ثلاثة عقود ونيّف مُجدّدًا هنا في ابنة البلطيق، في بلاد الشمال. كانت دوريس بعد تخرّجها من مدرسة شميدت الألمانية المقدسية طيّبة الصيت، بالقرب من باب العامود، قد تعلّمت مهنةَ، لا بل رسالة التمريض في مستشفى آوغستا ڤكتوريا في القدس، وعمِلت في هذا المجال ودرّسته في مسقط رأسها، ومن ثَمّ في فنلندا أيضًا. في هلسنكي، عملت دوريس سنواتٍ مديدة سكرتيرة في مكتب المفوضية الفلسطينية. والمهنة الثانية التي ٱكتسبتها بجدارة، ومارستها بمحبّة وإخلاص ونجاح، كانت الترجمة من وإلى الفنلندية والعربية بشقّيها الأساسيين، المحكية والمعيارية. وفي هذا العِلم والفنّ على حدّ سواء، أبْلت المرحومة دوريس المخلصة طيبةُ القلب، بلاءً حسنًا ساطعًا سطوع شمس آب في أوطاننا الحبيبة.
في أكثرَ من مناسبة، كنت شاهدًا على مهارتها، ولباقتها وحذقها في نقلها فحوى ما يقوله المتكلّم من العربية إلى الفنلندية، بأسلوب أفضلَ بكثير من الأصل. فالترجمة، هذه المهنة العريقة والهامّة، ليست مقتصرةً على نقل حرفي أو معنى ما في لغة الأصل إلى لغة الهدف، بمساعدة المعاجم وكتب القواعد، بل اقتناص المقابل المألوف في ثقافة أبناء اللغة المنقول إليها. عند ذلك فقط، لا يشعر القارىء النجيب بأنّه يقرأ نصًّا منقولًا من لغة أُخرى، بل يقرأ نصًّا أصليا. قد يعلم الكثيرون العبارة الإيطالية المسجوعة Traduttore Traditore، أي المترجم خائن أو الترجمان خوان. إذ أنهّ من المعروف عدم وجود مترادفات مائة بالمائة في أيّة لغة بشرية طبيعية. مثل هذه المهارة الفذّة، لا تُكتسب إلا بعد زمن وجهد طويلين من الممارسة، الاستماع، التحدّث والكتابة، والمطالعة الدؤوبة لتذويت ثقافة عامّة ثريّة لا تعرف الحدود. لا أُبالغ إذا قلتُ بأنّ دوريس كانت من القلائل حقًّا، الذين برعوا، بدون أدنى ريْب، في هذا المضمار الحيوي. كما كانت المرحومة دوريس، طالبةً عندي في جامعة هلسنكي، وٱشتركت بنشاط ملحوظ في عدّة مساقات في قواعد العربية، صرفها ونحوها، وَفق الطريقتين العربية والغربية، وحازت على شهادة الماجستير في العربية.
تبادلنا الزياراتِ بحسب الظروف القاهرة في بعض الأحيان هنا، وكان لقاؤنا الأخير بمعيّة مجموعة من الأصدقاء في بيتها بمدينة ڤَنْتا (Vantaa)، قبل رحيلها بسنة. ولكنّ الاتصالات الهاتفية كانت منتظمة مرّة أو أكثر شهريًا، تمشيًا مع الظروف السائدة. وفي الاتصالات هذه الأخيرة، التي كانت تتمّ باللغة العربية المعيارية (MSA) الميسّرة مُتّعنا كثيرًا، أبلغتني دوريس عن نيّتها كتابة سيرة حياتها بالفنلندية وبالعربية، طالبةً منّي تنقيح النصّ العربي، وافقت بالطبع، وشجّعتها لإنجاز هذا المشروع.
سفينة حياة دوريس شهِدت الكثير من الرياح، وفي بعض الأحايين العواصف، التي لا تشتهيها، لا في هذه البلاد الشمالية النائية ولا في مسقط رأسها. الكثيرون من المغتربين، مثل أولائك القاطنين هنا في فنلندا، أكانوا من القُدامى أم من الجُدد، يعيشون بأجسادهم هنا وبأرواحهم وأنفسهم هم في مساقط رؤوسهم. أذكر، أنّ دوريس كانت قد عبّرت لي عن صدمتها، أو قُل خيبة أملها، بُعيْد وصولها فنلندا. كانت تتوقّع بأن تُستقبل على الرحب والسعة، بترحاب وحرارة، أو كما نقول بلغة الأم العربية المحكية ”بُخْدوها بالأحضان“.
أُنوِّه هنا، أنّ دوريس قد تمكنّت من تسطير ستّين صفحة أولى من ذكرياتها باللغة الفنلندية، وآمل أن تُنشر وتُنقل إلى العربية تخليدًا لذكرها الزكيّ. زملاؤها في الترجمة الفورية والتحريرية، قد يبحثون بجديّة موضوع ترجمة بعض النصوص القصيرة من العربية إلى الفنلندية، وأخرى من الفنلندية إلى العربية وإصدارها تكريمًا لدوريس العزيزة، وفي هذا الإطار سأكون مستعدًّا لتنقيح المادّة بالعربية.
من آمن بي ولو مات فَسَيَحْيا، يوحنّا ١١: ٢٥.

الربّ أعطى والربُّ أخذ، فليكن اسم الربّ مباركا.
ذكرى الصديقة الغالية دوريس ليون أغازريان، ستبقى حيّةً تنبُِض في قلوب وعقول ذويها ومحبيّها وأصدقائها!
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1046 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- هل تؤذي مقاطع الفيديو القصيرة عقول الأطفال والشباب؟ .. العلم يجيب
- لقاء بالفيديو - كيف سَلم نواف الزيدان عدي و قصي الى الأمريكان وخان الأمانة!!
- النمسا تمنح عراقياً لقب كبير علماء طب الأطفال
- نزع سلاح الميليشيات في العراق.. إيران تدير معركة النفوذ "بلا مواجهة"
- تقرير أمريكي مخيف .. الفساد والوظائف والنفط يحاصرون مستقبل العراق المالي
- سفير إيران ببغداد: يتم تقديم دعم جوي لرحلات إسرائيلية في أجواء العراق
- كلمات على ضفاف الحدث :( العراق ) من يستلمه ... ولمن ..؟!
- إيران وحصاد العام: انحسار للنفوذ وانقسام داخلي
تابعونا على الفيس بوك

















































































