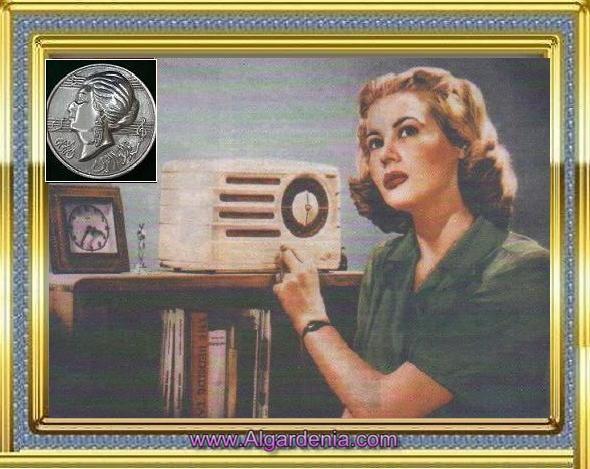الإسلام السياسي في العراق من الهامش إلى السلطة إلى الهامش
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2015 22:39

العرب/ الوليد خالد يحيى:البحث عن الإسلام السياسي في تاريخ العراق المعاصر يحتاج جهدا دقيقا لتلمس إرهاصاته الأولى في بدايات وأواسط نشوء الكيان العراقي الحديث، نظرا لهامشية حضوره تاريخيا، كمشروع ذي رؤية سياسية "دولتية" صريحة تنشد إقامة الحكم الإسلامي وفق "الأحكام الإلهية" التي تسترشد بها القوى الدينية السياسية عموما.
فرغم ظهور قوى إسلامية متنوعة منذ تأسيس الدولة العراقية في العام 1921، إلا أنها لم تستطع تعبئة المجتمع العراقي المتعدد طائفيا وفق رؤاها، ولم تفلح في إنشاء أجسام تنظيمية متينة وفاعلة، في ساحة عجّت بالتنوعات السياسية والحزبية المختلفة، إلا في وقت متأخر من عمر الدولة.
فالوجود الإسلامي في العراق الحديث، لم يتعدّ ميادينه التقليدية، حتى كاد يخرج عن تقليديته مع بعض الجمعيات الدينية، التي تصدت لمهام سياسية، أنيطت بها تلقائيا بعد تأسيس الدولة بقرار من الانتداب البريطاني عقب ثورة 1920، حيث لم يكن هناك سوى الجمعيات الدينية التقليدية، في مجتمع قيد التشكّل وطنيا آنذاك، ويفتقر للوضوح المجتمعي والطبقي بملامحه الحداثية، ونتاجاتها من التعبيرات السياسية والمدنية.
فكانت تلك الجمعيات، بمثابة واجهات للمجتمع الأهلي العراقي، ووُليّت على الشؤون السياسية في الدولة الوليدة، كـ"نقابة أشراف بغداد" التي ضمّت الوجاهات الدينية التقليدية "السنيّة"، حيث عيّن رئيسها عبدالرحمن الكيلاني كأول رئيس وزراء لدولة العراق الملكيّة، في عهد الانتداب البريطاني.
ولم يُعرف عن جمعية أشراف بغداد، ميلها لإقامة حكم وفق الأدبيات الإسلامية التقليدية “خلافة – شورى..إلخ" بل انحكمت إلى أسس الدولة الحديثة، وبدأت تترسخ مجتمعيا مع مجمل التطورات، التي بدأ يشهدها المجتمع على الصعيدين الاقتصادي والتعليمي، ونشوء طبقة وسطى متعلمة في المدن، حملت مشاريع وأفكارا حداثية، نتج عنها حراك سياسي ومجتمعي اتسم بتنوعات ليبرالية وقومية ويسارية، طغت على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.
ولم يخل الأمر من اختراقات إسلامية طفيفة في مطلع أربعينات القرن العشرين عبر جمعية الشباب المسلم "الشيعية" جنوب العراق، والتي نادت بالدولة الإسلامية، وظهور تنظيم تابع للإخوان المسلمين في بداية الخمسينات، قوامه من الطلاب الذين تأثروا بتنظيم الإخوان في مصر أثناء دراستهم في القاهرة.
ولم تلق الرؤى الإسلامية السياسية صدى مجتمعيا يذكر، وبقي وجودها على هوامش طوائفها، بينما بدا المجتمع عموما أكثر ميلا نحو الرؤى السياسية العلمانية والحداثية بمختلف تنوعاتها.
وظل الإسلام السياسي في العراق أسيرا لهامشيته، ولم يحقق أيّ قفزات تطوريّة في المجتمع، في المرحلة التالية من عمر الدولة الذي عُرف بـ”العهد الوطني”، حيث بدأت الحالة السياسية عموما بالتراجع، مع هيمنة العسكر القاسمي على مفاصل الدولة والمجتمع، ولاحقا فترة حكم البعث، التي شهدت أكبر تصفية للمجتمع السياسي والمدني العراقي، لصالح الحزب الواحد، دخل العراق معها حقبة من التصحّر السياسي ترتبت عليها تغييرات جوهرية أعادت الحياة السياسية في البلاد إلى حال مشابه لما قبل الدولة وبدايات تأسيسها.
لعلّ فترة الديكتاتورية البعثية كانت الأكثر ملاءمة، لانتعاش نسبي لبعض الرؤى الإسلامية السياسية "الشيعية"، التي اتخذت أدبياتها طابعا انفعاليا عدميّا وغارقا في الهوياتية الطائفية، إثر ممارسات البعث ضد معارضيه في البيئات الشيعية، والتي فُسرّت بمنحى طائفي، وهو الذي ظهر جليّا في مسلكيات "حزب الدعوة الإسلامية" ذات القوام العنيف، حيث تشكل الحزب على أرضية انتشار أفكار بعض رجال الدين، على رأسهم محمد باقر الصدر في مطلع الستينات، وكان إعدامه عام 1980 على أيدي مخابرات نظام البعث، عاملا حاسما في تمدد وانتشار أفكار الحزب، ذات دعاوى المظلومية الطائفية التي انطلق منها، وانتعشت نسبيا في مدن الجنوب الشيعي بعد إعدام الصدر.
وبدا أثر "الثورة الإسلامية" التي هيمنت على الحكم في إيران واضحا في سياق التبلور الأدبي والتنظيمي للإسلام السياسي الشيعي، حيث أصبحت الجمهورية الإسلامية في إيران الحاضن الأساسي للتنظيمات الشيعية السياسية، التي تكاثرت واكتسبت طابعا عسكريا، مكنها من لعب الدور الأبرز في عراق ما بعد الاحتلال الأميركي عام 2003.
وهنا يمكن القول إن وجود إسلام سياسي منظم في العراق، ليس وجودا تاريخيا راسخا، بقدر ما هو هامشيّ متقوقع، ضمن نطاقات طائفية ضيقة، معتمدا على خطاب غيبي وهوياتي مستمد من فكرة المظلوميات التي ولدتها الدكتاتورية الخالية من المضامين السياسية البرامجية التي من شأنها أن تكون رافعة لأيّ قوة سياسية تسعى إلى الرسوخ المجتمعي، وتحقيق الإجماع الشعبي ومصالح الفئات التي يعبّر عنها، مما أبقاها هامشيّة غير فاعلة في تصدياتها السياسية والوطنية في الداخل العراقي، فضلا عن بعدها عن الساحة الشعبية، ونموها تنظيميا خارج البلاد.
وحلّ العصر الذهبي للطائفية الدينية مع الاحتلال الأميركي للعراق، ونهاية نظام حزب البعث، الذي كشف عن حالة التصحر السياسي العارمة في البلاد، وفقدان المجتمع العراقي الذي يعيش حالة من الانهيار لمعبراته السياسية وقنوات اجتماعه المدني، التي من شأنها صياغة مستقبل دولته المنهارة.
فكانت الأحزاب الإسلامية الشيعية ذات التنظيمات القوية المترعرعة في إيران، والأخرى السنيّة من بقايا حركات الإخوان المسلمين وبعض الهيئات التقليدية التي عاودت الظهور، أول ما ملأ الفراغ السياسي والمجتمعي، ساعدتها في ذلك قوانين التحاصص “الديمقراطي” التي أعادت تشكيل العراق وفق مبدأ التعدد الديني والإثني، الأمر الذي مكّن تلك الأحزاب من إعطاء نفسها طابعا تمثيليا للطوائف والمكونات الدينية، وفتح ذلك على مرحلة جديدة في عمر الإسلام السياسي العراقي، ووجد نفسه على رأس السلطة مسطرا عقدا ونيفا من الفشل في ممارستها.
وبالتمحيص حول طبيعة أحزاب الإسلام السياسي العراقي، وتاريخ نشوئها وأدبياتها، يمكن تلمس أسباب فشلها الذي قاد العراق إلى انحدار شامل على كافة المستويات، الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
فمن الهامشية التاريخية إلى موقع السلطة بفعل الفراغ والخطاب التعبوي الهوياتي، وبإسناد من القوى الإقليمية التي ترعرعت في كنفها، ليكشف عصر سلطتها الراهن، عن طبيعتها الاستعصائية في التصدّي لمهام الإنجاز الوطني، فهي لم تنشأ وفق حاجة شرائح مجتمعية وجدت في الأحزاب الدينية وبرامجها، معبرا طبقيا وسياسيا حاملا لتطلعاتها الاقتصادية والوطنية، إنما تسلّطت بفعل الأمر الواقع المتسم بالانهيار المجتمعي الشامل، مستندة إلى حالة اجتماعية مستحدثة، قوامها طبقة طفيفة من المستفيدين من مميّزات السلطة، ونهب المال العام الذي وصل إلى مستويات قياسية، فضلا عن إسناد القوى الإقليمية لها كعامل حاسم في استمرارها، كإيران بالنسبة إلى القوى الشيعية التي باتت المهيمن شبه الوحيد على مفاصل السلطة في البلاد.
انعكاس نتاجات فشل الإسلام السياسي بعد اثني عشر عاما من السلطة، بدا واضحا في الوعي الشعبي العام، بتعبيره عن ميل كبير للفكاك من حكم الأحزاب الدينية، في التظاهرات الشعبية التي لا تزال تشهدها البلاد منذ سبتمبر الفائت، حيث اختلطت الهموم المعيشية والوطنية بالسياسية، وأنتجت تعبيرات هتف بها الشارع العراقي تربط بشكل عفوي، الفشل الاقتصادي والأمني بالطبيعة الدينية للأحزاب الحاكمة، التي لا تمتلك سوى الخطاب الطائفي والغيبي، لتغطية فشلها وفسادها وتبعيتها.
هذا ما يؤشر على عودة تلك الأحزاب لموضعها التاريخيّ المعتاد، أي على الهامش في ميدان الوعي الشعبي، وتبقى نهايتها رهنا بتطور تمظهرات سياسية ومدنية بديلة، تنقل حالة الاحتجاج والوعي الشعبي الجديد إلى مستويات السعي لافتكاك السلطة من القوى الإسلامية، التي لم يعد لديها سوى الدعم الإقليمي وأدوات القوة العنيفة التي تمكنها من استمرار هيمنتها على المجتمع.
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1127 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- تنويه الى الأخوة والأخوات كتاب وقراء مجلة الگاردينيا المحترمين
- هل تؤذي مقاطع الفيديو القصيرة عقول الأطفال والشباب؟ .. العلم يجيب
- لقاء بالفيديو - كيف سَلم نواف الزيدان عدي و قصي الى الأمريكان وخان الأمانة!!
- النمسا تمنح عراقياً لقب كبير علماء طب الأطفال
- نزع سلاح الميليشيات في العراق.. إيران تدير معركة النفوذ "بلا مواجهة"
- تقرير أمريكي مخيف .. الفساد والوظائف والنفط يحاصرون مستقبل العراق المالي
- سفير إيران ببغداد: يتم تقديم دعم جوي لرحلات إسرائيلية في أجواء العراق
- كلمات على ضفاف الحدث :( العراق ) من يستلمه ... ولمن ..؟!
تابعونا على الفيس بوك