«ديمقراطيةَ» المحاصصة الطائفية، ليست من الديمقراطية الحقيقية في شيء
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 20 شباط/فبراير 2024 07:14
- كتب بواسطة: قاسم محمد داود
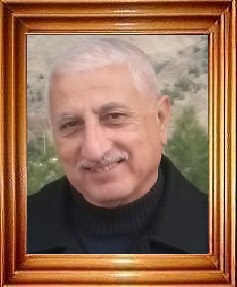
قاسم محمد داود

«ديمقراطيةَ» المحاصصة الطائفية، ليست من الديمقراطية الحقيقية في شيء
لا شك أن الديمقراطية هي من أفضل الحلول التي ابتكرها الإنسان على هذا الكوكب، لكن هذا (الحل) ليعطي ثماره، ويحقق المناط به، يجب أن يكون (الفرد) نفسه له خصائص وقيم وثقافة من شأنها إنجاح التجربة الديمقراطية، وأولى هذه الخصائص أن يكون الأفراد نساء ورجالاً متساوون في الحقوق والواجبات، لا يفرقهم مذهب ولا قبيلة ولا منطقة ولا أصل ولا فصل، وإذا افتقد المجتمع، أي مجتمع هذه الخصائص فإن الحل الديمقراطي سيأتي بأشكال عديدة من المتعصبين للدين والعرق والطائفة.
والمفهوم المتعارف علية في كل دول العالم ذات الأنظمة الديمقراطية، وهو أن ينتخب الشعب ممثلين عنه في مجلس النواب ثم بعدها تتشكل الحكومة وبقية مؤسسات الدولة، أما بدعة الديمقراطية الطائفية والمحاصصة الحزبية فهذه لم يعرفها أحد في العالم ولا يعترف بها بل هي نموذج مقنن لحكم طائفي ثيوقراطي يفرض عاداته وعبادته وشعائره على الآخرين.
أن «ديمقراطيةَ» المحاصصة الطائفية، ليست من الديمقراطية الحقيقية في شيء. بدلاً من أن تكون رمزاً لفاعلية وكفاءة واستقرار مؤسسات الدولة توكيداً لسيادة الشعب، أضحت ديمقراطية المحاصصة الطائفية رمزاً لتكريس ديكتاتورية الطائفة.. واستبداد وصراع المرجعيات الدينية.. وتبعية الدولة للمرجعيات المذهبية الأجنبية. بالتالي تفشي الفساد، في مؤسسات الدولة وبين النخب السياسية.. وتغَوّل المليشيات الطائفية بأيدولوجيتها العنصرية الرجعية المتزمتة، على حساب احتكار الدولة للقوة الجبرية القاهرة، رمز السيادة الأصيل للدولة القومية الحديثة.
الديمقراطية الحقيقية لا تقوم على نظام محاصصة طائفية هش وغير مستقر، ينتج عنه نظام أوتوقراطي مستبد.. فاسد.. عميل لقوى خارجية، يستند إلى قيم ثيوقراطية رجعية عنصرية متزمتة، لا تمثل فئات الشعب المختلفة، في إطار تعددية سياسية حقيقية، تتجاوز الفروق الدينية والمذهبية والعرقية في المجتمع، لا يوجد في الديمقراطية أكثرية عرقية ودينية وطائفية بل يوجد أغلبية سياسية تحكم الجميع بإرادتهم وفق القانون، بمعنى دولة قانون ومؤسسات، وضمن مبادئ الديمقراطية، عدم نكران حق الأقلية، فالأقلية هي جزء من المجتمع تتمتع بالحقوق الدستورية كافة وأهمها حقوق المواطنة التي تلغي مبدأ الأكثرية والأقلية في الحقوق.
وعليه فإن نظام الحكم الذي يكون على أساس الأكثرية الدينية أو المذهبية أو العرقية وتسيد طائفة أو عرقية معينة على ما سواها والاستئثار بالسلطة والثروات القومية سيكون حتماً نظاماً مشوهاً ومسيئاً على المستوى السياسي عندما توزع السلطات بحسب المكونات، مما يعني انتزاع الشعب من المواطنة نحو الانتماء الفرعي والطائفي والقومي والاثني والمذهبي، وبهذا يكون النظام الحاكم قد ارتكب جريمة التقسيم لما هو وطني ومتحد منذ مئات السنين، وأشاعه فكرة الغُلبْ بين المكونات وبالتالي سينتج عنه صراعاً طائفياً وقومياً، ونظاماً هجيناً. لأن فكرة الأغلبية الطائفية هي بلا أدنى شك فكرة (عقائدية) تبنى عليها أفكار عقائدية تفرض وجودها على الجميع بغض النظر عن مدى الإيمان بها أو رأي بقية العقائد الأخرى بها أو حتى من لا يؤمن بها وتكون ملزمة للحكومة والبرلمان، وفكرة الأغلبية الطائفية الدينية غير السياسية يترتب عليها تعسف طائفي في كافة مجالات الدولة من تعينات أو قبول خاص أو زمالات ثم تسحب فكرة الانتماء مقدم على ما سواه من خبرة أو أحقية لأن (مصلحة الدين أو المذهب) مقدمة على ما سواهاَ وفي ظل مثل هذا النظام ينتج:
أولاً الحق المقدس والدين: فالطائفية هي نتيجة وسبب لتسيس الدين، فهنا يصبح كل حزب طائفي ينطلق من مرجعية رجل الدين والزعيم الطائفي، والناخب ليس مواطناً له حرية الاختيار على أساس برامج سياسية وخيارات شخصية، بل هو رعية طائفة، وعليه أن يتبع المرجعية الدينية التي تحدد ما يجب وما لا يجب بفتوى دينية، يصعب عليه مخالفتها لارتباطها بفكرة العقوبة الإلهية والنبذ الاجتماعي والعائلي، ومن الطبيعي جداً ان تنسحب الفكرة الطائفية على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ويتم تأسيس أجهزة أمنية لها (قداستها) وعصمتها الدينية توفر لها غطاء ديني يحول دون محاسبتها أو فرض قوانين وضوابط مدنية. وهذا ما تجنبته المجتمعات الأوربية عندما أبعدت الدين ورجاله عن التدخل في سياسة الدولة، ففي ظلّ نظام ديمقراطي حقيقي، لا معنى سياسي للانتساب إلى أقليات أو أكثريات عرقية أو مذهبية داخل البلد، لأن الكتلة الاجتماعية للمذهب أو القومية ليست تنظيماً سياسياً، والزعماء التقليديون للمذهب أو القومية لم يأخذوا تفويضاً سياسياً من كل الأفراد المنتسبين لهذه القومية أو المذهب.
ثانياً المرجعية الخارجية: نتيجة لإعلاء شأن الطائفة والهوية المذهبية، على المواطنة والحقوق الفردية، يصبح الوطن ذاته في مرتبة ثانية أو ثالثة، وتصبح المرجعية الطائفية التي قد تكون موجودة خارج البلاد، هي المرجع. أو على الأقل تصبح مصالح التنظيمات السياسية والمذهبية "الأم" أو "الشقيقة"، الموجودة في بلاد أخرى، جزءاً رئيسياً من محددات المواقف السياسية للأحزاب المختلفة.
وذا ما أردنا أن نبحث عن العلاقة التي تربط بين الطائفية والسياسة نجد أن الطائفية هي وسيلة تستند إلى الاستراتيجية او القدرة على إقناع الآخرين بهدف الحصول على السلطة والكسب الخاص بالقوة السياسية وهذا عن طريق مناشدة جميع التحيزات والنعرات المذهبية الشعبية وعادة يكون من خلال الخطابات والدعاية الحماسية لاستثارة العواطف الخاصة بالجمهور، بواسطة مجموعة من الطرق والأساليب التي يستخدمها السياسيون لخداع الشعب وإغراءه ظاهرياً للوصول للسلطة وخدمة مصالحهم. وأنّها في الحقيقة هي التعصّب لجماعة سواء كانت تضمّ متديّنين وغير متديّنين أو متديّنين حصريّين من فهمٍ معيّن للدّين.
ومن جملة المغالطات التي تقوم عليها الطائفيّة والنظام الطائفيّ القول إنّ التعدديّة الطائفيّة هي التعددية الديمقراطيّة ومحاولة مطابقة هذه بهذه، لذلك فأن اعتبار التعدديّة الطائفية تعدّدية ديمقراطيّة لا أساسَ له، لأنّ التعدّدية الديمقراطية تعني تَنافسُ أفكارٍ سياسيّةٍ وبرامج بخصوص أفضل سبل تمثيل مصالح الأمّة، أمّا الطائفيّة فهي أبعد ما تكون عن تحديد مصالح الأمّة بل تسعى إلى ضمان مصالحَ ضيّقة للطّائفة وأفرادها وتؤدّي إلى تهميش المصالح والقضايا الوطنيّة والقوميّة.
أنّ تعدّد الهويّات والانتماءات وجعل الانتماء للوطن والأمة في آخر قائمة الانتماءات لا يميّز الحداثة والدولة المدنية، والديمقراطية في حال تحقيقها تأخذ على عاتقها تنظيم العلاقة بين المجتمع والدولة، من خلال قوانين ونظم علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، وهذه العلاقة بين الدولة والمجتمع تصل بالمجتمع في نهاية المطاف إلى أن الصراع السلمي بين الطبقات الاجتماعية هو من يحدد شكل النظام السياسي/ الديمقراطي، من خلال التداول السلمي للسلطة طبعا. ومن المفيد أن نذكّر بفشل النظام السياسي المبني على أساس أن التعددية الطائفية والعرقية والادعاء أنه هو تعددية ديمقراطية، تجربة الحاكم الأميركيّ للعراق بول بريمر الذي كان أخطر ما فعله هو أنّه كرّس الطائفيّة بتقنين تعامل الدولة مع المواطن على أساس كونه شيعيّاً أو سنيّاً أو كردياً، وجعل المواطن يتعامل هو معها على هذا الأساس. على الرغم من أن بلاده التي احتلت العراق بعد غزو عام 2003 تعج بالطوائف الدينية والإثنيات العرقية لكنها لم تنشأ نظامها السياسي على أساس هذا التعدد لأن النخب الحاكمة هناك تعي جيداً بأن الطائفية تلغي مفهوم الأمّة، وبروز التّعابير الطائفية يدلّل أيضًا على أنّ مؤسّسات الدولة الحداثيّة كانت قشريّة وغير ضاربة جذورها في ثقافة المجتمع .كما أن الديمقراطية في الأساس تعنى بإيصال الأكفأ مرحليا للسلطة ثم التعاون معه في تنفيذ خططه وبرامجه التي هي في الأصل واضحة وواقعية لا يشوبها الغموض ولا الرؤى الخيالية المبهمة، ومن ثم مراقبته ومحاسبته على التقصير والتهاون وصولًا لتطبيق آلية عزله الدستورية حال فشله. كيف نلصق بالديمقراطية كارثة إيصال من لا يكترث كثيرا بمبدأ الكفاءات بل بالثقة والانتماء التنظيمي، ولا بوضع السياسات الاقتصادية الملائمة في مختلف المجالات، ولا يملكون حلولا واقعية للمشكلات التي تنخر مجتمعاتهم، بل فقط يسعون إلى الهيمنة العقائدية والكسب المادي؟
الديمقراطية وفق جوهرها وفلسفتها لا تعني التغيير في البنيان السياسي، واستبدال الدولة السلطوية أيًا كانت مرجعيتها بدولة سلطوية أخرى ذات مرجعية دينية مذهبية، بل هي بالموازاة انتقال في النظم الاقتصادية من الإقطاعية والرعوية إلى التجارية والصناعية المعقدة المحكومة بشبكة معرفية واسعة لإدارة العلاقات مع العالم.
الواقع أنه لا ديمقراطية حقيقية قبل أن تحل المسألة الدينية والمذهبية، فالغرب يطبق جوهر الديمقراطية لأن الدين لم يعد يمثل إشكالية وصار الكاثوليكي ينتخب البروتستانتي لكونه الأكفأ. ما دامت المسألة الدينية لم تحل بشكل جذري بمعنى تفكيك انغلاقات الماضي المذهبية وتعميم التأويل المستنير المتسامح للنص الديني وحصر التنافسية السياسية بين من يقدم البرامج السياسية والاقتصادية.
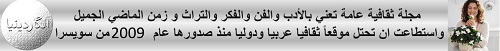
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1023 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- تنويه الى الأخوة والأخوات كتاب وقراء مجلة الگاردينيا المحترمين
- رابطة النخب التربوية والاجتماعية في بغداد، تقيم أمسية احتفاء بالأديب لطيف عبد سالم، وإشهار وتوقيع كتابه (هوادج الحب)
- فيديو - استراحة قصيرة مع لوريل و هاردي /١
- رمضان في أزقة بغداد .. تقليد تبادل الأطباق يتجدد بروح عصرية
- هل وصلت الاستعدادات الامريكية للحرب مرحلة اللاعودة؟ وهل بإمكان إيران اللجوء الى الخيار الشيطاني لتفاديها؟
- برنامج الامثال البغدادية .. الموسم الثالث مثلنا لليوم(الصبر مفتاح الفرج)
- فيديو - سوق الأعظمية في رمضان
- على مائدتك في رمضان .. اعرف أصل حكاية القطايف
تابعونا على الفيس بوك




















































































