ذكريات كلية الاداب في الخمسينيات
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 06 نيسان/أبريل 2017 10:00

ذكريات كلية الاداب في الخمسينيات
بلقيس شرارة:كان أملي قوياً في الحصول على بعثة دراسية، بعد أن حصلت في امتحان البكالوريا على درجات تمنحني الحق بالحصول على بعثة دراسية خارج العراق، و كنت أتوق إلى دراسة الأدب الانكليزي في انكلترا، اذ كانت انكلترا في مخيلتي تجسيداً للحلم الذي كنت أتطلع لتحقيقه، بلد شكسبير و كيتس و شيلي و بايرون و ديكنز و لورنس...
خابت آمالي عندما أوقفت البعثات الدراسية من قبل وزارة المعارف عام 1951. و شعرت عندئذ أن الحلم دائماً بعيد عن الواقع، فهو الأمنية التي تتجول و تدور في الفكر، و تبقى بعيدة المنال! وعدني مدير المعارف أن ينظر بملفي حالما يلغى أمر إيقاف البعثات، و لكن كان أملي ضعيف، خاصة بعد أن قدمت ملفي إلى عدد من الكليات الأدبية التي قبلت في جميعها. و لم يكن هنالك مخرج آخر لي، إذ كان والدي يمر بضائقة مالية منذ أن فصل من وظيفته عام 1949.
قررت الالتحاق بفرع اللغة الإنكليزية في كلية الآداب. كان الفرع مرغوباً من قبل الطلبة، و لم يكن يقبل فيه إلا طلبة ذوي الدرجات العالية. و كان عليّ أن أنجح في المقابلة الشفوية التي تجرى من قبل لجنة القبول.
ذهبت صباح اليوم المعين إلى المقابلة في كلية الآداب الواقعة في باب المعظم. كان الجو ما زال حاراً، وزعت أسماؤنا حسب الحروف الأبجدية، فكان أسمي ثالث أسم، فالتسلسل اعتمد الاسم الأول و ليس أسم العائلة.
كانت اللجنة مكونة من أستاذين، الكاتب جبرا إبراهيم جبرا و الكاتب دزمند ستيوارت. دخلت القاعة، و شعرت بأعصابي متوترة. سألني الأستاذ جبرا عن اسمي، أجبت: بلقيس شرارة، وهي المرة الأولى التي التقي بجبرا. ثم أردف قائلا: لماذا ترغبين في دراسة هذا الفرع؟ أجبت: لأنني مولعة في قراءة الأدب. ثم سألني الأستاذ دزمند: بمن معجبة من الشعراء الإنكليز؟ أجبت: شلي و كيتس. قال لماذا شلي بالذات؟ قلت: لأنه كان ثائراً على تقاليد مجتمعه. و استطرد جبرا و سألني سؤالا أقرب منه إلى أُحجية: كم كان عمر شلي عندما توفي؟ قلت: ثلاثين عاماً. و كيف مات؟ غرقاً. ثم سألني دزمند: و من الذي استعمل جمجمته في شرب النبيذ؟ أجبت: الشاعر بايرون.
شعرتُ براحة نفسية عندما استطعت أن أجيب عن جميع الأسئلة بصورة صحيحة. بعد انتهاء المقابلة، سألني جبرا: ماذا يكون عبد اللطيف شرارة منك؟ أجبته: عمي. قال: اقرأ مقالاته التي تنشر في المجلات و الصحف. توجهت نحو المجاز، و التف حولي الطلبة يسألونني عن الأسئلة التي وجهت لي من قبل اللجنة. بعد بضعة أيام استلمت قبولي في فرع اللغة الإنكليزية.
كان معظم الطلبة في السن الدراسية نفسها، و لكن كان عدد قليل منهم أكبر سناً منا. كان البعض منهم بعيداً عن الأدب و الشعر و المسرح، و لاقى صعوبة في هضم المادة. خاصة و إن خلفية هذا البعض من الطلبة كانت تجارية، فآباءهم تجار في سوق الشورجة بعيدون عن الأجواء الأدبية. و لم ينتهي الفصل الأول حتى بدأ الصف بالتقلص حتى نصف العدد، إضافة إلى أن الطلبة في المدارس العراقية، مفطومين على ثقافة التلقين. فالطفل يبدأ حياته بتلقين القراءة و جدول الضرب، و لم ينته من الدراسة الابتدائية حتى تكون شخصيته قد تكونت، معتمدة على التلقي و التلقين. فمعلم الابتدائية و مدرس الثانوية و أستاذ الجامعة ينهجون نفس الأسلوب في التعليم، و تبعه التلقين الحزبي الذي ساد في مجتمع الحزب الواحد و هيمن على حياة الناس، فلا يبقى أمام الفرد إلا الانسياق في هذا التيار، فهو محاصر من كل جانب، و لغة الحوار و إبداء الرأي بعيدة عن ممارسة العراقي، لأنه ترعرع في أحضان ثقافة التلقين و الأمر، في البيت و الجامع و المدرسة و الدائرة التي يعمل فيها، و بذا أصبح مشلول التفكير.
أصيب بعض الطلبة، بما يشبه الصدمة حين ظهر اختلاف قسم اللغة الانكليزية في كلية الآداب عما اعتادوا عليه من أسلوب التلقين و الحفظ، و اعتماده الحوار و النقد و التحليل و إبداء الرأي و تكوين فكرة مستقلة عن رأي الإستاذ. فواجه الطلبة من هؤلاء صعوبة التماشي في أسلوب التدريس الجديد، مما اضطر بعضهم إلى ترك القسم، و الانتقال إلى كليات أخرى.
* * *
كنت أسير مشياً أحياناً من الكلية إلى دارنا في منطقة الوزيرية، أو أركب الباص، فأعبر الشارع إلى محطة الباص بخط مستقيم، لا ألتفت يميناً أو يساراً، أجلس في المقعد الأمامي القريب من السائق، مرفوعة الرأس، أتطلع إلى الشارع. يصعد طلبة الكلية في نفس الباص المتجه إلى الوزيرية. حين اتأهب للنزول من الباص، ترصدني العيون و تراقبني عن كثب، أقفز بسرعة عندما يقف الباص أمام المحطة القريبة من دارنا، أسير بخطوات واثقة حتى أصل الدار. كنت أشعر لأكثر من مرة بحركة غريبة خلفي، وقع خطوات على مبعدة أمتار مني. مما يحفزني على تسريع الخطى، ثم أعود للسير ببطئ فيخفف وقع الخطوات ورائي. كنت أواصل السير، و أنا أتابع حفر الرصيف، لا ألتفت خلفي، حتى عندما أصل الدار. ظل وقع تلك الخطوات يثير قلقي، أذهب في اليوم التالي إلى الكلية، و تلاحقني كظلي، بصوتها الرتيب على قارعة الرصيف حتى وصولي داري.
حاولت التغلب على هذه الملاحقة، فقامرت بترك الدرس الأخير، لكن باءت محاولتي بالفشل، لأنها تواصلت يوماً بعد يوم، و أسبوعاً بعد أسبوع، أحس بالخطوات تقترب أحياناً، متداخلة مع خطواتي، فأسرع عندئذ، و أحس بغضب في أعماقي من تلك الأشباح التي تلاحقني. يغالبني الشعور أنني مطاردة. و أنا في حيرة من أمري، لا أجد حلاً مناسباً لتلك المشكلة التي أقضت مضجعي! و هو ما يسببه الحرمان الجنسي عند الشباب، و الذهنية الذكورية المهيمنة على المجتمع آنذاك.
لم أفاتح والدي أو والدتي بالموضوع أو أبحثه مع شقيقتي مريم. إلا إنني صممت على تجاهلها! مع شعوري في معظم الأوقات أن حريتي كانت محاصرة. و لكن نجحت بعد عدة أشهر، فتلاشت الخطوات التي كانت تتبعني تدريجياً، حتى اختفت تماماً، لا اسمع إلا خطواتي! أصبحت لي الجرأة أن التفت ورائي، لأطمئن أن ليس هناك من يتبعني، و اختفت الأشباح التي ظلت تتعقبي.
كنت حذرة جداً، لا أختلط إلا بطلبة صفي، نتمشى كطالبات في ساحة الكلية و لا نتحدث مع الطلبة إلا كمجموعة في ساحة أو نادي الكلية. و نادراً ما تتجرأ طالبة و تجلس بصحبة طالب لوحدهما في النادي، خوفاً من الشائعات التي تنهش سمعة الفتاة و تنتشر كالنار في الهشيم، كانت سمعة البنت رقيقة برقة الزجاج الشفاف، و العيون مصوبة نحوها كتيار الضوء الكاشف عتمة المكان.
كنت لا أجلس في نادي الكلية إلا بصحبة رفيقاتي، ذهبت ذات يوم أفتش عنهن في النادي..

كان شعري الأسود منسدل على كتفي، فاشرأبت الأعناق فجأة و تسّمرت عيون الطلبة محدقة بي،ارتبكت و شعرت بتدفق الدم يسري في عروقي، و أحسست بطول الدرج الذي قطعته و كأن عدد درجاته قد تضاعفت. وصلت الصف، كان خالياً من الطلبة، فرفعت شعري بدبوسين، محاولة إعادة ترتيبه كما كنت أمشطه في السابق. كانت هي المرة الأولى و الأخيرة التي أغير فيها موضة شعري. أصبحت تلك الحادثة درساً لي و علمتني ألا أتركه يتدلى ثانية على كتفي. و لكن أصبحت الشرائط التي كنت أربط بها شعري، موضوع حديث و تعليقات من قبل الطلبة و شملت حتى بعض الأساتذة العرب. كنت أتجاهل ما يدور حولي من تعليقات التي اعتادت أذني على سماعها، مثل « اليوم الشريط الأبيض، و اليوم مقطّع، و اليوم ملّون»! مما أشعرني أن حريتي كانت مقيدة.
* * *
كان في الصف طلبة فلسطينون الذين قدموا إلى العراق مع اللاجئين الذين تركوا وطنهم عام 1948. تميزوا بتفوقهم باللغة الإنكليزية، ليس بمعزل عن اعتماد دراستهم في مرحلة الثانوية المنهج الإنكليزي، و شعرت أن عليً اللحاق بهم،
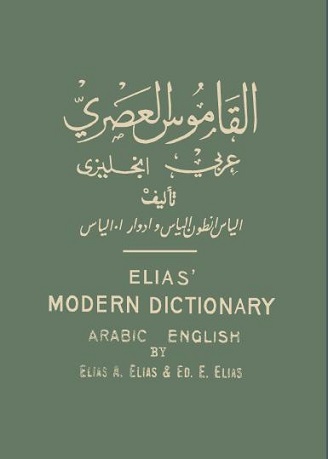
فقضيت الفصل الأول من السنة الدراسية مع «القاموس العصري» وأصبح صديقي الدائم و المرافق لي في البيت، يسهر الليل معي، أقلب أوراقه و أحفظ اصطلاحات و مرادفات جديدة كل يوم. تسلحت قبل انتهاء العام الدراسي بمرادفات كثيرة ساعدتني على فهم ما كان مطلوباً منا دراسته في المسرح و الرواية و الشعر و النقد.
كان معظم الطلبة الفلسطينيين من القوميين العرب. و لم يخلق أواصر صداقة تربطنا بهم باستثناء قلة من أمثال سولافة حجاوي، و بقي معظمهم مجرد معارف، لم يكن ثمة اختلاط بين الطلبة من اليساريين أو الديمقراطيين أو الشيوعيين و بين القوميين و البعثيين. فالانقسام كان إيديولوجياً، فمعظم الطلبة الفلسطينيين يميلون أو ينتمون إلى الأحزاب القومية أو حزب البعث، الذي بدأ يتبلور في كلية الآداب.
بينما كان اتحاد الطلبة، الذي تأسس في شهر نيسان عام 1948، تحت قيادة الشيوعيين و اليساريين،فالطلبة الشيوعيون هم المنظمين الرئيسيين للإضرابات و الاحتجاجات و المشرفين على المظاهرات.
كنتُ محسوبة على اليساريين عندما بدأت الدراسة في كلية الآداب، و لكن لم أنتمي بصورة رسمية إلى اتحاد الطلبة، فلم أحضر الاجتماعات الدورية للاتحاد، لكنني كنت أتبرع مالياً للاتحاد و لا أقوم بجمع التبرعات.
كانت تقام في الكلية نشاطات ثقافية، من بينها اجتماع أسبوعي يعقد كل يوم اثنين في الساعة العاشرة صباحاً. فيجتمع طلبة الكلية و الأساتذة في القاعة الكبيرة المعدة لهذا الغرض. سارت الأمور على طبيعتها في البداية، فلم يتدخل العميد فيما يتعلق في الاجتماع الأسبوعي، حتى ألقى الشاعر مظفر النواب قصيدته الشعبية في فرّاش الكلية «مروكي» فامتلأت القاعة بالطلبة، و لم تكفي مقاعدها للحضور فاضطر جمهور الطلبة الوقوف على جانبيها.
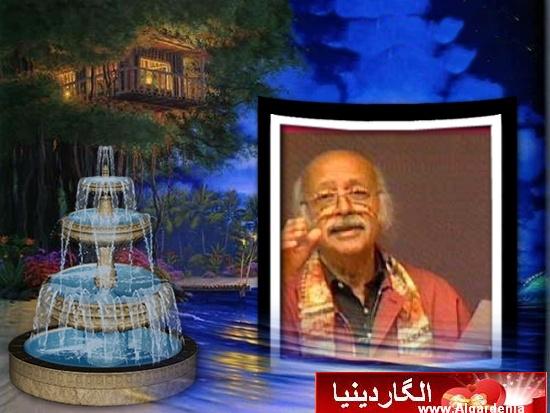
علا التصفيق بحماس لمظفر بعد أن انتهى من إلقاء القصيدة، و كان لها صدى واسعاً بين أوساط الطلبة، و أصبح الفراش «مَروكي» فجأة نجماً من نجوم الكلية. و اشتهر مظفر بشعره الشعبي في الكلية، و جرى تداول قصيدته على أوساط واسعة يحفظها و يرددها عدد من طلبة الكلية.
على أثر ذلك قرر العميد عبد العزيز الدوري بشكل مفاجئ أن يلغي هذه الساعة، مما خلف في نفوس الطلبة إحساساً بعدم استعداد الإدارة تقبل أي نوع من أنواع الانفتاح، بالرغم من إن العميد كان من خريجي جامعة لندن و عاش في جو ليبرالي لبضعة أعوام في إنكلترا، لكنه كما يبدو كان أسير إملاأت من وزير المعارف خليل كنة عليه الإلتزام بها و تطبيقها.
كما كان مظفر النواب من الطلبة الناشطين في جمعية الانطباعيين التي أسسها الرسام حافظ الدروبي في كلية الآداب و العلوم، و بعض الطالبات كن يجلسن كموديل في فترات الفراغ من الدروس. و قد ألّح عليً الرسام حافظ الدروبي مرات عديدة أن أنتمي للجمعية، و حجتي بالامتناع تمثلت بضيق الوقت و كثرة المواد التي علينا تحضيرها.

أما الأستاذ جبرا إبراهيم جبرا، فكان من المشرفين على جمعية الموسيقى الكلاسيكية بالإضافة إلى التدريس. جذبت لجنة الموسيقى العديد من الطلبة و الأساتذة المولعين بسماع الموسيقى الغربية. كنا نجتمع مساء نهاية الأسبوع، في قاعة الكلية بعد انتهاء الدوام، يقف جبرا على المنصة فتشرئب الأعناق و يسود الصمت، ليبدأ بشرح أهمية القطعة الموسيقية أو الأوبرا التي سنستمع إليها. كان له الفضل في تثقيف عدد من الطلبة في حبهم و ولعهم و ميلهم لتذوق الموسيقى "الكلاسيكية" الغربية. و كنت من بين الطلبة المواظبين على حضور هذه الجمعية.

كانت أول قطعة موسيقية سمعناها أوبرا أثلوOtello للموسيقار الإيطالي فرديVerdi و هي المرة الأولى التي استمع فيها الى أوبرا، وجدت صعوبة في استيعابها في بادئ الأمر، بالرغم من إنني كنت أستمع كثيراً إلى الموسيقى الغربية و لكن لم أشارك في الاستماع غنائيات الموسيقى الغربية. و لعب جبرا دوراً فعالاً في ذلك، فقد فتح أمامي آفاقاً جديدة كنت أجهلها، و لذا اتخذت من سماع الموسيقى الجنائزية/requim كجسر أتكئ عليه لكي أفهم الأوبرا. كان جبرا أستاذ الشعر الرومنطيقي و الترجمة في كلية الآداب.
كنا مخيرين بين موضوعين، الفلسفة أو اللغة الفرنسية، و اختار معظم الطلبة درس اللغة الفرنسية حباً بالمدرسة الفرنسية التي كانت فتاة شابة، نحيفة القد و القوام.

جميلة الوجه، ذات عينين واسعتين داكنة الزرقة، تطوقها أهداب طويلة سوداء، و شفتين رقيقتين قرمزيتين، و شعر أسود قصير. كانت تبذل قصارى جهدها في تلقيننا اللغة الفرنسية تلقيناً صحيحاً. كانت لغة جديدة علينا، تختلف تماماً عن الإنكليزية التي اعتدنا على تلفظها في المدارس الابتدائية. تميزت بجديتها في التدريس، تنتقل من طالب إلى آخر للتأكيد على صحة لفظ الكلمة بالإعادة و التكرار مرات عديدة، حريصة على آلا تترك الطالب أو الطالبة حتى تتأكد من اللفظ الصحيح. فتعيد الكلمات و الجمل كآلة تسجيل حية. يتحايل بعض الطلبة في إعادة اللفظ بصورة غير صحيحة، بالرغم من الجهد الذي كانت تبذله معهم، تعود ثانية لتنحني على الطالب عن قرب، حيث لا تبقى إلا مسافة قصيرة تفصل بينهما! كان الطلبة من الشباب يتلذذون بهذه الحيلة، وهم يحدقون بعينيها الواسعتين، الداكنة الزرقة، و شفتيها الرقيقتين، المصبوغتين بالحمرة. كنت أحس بما تحس به من التعب، تبلع ريقها أحياناً، من الإعادة و التكرار، اشعر بنوع من التعدي على هذه المرأة الأوربية، في مجتمع محروم من الجنس! و لكن بالرغم من هذا الحرمان الذي كانوا يعانون منه، فقد كانوا مؤدبين بتصرفهم وسلوكهم تجاه زميلاتهم في الكلية.
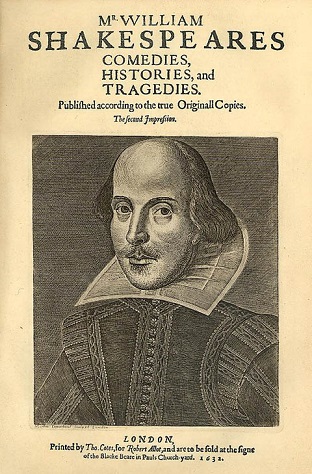
أما الأستاذ دزمند ستيوارتDesmond Stewart فكان على عاتقه تدريس مسرحيات شكسبير، و كانت مسرحية يوليوس قيصرJulius Caesar إحدى المسرحيات في منهج الدراسة. كان معجباً بشخصية يوليوس قيصر، فعّلمنا القراءة الصحيحة للمسرحية. و كان يدمج في كثير من الأحيان ساعتين من دون فاصل، و نحصل بذلك على الفاصل بين الدرسين في نهاية الحصتين. كان يجلس بيننا، يوجه لنا أسئلة سياسية، مستقصياً أراء الطلبة، و يسمح لنا أن نوجه له الأسئلة عن القضايا الآنية في السياسية.
كان دزمند ستيوارت من المعجبين بهتلر كقائد، و حدثنا عن دور موزلي رئيس الحزب الفاشي في إنكلترا أثناء الحرب العالمية الثانية. لم نكن نعرف ما خلفه هتلر من مآسي في تلك الحرب. و لم تكن الأضواء مسلطة على المحرقة التي ذهب في أوارها ملايين من اليهود و الشيوعيين و الغجر و المقاومين للاحتلال من قبل أبناء و بنات البلدان التي سقطت تحت عبء الاحتلال النازي.كنت في موقفي حيادية بالنسبة لهتلر، لم أكن معه أو ضده خلال سنوات الطفولة، فقد كان والدي ضد الإنكليز خلال الحرب في البداية، و لكنه لم يؤيد المفاهيم النازية أو يتبناها بل كان ضدها.
عن كتاب (هكذا مرت الايام) الصادر عن دار المدى
الصورة الأولى من اليمين :من مدونة الأستاذ الدكتور ابراهيم العلاف -الاستاذ عبد العزيز سليمان نوار يتوسط طلبته في كلية تربية جامعة بغداد 1965
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1045 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- نجوى فؤاد تكشف: كنت الصندوق الأسود للعندليب ولم يتزوج سعاد حسني
- اب ستين او (ابستين)
- فيديو - تكاليف شهر رمضان ٢٠٢٦ في لبنان / طرابلس
- عباس جميل و أغنية / أبو عيون الوسيعة
- "الصينية".. لعبة تجمع كبار وشباب أربيل في ليالي رمضان
- لمحبي الظواهر الفلكية.. أنتم على موعد مع "القمر الدموي" بـ٣ مارس
- مسلسل_عمر - الحلقة السابعة
- فرد حچاية - مالا تعرفه عن مطاعم بغداد القديمة
تابعونا على الفيس بوك




















































































