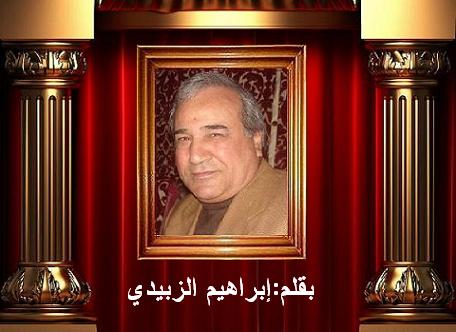الكبير أبو علي .. الشاعر والصحفي العجيب حسين مردان
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 21 آب/أغسطس 2014 18:40

الكبير أبو علي..صفحات من كتاب (دولة الإذاعة)

لم تبدأ صداقتي الحميمة مع الشاعر والصحفي العجيب حسين مردان، إلا بعد أن ودع الفقر والجوع وحياة الصعلكة التي لازمته طويلاً جداً حتى بلغ الخمسين. لذلك فإن ما سمعته منه ومن غيره عن تلك الأيام الخالية ورد ذكره في العديد من شهادات وأحاديث أدباء وروائيين وصحفيين كثيرين غيري. من أهمهم غائب طعمة فرمان الذي جعل حسين مردان أحد الأصوات الخمسة في روايته الشهيرة (خمسة أصوات).
ميزة أبو علي، حسين مردان، ليست أنه شاعر عملاق بين العمالقة، ولا أنه صحفي متفرد، ولا أنه كاتب مدهش. فكل ما حاوله كان عادياً ومن الدرجة الثالثة وربما الرابعة بين رفاق جيله الشعراء والكتاب والصحفيين.
ورغم أنه ابن جيل السياب ونازك الملائكة والبياتي وبلند الحيدري وغائب طعمة فرمان من الأدباء، وسجاد الغازي وصادق الأزدي وعبد النعم الجادر وغازي العياش من الصحفيين، إلا أن كل هؤلاء كانوا يدهشون من إصراره على التفرد والتميز حتى فرض نفسه علماً من أعلام الحياة الثقافية في العراق وعموداً مهما من أعمدة ليالي الثقافة والفن والصحافة في شارعَيّ الرشيد والمتنبي....

وخصوصاً في مقاهي (البرازيلية) و(حسن عجمي) و(البرلمان) و(الزهاوي) ، ثم في اتحاد الأدباء، ونادي نقابة الصحفيين بعد ذلك.
كان أبو علي مهملاً جداً في شعره. فلم يعتنِ بأدواته الفنية أبدا. فظل يكتب شعره بمضامينه الجديدة المبتكرة بأدوات فنية بسيطة متواضعة. ولولا حرارة موضوعاته، وخاصة الجنسية والوجودية، لما ذكره أحد من المؤرخين. ولعل إحالته على المحاكم أكثر من مرة بتهم (الابتذال الخلقي والتمرد المجوني) كانت النعمة الكبيرة التي رزقته ذلك الحضور البيَن على الساحة الثقافية العراقية. قرأت شعره كثيرا. وكنت مجبراً على قراءته في أغلب الأحيان، لأن أبو علي يستمتع بسماعه بصوتي. لذلك فأنا حين أقول كلمتي عنه كشاعر لا أكون ظلمته ولا ظلمت شعره. كان يعد نفسه واحداً من الرواد، ويطالبنا أن نعامله كما نعاملهم، بالتمام والكمال. كان قليلاً ما يقرأ. وإذا ما قرأ فلا يجهز على ما يقرأ. يمله بسرعة. لكنه يصغي إلى من يقرأ، ويلتقط منه الكثير، فيختزنه ويصنع منه زاده في الثقافة.
كنت ذات صباح أجلس في الشمس الشتائية المنعشة في مقهى بقرب جسر الأحرار من ناحية الكرخ. فإذا بأبو علي يطل بوجهه الممتلئ المستدير ونظرته التي كانت دائماً تبحث عن شيء مفقود. سلم علي وقال:
مررت على الديار ديار سلمى
أقبل ذا الجـدار وذا الجـدارا
وما حب الديـــــار شغفن قلبي
ولكن حب من سكن الديــارا
وقبل أن أدعوه إلى الجلوس نطق (مواطن) فضولي كان يجلس بالقرب مني، فقال: "يبدو أن الأستاذ يحفظ شعراً كثيراً، هل هو شاعر؟". لقد اُستفز أبو علي. إلا أن غروره واعتزازه بنفسه منعاه من أن يتولى بنفسه تقديم نفسه إليه وتبيان أنه في حضرة حسين مردان الشاعر الكبير. فسحب كتاباً كان يتأبطه وفتح صفحة الغلاف الداخلي وقربها من السائل ليتيح له قراءة إهداء مؤلف الكتاب. وبدأ (المواطن) يقرأ ببطء شديد:
"إلى الشاعر الكبير الأستاذ حسين"، ثم توقف عند كلمة (مردان) لأنها لم تكن مكتوبة بوضوح، فتهجا وتهجا، وأمعن النظر، ثم نطقها أخيراً:
"حسين فروان".
فما كان من أبو علي إلا أن استشاط غضباً وسحب الكتاب منه بعصبية وقال له: "كل خــ...". ولولا تدخلي وتدخل آخرين لنال أبو علي الكثير من ضرب الأيدي والأرجل.
كان أبو علي، قصير القامة، الممتلئ، ذو الخدين الممتلئين والكرش الهابط والصلعة اللامعة، مزيجاً من أشخاص عديدين. فهو الشاعر الرقيق والغاضب العنيف. الصحفي المغامر والمتخوف في آن. السياسي الثائر والمواطن المستسلم لقدره والزاهد في غده. الصديق الودود والرفيق الذي لا ينجو من لسانه السليط وشتائمه الساخنة صديق أو عدو. الطفل الوديع عاشق الطفولة، والرجل الذي لا يعرف البراءة في حديثه ولا في أحلامه. العاشق الذي يبالغ في عشقه للمرأة إلى حد العبودية، والشتّام الأزلي الذي يرى أن أية امرأة لا تخلو من نزوع فطري إلى الفاحشة والرذيلة. كل هؤلاء يشكلون حسين مردان بأعجوبة. كانت نظريته الوجودية تقوم على أساس عبثية كل شيء. لكنه لم يكن عبثياً بالمعنى الدقيق. حين كنا نناقش أهمية شعره، وكنت أنصحه بالاعتناء بالقصيدة قبل إطلاقها نحو قرائها، كان يرد علي ساخراً: "حين أموت لن أسمع رأي الآخرين بي وبشعري، فما قيمة كل شيء؟".
كان بديناً جداً، وعاشقاً للطعام لا يتوقف عن الغزل بأصنافه المتنوعة العديدة أبداً. وكان يشعر بآلام هنا وهناك، لكنه لم يكن يقتنع بزيارة أي طبيب، لأنه لا يريد أن يعرف ما فيه من علل. وكان يقول لي: "حين تأتي الساعة فمرحباً بها دون أدوية ولا خوف". وحين أجبرناه على مراجعة الأطباء لسوء حالته الصحية أجرى تحليلاً لدمه فاكتشف أنه يعاني من مرض السكري، ومنعه الطبيب من الحلويات. فراح يقف وراء زجاج محلات الحلويات ويطيل الوقوف متأملاً حبات (البقلاوة) و(الزلابية) بعشق فريد.
ومنعه الطبيب من الخمرة، لكنه سمح له بكأس واحدة من أي مشروب، فاشترى قدحاً عملاقاً يستوعب نصف قنينة من البيرة. وحين يُسأل كان يرد بأن الطبيب سمح له بكأس، لكنه لم يحدد له حجمها.
معاً إلى بيروت عام 1971
وصلنا ظهراً من بغداد، وتوجهنا على الفور إلى مصيف عاليه، ونزلنا في فندق أنيق صغير يطل على وادٍ مزهرٍ ساحرٍ جميل.
وفي أول ساعات مساء يوم الوصول هبطنا إلى الشارع الذي أسكرته الأضواء والموسيقى وروائح الشواء.
وبين مئات الصور والإعلانات الملونة عن حفلات السهر العديدة في عاليه لمح أبو علي صورة المغنية العراقية هيفاء حسين، وهي مغنية من الدرجة العاشرة،
عرفت بأغنية وحيدة في العراق تقول فيها: (رسالة للولف مني لودّيها)، واختفت فجأة من ملاهي بغداد لنجدها هنا في هذا المَربَع الصغير في هذا المصيف الساحر في لبنان. انفرجت أسـارير أبو علي كثيرا، وفرح، وأطلق عليها اسم (هفو) تدليلا، ليوحي لي أنه يعرفها معرفة حميمة. قال لي: اسمع، الليلة سأجعلك تقضي أجمل سهرات عمرك.ففرحت وانتظرت.
تناولنا عشاءنا الممتع الشهي في مطعم جانبي، وعاودنا التمشي بين الجموع الفرحة التي تجمعت من كل أوطان العروبة (الظافرة). إلى أن حان وقت السهر، فقصدنا الملهى إياه، واتخذنا طاولة قريبة من زاوية خصصت للموسيقيين والمطربين. ورأينا (هفو) بينهم. لم يُبدِ أبو علي أي حماس في النهوض والذهاب للسلام عليها وتدبير السهرة الموعودة. فاغتنمت أنا فرصة غيابه في حمامات الملهى فتوجهت إليها وسلمت عليها. فرحت بي كثيراً جداً كعراقي ومن (جماعة) الإذاعة بالذات، وأصرت على استضافتي. أردت أن أفاجئها بصديقها القديم، فسألتها إن كانت شاهدت صديقها أبو علي معي أم لا؟ فوجئت بسؤالي وقالت: أبو علي؟ لا أعرفه، هل هي يعرفني من بغداد؟ فذكرت لها اسم الشاعر الكبير الأستاذ حسين مردان. فاعتذرت بخجل وقالت: لا أعرفه مع الأسف، ولم أسمع باسمه من قبل.
هنا عاد أبو علي من الحمام دون أن ألمحه، وحين وجدني جالساً مع (هفو) أضاحكها غضب مني وخرج. بعدها لم نفتح الموضوع. لا هو سأل ولا أنا نطقت. ومرت السحابة العابرة!
حـذاء لمعــان
في الليلة التالية توجهنا إلى منزل شاعر العرب الفريد نزار قباني وزوجته العراقية، الناعسة، الراضية، الباسمة، الحنون، بلقيس الراوي التي سقطت ضحية العروبة المسلحة بالديناميت في تفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1981 والتي قال نزار عنها:
بلقيس كانت أجمل الملكات في تاريخ بابل
بلقيس كانت أطول النخلات في أرض العراق
كانت إذا تمشي ترافقها طواويس وتتبعها أيائل
بلقيس يا وجعي ويا وجع القصيدة حين تلمسها الأنامل
هل يا ترى من بعد ثغرك سوف ترتفع السنابل؟
أين السموأل والمهلهل والغطاريف الأوائل؟
فقبائل أكلت قبائل
وعناكب قتلت عناكب
قسما بعينيك اللتين إليهما تأوي الكواكب
سأقول، يا قمري، عن العرب العجائب
فهل البطولة كذبة عربيةٌ؟ أم مثلنا التاريخ كاذب؟
بلقيس لا تتغيبي عني فإن الشمس بعدك لا تضيء على السواحل
سأقول في التحقيق: إن اللص أصبح يرتدي ثوب المقاتل
وأقول في التحقيق: إن القائد الموهوب أصبح كالمقاول
أترى ظلمتك إذ نقلتك ذات يوم من ضفاف الأعظمية؟
كان بين نزار وأبو علي، كما بدا لي، ود عميق وحب دافئ مقيم. فإذا سلط لسانه عليه بالشتائم العراقية المقذعة كان نزار لا يضحك فقط، بل يتوهج من السرور بتلك الشتائم الثقيلة. لم يدر حديث على طول تلك السهرة النادرة عن الشعر ولا عن الأدب ولا عن الثقافة. بل كانت الأحاديث كلها تدور حول بلقيس وطبخها ومقالب نزار فيها، وعن دجلة وشارع أبو نواس وسمكه المسقوف والأعظمية وليالي بغداد. وقبل أن نغادر طلب أبو علي من بلقيس أن ترافقنا صباح اليوم التالي إلى السوق ليشتري وفق خبرتها حذاء للعزيزة لمعان. طبعا أنا الوحيد العارف بشطارة أبو علي في الإيحاء للآخرين أن التي يتحدث عنها هي حبيبته وربما عشيقته. فيتكلف الوقار في الحديث عنها والاحترام الزائد لذكرها وعدم سماحه لأحد، كائناً من كان، أن يسأل من هي، أو ما اسمها الكامل أو عملها أو أي شيء آخر من شؤونها. وحين تدخّل نزار معترضا، قائلا له: ألا تستحيي أيها الجبان من أن تواعد زوجتي من ورائي؟ رد عليه أبو علي:
اخرس، إنها ابنتنا وقد سطوت عليها بالخديعة. ثم يقسم له على أنه لا يستحق ظفرها. فيغرق نزار في الضحك.
المشكلة أن حذاء لمعان كان الطلب الأعجوبة الذي لا يسهل العثور عليه. نصف مغلق من الأمام، وارتفاعه كذا وعرضه من الوسط كذا، ولونه وشكله،مجموعة شروط يصعب توفيرها. زرنا أغلب معارض أحذية النساء في بيروت. من ساحة المرجة وحتى شارع الحمرا دون جدوى.
كانت بيروت تقطر رطوبة في ذلك اليوم التموزي اللاهب، وبلقيس الخجول تقطر عرقاً وهي تدخل محلاً وتخرج من محل بحثاً عن حذاء لمعان. وكلما رجوته أن يكف عن تعذيب تلك الإنسانة الرقيقة كان ينتفض غضباً، وينذرني بأفدح عقاب إذا فتحت فمي مرة ثانية. وبعد نهار طويل متعب عدنا إلى منزل نزار دون حذاء، وأبو علي صامت حزين. وعلى العشاء أخبرت نزار بحكاية الحذاء، ووصفت له عرق بلقيس، وعددت له الدكاكين التي ابتُليت ببحثنا عن الحذاء السحري العجيب. فكأنني منحت نزار ثروة لا تعادلها ثروة. لقد استغلها إلى آخر ما فيها من سخرية بصديقه أبو علي، الذي راح يستنجد ببلقيس، التي كانت تضحك بعمق، لتنقذه من فحش نزار قباني. وبعد عودتنا إلي بغداد تمكنت من اكتشاف أن لمعان هي تلك السيدة الأنيقة دائما، وصديقة ثلاثة أربـاع مثقفي العراق. تعطف على (مرضاهم) و(مجانينهم) بأمومة عالية، ومنهم، بل في طليعتهم، شاعرنا الحبيب حسين مردان.
طفولة متـأخرة
من شدة عشقه للطفولة، كان أبو علي لا يتمالك نفسه ولا يمنع دمعه حين يصادف طفلاً يبكي. حتى إنني كنت أحسب في كثير من الأحيان أنه يبالغ ويفتعل.
ذات ظهيرة ساخنة، كنا نشق زحام ساحة البرج بصعوبة، وكنت أسير خلفه وكانت صلعته اللامعة تحت شمس تموز هي دليلي إليه وسط الزحام. وفجأة ظهرت من بين الجموع الزاحفة سيدة لبنانية غير مترفة، تحمل طفلاً على كتفها الأيمن، وعلى ذراعها الأيسر علقت (شنطة) من القماش، وخلفها يمشي طفل آخر لا يتعدى الخامسة من عمره يكاد ينفجر من البكاء الجارح، وهي منشغلة عن بكائه بالتسوق.
بدأ أبو علي يغلي كالمرجل ويوشك أن ينفجر، وراح يسب تلك الأم وينعتها بالحيوانة والغبية. لكنني استطعت أن أنزع فتيل ثورته، وأن أهون عليه المسألة متذرعاً بأن للأطفال أحياناً مطالب يعجز الكون كله عن تلبيتها. لكنه فجأة غافلني وقفز أمامي راكضاً نحو الأم فأمسك بذراعها الذي تعلق عليه (شنطتها) صارخاً بلهجة عراقية صافية: (لج أنت زمالة؟ متكَولين هذا الحيوان ليش يبجي؟). وترجمتها إلى العربيــة: (هل أنت حمارة؟ ألا تسألين لماذا يبكي هذا الحيوان؟). فوجئت السيدة التي لم تفهم ماذا قال. لكنني تمكنت من انتزاع ذراعها من يده، وسحبت صديقي بصمت لنغوص من جديد في الزحام.
حب من دون كلام
تعرّف أبو علي إلى فتاة تركية من سكنة أسطنبول كان قد التقاها في إحدى رحلاته السياحية إلى خارج العراق. ويبدو أنها منحته ما لم تستطع غيرها أن تمنحه، فأحبها كما يحب الناس زوجاتهم وأمهاتهم. ولكن المفارقة تكمن في أن أبو علي لا يعرف شيئاً من اللغة التركية ولا الإنجليزية، ولا هي تملك شيئاً من اللغة العربية ولا الإنجليزية كذلك. فبأية لغة كانا يتهاتفان ويتغازلان؟ لا أدري.
ولأن حال أبو علي لم تكن ميسورة، فقد كان يحرص كل شتاء على توفير أقصى ما يستطيع توفيره لرحلة الصيف التركية الساحرة. وقد استمر على ذلك سنين عديدة.
وهنا علي أن أذكر هذه الحكاية:
أخذ أبو علي من أخته ابنها الصغير، وكان في الرابعة من عمره، وتعهد برعايته من شدة حبه المرضي للطفولة. وعاش الولد مع خاله حسين وجدته أم حسين. وذات صيف وكان أبو علي متعجلاً يدفعه الشوق إلى أسطنبول، حدث ما لم في يكن في الحسبان. وهنا أترك أبو علي يتحدث:
"ركبت الحافلة: بغداد - دمشق - حلب - أنقرة - أسطنبول . وحين وصلت، علمت أن مرض الكوليرا قد تفشى في بغداد. فقلت إن أمي (تلك الحمارة) قد لا تعرف أن عليها تلقيح الولد ضد الكوليرا. فعدت: أسطنبول - أنقرة - حلب - دمشق - بغداد، فوجدتها قد لقحته، فعدت: بغداد - دمشق - حلب - أنقرة - أسطنبول!".
مأزق.. ولكن
في أواسط الستينيات تعرفت في الكويت إلى شاعر اسمه عبد الله الطائي. جمعتني به سهرات متعددة مع رفاق تلك الأيام الكويتية الزاهرة. فقد كانت الكويت واحة مضيئة وارفة يؤمها الشعراء والأدباء والفنانون من كل حدب وصوب. ولم يخبرني أحد من الأصدقاء الكويتيين، الشاعر علي السبتي وخالد سعود الزيد وسليمان الشطي ومحمد الفايز، أن عبد الله الطائي غير كويتي. وذات صباح من عام 1969 أخبرني المدير العام للإذاعة والتلفزيون أن شخصاً اسمه عبد الله الطائي سيزور الإذاعة بعد ساعة ويقول إنه صديقي ويريد أن يراني. ولم يذكر الصحاف تفاصيل أخرى. كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قد وصل إلى بغداد قبل ذلك بيوم في زيارة رسمية للعراق، فظننت أن عبد الله الطائي جاء كصحفي لتغطية الزيارة. وحين وصلت مبنى الإذاعة في الصالحية وجدت استعدادات استقبالية واضحة، كانت لا تتخذ إلا حين يزورنا رئيس أو وزير أو وفد زائر مهم. وتوقعت أن يكون لزيارة الشيخ زايد ضلع في ذلك. إلا أنني حين دخلت على الصحاف فوجئت أن الزائر الكبير هو (وزير إعلام أبو ظبي) صديقي القديم عبد الله الطائي. بعدها بقينا على تواصل إلى أن ترك أبو ظبي وعين وزيراً للإعلام في سلطنة عمان. يومها علمت أنه مواطن عماني. ثم تسلم بعد فترة منصب وزير خارجية عمان.
وذات مساء من صيف عام 1970، وكنا أبو علي وأنا في عاليه في بيروت، قابلت صديقي القديم عبد الله الطائي. وقف أبو علي صامتاً متأملا حرارة اللقاء. سألت عبد الله عن أحواله فقال: لقد استقلت.
قلت: ولماذا؟
قال: عينوني مندوب عمان الدائم في الأمم المتحدة، فاستقلت.
عدت فسألته: ولماذا؟
فرد متضايقا: وماذا أفعل في المنفى؟
ودون أن يعرف أبو علي من هو هذا الصديق بادره على الفور: ينقلونك من مسقط إلى نيويورك وتقول منفى؟ أتسمح لي أن أقول لك إنك سخيف؟ فانتفض عبد الله. لكنني عاجلته قائلا: أعرفك على صديقي الشاعر حسين مردان. فصرخ عبد الله ضاحكا: أهذا هو أنت؟ لقد سمعت بسلاطة لسانك قبل أن أراك. وصافحه بحرارة وساد بينهما الانسجام من أول ذلك اللقاء، وسهرنا تلك الليلة حتى ساعات الصباح الأولى.

لا تصلح للإذاعة
قرر الصحاف المدير العام للإذاعة والتلفزيون تعييني رئيساً لقسم الموسيقى والغناء، لإحراجي والتخلص مني كان يعرف أنني لست موسيقياً ولا مطرباً ولا ملحناً. لكن الصراع الدائم بين شلل العاملين في الوسط الغنائي، والتنافس الدامي بين جماعة الغناء الحديث وغناء الريف والمقام العراقي، أو بعبارة أصح بين الغنائَين البغدادي والجنوبي كانا على أشدهما. فبرر الصحاف قراره بأنه أراد أن يأتي بمن لا ينتمي إلى كل تلك الشلل، ويملك رؤية إذاعية عملية وطنية عامة يستطيع بها أن يستقطب الجميع ويعدل بينهم ويحرك جميع الفرق وجميع الأوزان.
أول إجراء أقدمتُ عليه هو تشكيل لجنة عليا لفحص نصوص الأغاني برئاسة الشاعر حسين مردان (أبو علي) وعضوية الشاعر حميد الخاقاني والإذاعي عبد اللطيف السعدون. ولجنة أخرى لفحص المواهب الجديدة، الموسيقية والغنائية، برئاسة أحمد الخليل وعضوية عباس جميل ويحيى حمدي ومحمد عبد المحسن وناظم نعيم وعبد الكريم بدر والحاج هاشم الرجب. ومن اليوم الأول أحلنا إلى لجنة النصوص ملفاً ضخماً من نصوص غنائية، بعضها باللهجة البغدادية، وبعضها الآخر بالريفية، والثالث بالريفية (المفصحة)، والرابع بالفصحى. وكان الجميع ينتظر عودة (الملف) ليبدأ العمل على الفور. لكن أبو علي رئيس اللجنة أعاد ذلك الملف دون أن يجيز أي شيء. بل كتب على غلاف الملف عبارة بالحبر الأحمر: (لا يصلح للإذاعة). حملت الملف وذهبت إليه طالباً إعادة النظر وإعادة صياغة بعض النصوص وإصلاح ما هو قابل للإصلاح، وذلك لسبب واحد، هو أن الملحنين لا يستطيعون التلحين، والمطربين لا يغنون، والموسيقيين لا يعملون دون نصوص مجازة من اللجنة. ضحك الشاعر حسين مردان وقال:
"إن عليك أن تبلغ الشرطة بحدوث سرقة في الإذاعة. فهؤلاء الذين كتبوا مثل هذه النصوص (التافهة) يحاولون تخديرنا ليسرقوا أموال الإذاعة. فكيف يكتب أحدهم عن الغربة وهو ينام بين أحضان زوجته أو عشيقته؟ وكيف يبكي وهو يسكر في ماخور؟ وكيف يكذب على ربه ونفسه ويدعي الحب وهو يقطر كراهية للحياة والحب والجمال؟".
بعد أن استمعت إليه قلت بإصرار: إن عليك أن تتصرف وتجيز لنا من كل هذا الملف النصوص الأقل فسادا والأقل تفاهة لكي تدور العجلة ولا تتوقف.
وبعد ساعة أعاد إلي الملف مع ثلاثة نصوص أعاد صياغتها فأجازها، وثلاث قصائد مختارة من شعر نزار قباني ونازك الملائكة والعباس بن الأحنف، مرفقة بطلب إعفائه من رئاسة لجنة فحص النصوص!
بعد التفكير.. فاصوليا
كان أبو علي معتاداً على تناول وجبة غداء مرتين في الأسبوع في مطعم تاجران الشهير في شارع الرشيد. وكان معتاداً أيضا على تناول صحنه المفضل (فاصوليا مع الرز، وصحن سلطة وكوب من اللبن) لا يغيره إلا نادرا.
ذهب ذات ظهيرة إلى مطعمه الأثير وجلس وهو شارد الذهن. جاءه النادل وسأله عما يحب أن يأمر به ذلك اليوم، فطلب منه أبو علي أن يمهله قليلا ليفكر. فصاح النادل بصوته لتوصيل الطلب إلى المطبخ بطريقة منغمة طريفة: يابا ديفكر (أي إنه يفكر).
وغاب عنه فترة وعاد ليسأله عما استقر عليه تفكيره، فأجابه أبو علي: ما زلت أفكر. فصاح النادل بالنغمة نفسها: يابا بعده ديفكر (أي إنه ما يزال يفكر). وحين عاد إليه في المرة الثالثة قال له أبو علي: يابسة وتمن (أي فاصوليا يابسة ورز)، فصاح النادل: يابا بعد التفكير، يابسة وتمن!
مـات أبو علي
أعادته الذبحة الصدرية التي أصابته فجأة إلى حب الحياة والتمسك بها. مكثت عنده في المستشفى حتى ساعة متأخرة من الليل. كان يؤكد لي أن صحته كاملة، وأن ما أصابه عارض عابر، وأنه اكتشف أن كل مشاكله الحياتية والصحية هي بسببنا، نحن أصدقاءه. فنحن سبب عصبيته وانفعالاته الدائمة. وبعد أن كان مضرباً عن الزواج عاد وآمن به، وقرر أن يتزوج وأن يهجرنا جميعا، ويسكن في أقاصي مدينة بغداد، لئلا يرى وجوهنا السود. ووعدني أن لا أراه غاضباً أبداً. ودعته وكان يحب أن أبقى أكثر، فسخرت منه وقلت: لن تستطيع أن تتبدل أبداً. فتحداني وقال: سوف نرى. وفور وصولي إلى داري فوجئت بمن يتصل بي ويخبرني بوفاته.
وفي اليوم التالي ذهبنا، محمد المبارك وأنا، لنستلم جثته. رحنا نبحث عنه في الصناديق العديدة في ثلاجة المستشفى. إلا أنني عرفته من قدميه، فصرخت: ها هو أبو علي. ولهذا الأمر حكاية.
حين ذهبنا إلى لبنان، تشاركنا في غرفة واحدة بسريرين. لم يكن ينام قبل أن أقرأ عليه بعضاً من شعره بصوتي. كنت أنام ورأسي تحت الشباك ورجلاي باتجاه الباب، أما هو فينام وقدماه تحت الشباك ورأسه على الطرف المعاكس، ليشبع من هواء جبل لبنان – كما كان يقول -. لذلك كنت أرى قدميه أكثر من وجهه، وكرهت منظرهما المخيف، وكنت أسخر منهما وأقول له: "أي شاعر هذا الذي له قدمان كهاتين القدمين؟".
كانت تعجبه مني تلك السخرية، فيضحك.. ويضحك إلى أن تدمع عيناه.
حضرت تغسيله. ورأيت ذراعه اليابسة وهي تطوى لتوضع على صدره. ورأيت عينيه تُغمضان وقد غادرهما البريق. وضعوه في صندوق من الخشب، وأخذناه إلى مبنى اتحاد الأدباء العراقيين، وكانت تلك وصيته. ذهب الجميع وبقينا وحدنا ظهيرةً كاملة، أبو علي وأنا. وقبل المساء بقليل وضعناه على ظهر سيارة (بيكاب): الصحاف ومحمد مبارك وحميد الخاقاني وأحمد خلف وأنا، وأخذناه إلى النجف. كنت كأنني في رحلة. لم أكن في حال مَن فقد إلى الابد واحداً من أهله أو من أعز أحبائه. كنت أضحك وأحدث رفاقي عن طرائفه فيضحكون. أودعناه مدفناً خاصاً في النجف، وركبنا السيارة نفسها عائدين إلى بغداد.
ونحن في طريق العودة أدركت الحقيقةً، نعم لقد فقدته. حزنت بصمت وعمق. ولا أدري من أين هبط علي ذلك الطوفان من البكاء ولا كيف. بكيت كثيراً، بكيت بحرقة لم أعرفها في حياتي كلها. لقد غاب أبو علي بحق.
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1308 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- صورة الفارس والفروسية على النقود العربية آنذاك
- الشخصية النرجسية لدى بعض طلبة الكليات
- أهو الرئيس الأميركي أم أنه النظام الأميركي؟
- الحياة ونحن ومصائرنا!
- حين أهمل السور سياسيًا تجاوزه عتاة الدواعش
- كلمات على ضفاف الحدث : القضية الكردية معقدة أم جذور التخلف قوية ..؟!
- نظام جزار عار على جبين الانسانية
- ساعة "يوم القيامة" الرمزية تقترب .. هذا ما قاله علماء ذرة!
تابعونا على الفيس بوك