التعدد العرقي والديني نعمة وليس نقمة
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 15:48
- كتب بواسطة: قاسم محمد داود
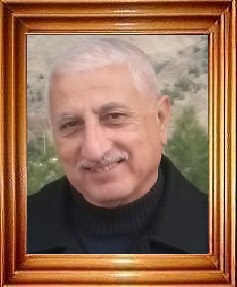
قاسم محمد داود
التعدد العرقي والديني نعمة وليس نقمة
تتعدد الأعراق بين الناس وتختلف بينهم الأديان والأفكار وغيرها من الأمور. الإشكالية لا تكمن في وجوه هذا الاختلاف، إنما في القدرة على تقبله والتعايش معه. والسؤال هو، هل الاختلاف نعمة أم نقمة؟ مع ظهور أفكار الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير في النصف الثاني من القرن العشرين أصبح من الصعب إنكار حق أي مكون من مكونات المجتمع العرقية أو الدينية لاسيما وأن عدد من القوميات التي فرض عليها الانضواء تحت دول دون أرادتها تبعاً لمصالح الدول التي ربحت الحرب العالمية الأولى عندما رسمت الحدود الدولية دون أن تأخذ في اعتبارها الدين والبنية العرقية للسكان وقضايا هياكل القوى المحلية وتم تحديد الانقسامات الأثنية اما لخطوط اقتصادية كالتقسيم على اساس تقاسم الثروات وارتباطات الأسواق المحلية والتقسيم الحضاري للعمل وأما وفقاً لخطوط سياسية مما دفع هذه الدول المستقلة الى التعايش القسري التي جمعت الأثنيات بشكل مصطنع داخل الدولة الواحدة التي أقامها المستعمر لحرصه على إقامة الفتن. وهذه ليست مشكلة عربية او شرق أوسطية فقط، فالظهور السياسي للجماعات العرقية والدينية ظاهرة عالمية إذ أن هذه الجماعات في جميع دول العالم النامي أصبحت أكثر تصريحاً ومطالبة بحقوقها وتسعى للاعتراف بوجودها المستقل ولغتها وعرقيتها وثقافتها وحقوقها التعليمية. لكن القيادات المتسلطة تخشى من ضعف قوة الدولة إذا ما اعترفت بهذه الحقوق. وحتى الغرب ليس حصيناً من هذه الحركات، ففي بريطانيا على سبيل المثال نجد إن الوليزيين والأسكتلنديين حصلوا على حكم ذاتي ولديهم برلماناتهم الخاصة ومع ذلك هناك منهم من يطالب بدولة مستقلة، والكاتالونيين في إسبانيا يطالبون بالاستقلال عن إسبانيا وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية في الدول الغربية.
وفي الوطن العربي يشكل موضوع العرقيات غير العربية مأزقاً مزعجاً للحكومات العربية، ويمثل مصدر قلق وتوتر في معظم دول الوطن العربي على امتداده من المحيط الى الخليج في حين ان التنوع القومي والعرقي والديني يعتبر ثروة بشرية وثقافية في العديد من دول العالم. وهو موضوع أستغلَ من قبل الحكومات الغربية لابتزاز هذه الدول تحت غطاء الدفاع عن حقوق الأنسان من مفهومها الاستعماري لهذه الحقوق ومن دافع مصالحها السياسية والاقتصادية كذلك استخدم عامل ضغط سياسي وتدخل خارجي في شؤون الحكم من قبل بعض الدول المجاورة عن طريق الدعم العسكري والسياسي للحركات المسلحة التي تقوم بها بعض هذه الجماعات لتحقيق اهدافها. ولكن هذا لا يعني أن ننكر أن المشكلة في الوطن العربي هو تفشي الطائفية والقبلية والعشائرية سواء على مستوى أنظمة الحكم أو توزيع القوة والنفوذ داخل المجتمع فالدول العربية بشكلها الحالي الذي شكلته دول التحالف المنتصر في الحرب العالمية الأولى دول لم ترى النور إلا حديثاً حافظت على شكلها الفسيفسائي ولم ينصهر الجميع في بوتقة واحدة ويتشكل مجتمع المواطنة. ومن الطبيعي ان يشعر شركاء الوطن الأقل عدداً بحاجة إلى حماية أنفسهم وتأمين مصادر قوتهم الخاصة. ومن الطبيعي أن تبدأ أطراف المجتمع المحرومة في التفتيش عن حلول لمشاكلها. مع التطور العالمي وانتهاء عصر الاستعمار المباشر للدول أصبحت مسألة التعامل مع التعدد العرقي والثقافي علامة على التحضر، فالدول المتحضرة التي تضم اعراق وثقافات متعددة تبحث عن عوامل التوافق وتعمل على تنميتها وتحويلها إلى طاقات إيجابية فاعلة إضافية على العكس من الدول المتخلفة التي تحكمها عقد الماضي وأحقاده وتعتمد العنصرية والقبلية والطائفية منهجاً تسير عليه لإدارة البلاد فتبرز فيها مواطن الشقاق والاختلاف التي تجد دائماً من يغذيها ويثيرها بدلاً من نشر قيم التسامح واحترام الآخر وقبوله أي عدم تكريس وصيانة حقوق الأنسان في المجتمع حتى وأن كانت تدعي الديمقراطية، فالشعوب التي تعاني الجهل والتخلف واحتقار المختلف الآخر لا يمكن ان تجد النعيم في الديمقراطية ما لم ترتقي هذه الشعوب بنفسها وتؤمن بحقوق الإنسان وتستنكر بأعلى صوت جرائم التطهير العرقي ضد قومية أو دين أو طائفة أو مذهب أو جنس ويتوقف الحكام ووسائل اعلامهم عن إيجاد المبررات لكل جريمة يقوم بها متعصب. وبما أن الوطن العربي موطن الحضارات القديمة وقلب العالمين المسيحي والإسلامي فمن الطبيعي ان يكون موطن قوميات واديان مختلفة، فعلى مدى هذه المساحة الشاسعة عاشت مجتمعات منذ مئات السنين، مكونة من عرقيات مختلفة، من عرب وكرد وامازيغ، ودينية، من مسلمين ومسيحيين في وئام وشكلت مكونات رئيسة لنسيج اجتماعي بدا منسجماً. وإذا كان الاختلاف بين الجماعات الحية على الأرض طبيعياً فمن الطبيعي إذاً ان يكون الاعتراف بحق اختلاف البشر طبيعياً ايضاً ومن هنا اقرت الدساتير والقوانين في الدول المتحضرة بهذا الحق وإذا ما طبق على أرض الواقع صار التعايش في المجتمعات المتعددة الثقافات والأطياف ممكناً لابل سبباً للرقي والتقدم والتحضر بالتفاعل بين الجماعات البشرية وتبادل خبراتها بدلاً من الاختلاف والتناحر، والحضارات الإنسانية ما هي إلا ثمرة التعايش والتلاقح الفكري الذي أسهمت فيه الجماعات والشعوب والأقوام على مر تاريخ هذا التعايش فيما بينها. ويقاس مدى التطور والرقي الإنساني وتطور الأمم بقدر ما يتحقق من نجاح إدارة الاختلاف بين الأقوام والشعوب، فالصراع بين الأقوام المختلفة هو موروث عصور بائدة من التاريخ البشري. والاعتراف بأن التعدد العرقي والديني والثقافي يمثل حالة اثراء وليس حالة تضاد وصراع وهو عامل قوة يدفع البلد نحو التقدم ولكن عند أتاحه الفرص الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكافة العرقيات على قدم المساواة. كما ان تعميق الروابط الثقافية والتاريخية المشتركة بين مكونات البلد يساعد على خلق روح المواطنة والعيش بسلام مع الآخرين، ولا ننسى ان العمل على صياغة دستور توافقي يكفل لعرقيات المجتمع وأطيافه المختلفة التعايش السلمي دون تمييز بين فئة وأخرى، والعمل عل ضمان الحقوق والحريات الأساسية لكافة أطياف المجتمع بما فيها الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق عدالة اجتماعية لكافة مكونات المجتمع على قدم المساواة دون أخلال بحقوق ومصالح أي جماعة عرقية او دينية صغيرة. ان إيجاد الرؤى التنموية التوافقية يساعد على طمأنة جميع فئات المجتمع على صحة المسار. وبالإضافة الى ما تقدم فأن التأكيد على الأهداف غير الاقتصادية التي يحققها التعليم في حياة الفرد وفي حياة المجتمعات كالأهداف القومية والإنسانية معاً فأن التعليم أصبح عملية استثمار اقتصادي في الموارد البشرية وهذا مجال هام من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1220 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- اليوم الدولي للأخوة الإنسانية
- بعد ٦٠ عاماً .. من هو كاتب الأغنية العراقية الشهيرة "الهدل"؟
- كي لا ننسى جرائم أحفاد القرامطة (٧)
- أبناء القذافي .. أين هم؟
- سياسيون وزعماء وأنبياء
- ترامب الصفقة المربحة تحت ظل فرض السلام بالقوة
- كلمات على ضفاف الحدث : في مواجهة غطرسة ترامب : هل أوروبا : بحاجة الى (نهضة حديثة )
- مفاوضات واشنطن وطهران.. ٤ مطالب لن يتراجع عنها ترامب
تابعونا على الفيس بوك




















































































