تيه الجنوب - صفحات القسم الثاني من ثنائية حفل رئاسي / ج١
- التفاصيل
- المجموعة: ثقافة وأدب
- تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 16 تشرين1/أكتوير 2023 10:48

تيه الجنوب - صفحات القسم الثاني من ثنائية حفل رئاسي/ج١
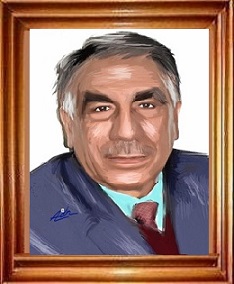
تأليف الدكتور سعد العبيدي

رغبة مكبوتة
أوقفني أحدهم عند مفرق الصليخ سائلاً عن جسر الصرافية، صوته في أذني كان مبعثراً كنقيق ضفدع جائع، ومخدوشاً بتأتأة طالما أثارت قرفي وملأت صدري بالحقد الأسود. وقبل التدقيق في وجهه الأسمر العابس، شعرت غل العالم موجود في هذا الصوت، الذي أعرفه، لذاك المدعو عبد الله الذي نجوت من ضربة عصاه في أحد نوبات التدجين بسجن أبو غريب احتفالاً بمرور سنة على نطق الحكم بحقنا نحن مجموعة رفاق غضب الرئيس على وجودنا السياسي قريباً منه. كان منظره مخيفاً، كأنه لم ينم سنتين متتاليتين، وكان الخوف هو الخميرة التي يريدها الرئيس كافية لتحويلنا من سجناء سياسيين الى حيوانات مدجنة.
سألت نفسي لِمَ تغيّر شكله واقترب من حال الشيطان. وعندما لم أجد جواباً، تركته ومخلب الذعر ينهشني مسرّعاً الخطى ركضاً باتجاه الوزيرية، مثل أرنب يتبعه كلب صيد أجرب. لم يساعدني جسم أحمله مترهلاً على الاستمرار بالركض أكثر من عشرين خطوة، بعد زيادة فاضحة للوزن لما يقارب العشرين كيلوغراماً، وترهلٍ مضطرد للعضلات خلال السنتين الأخيرتين. اضطررت بسببهما وشدة الخوف من عبد الله الى الجلوس على حافة الرصيف الذي حفرت فيه عربات خيول غزت شوارع بغداد إبان حروبها جيوباً ملأتها النفايات، ومع هذا وبعد استعادة ما تسرب من خزين طاقتي واصلت السير قلقاً، معاوداً التدقيق في جهاتي الأربع.
كأن البيت الذي تعودت زيارته مرتين في الأسبوع في أقل تقدير، قد تغيرت هيأته، بات سياجه الطيني منخوراً بفعل المطر، بَنت فيه الدبابير الحمر ممالكها. شبابيكه الحديدية تغيرت هي الأخرى الى خشب، أنشأت فيها حشرة الارضة ممرات لها بشكل واضح. لون طلاء جدرانه أسود حزين، كأنه مسكن أشباح. حيرني حاله وعواء كلاب تكاثرت في الشارع المجاور، تفتش عما يسد رمقها من جوع نافذ، تسببت فيه خسارة معركة قيل عنها الأخيرة في الحرب، وامرأة عجوز تقف على سطحه، مثل ساحرة تمتطي عصا في نهايتها قش.
هممت بالعودة من حيث أتيت، أدرت وجهي ساعياً للهروب مغلوباً على أمري، فجاء صوت هاني من جهة الباب المخلوع نصفها الأيمن:
- الى أين أنت ذاهب وجئت قاصداً لأمر مهم؟.
كان وكأنه ينتظر قدومي، وإن لم أبلغه القدوم.
سألته عما أخرجهُ من هذا البيت المسكون في لحظة حرج أهمُ فيها قاصداً الرجوع؟.
أجاب بهدوء غير مسبوق:
كنت أنتظرك، وكان الوقت المتوقع لوصولك قبل ساعة من الآن. قلت:
- لقد أخرني الخوف المنبوذ.
سأل بامتعاض:
- لم أصبحت هكذا خوافاً في سنيك الأخيرة؟. قلت:
- ألا تعلم أني أخاف السير في الأماكن المكتظة بالناس، ومن خيالي عندما أسير في الشارع أثناء النهار؟. هل نسيت من يتبعني طوال التنقل، يترصدني جليس فراش أفلج بين الصحو والغفوة، فيزيد عمداً مخاوفي التي شكلت سلوكي، لتجنب بني البشر منذ الأيام الأولى لدخولي سجن أبو غريب بدعوى الاشتراك بمؤامرة غير موجودة في الأصل، وأستمر مرصوصاً بناءه في داخلي الى هذه اللحظة التي أقف بها أمامك، خائفاً منك ومن عواء الكلاب، ومن تلك الساحرة الشمطاء في أعلى السطح؟.
توقفت قليلاً عن الكلام، كمن يحاول ترتيب أوراق له تبعثرت في لجة ريح وسألت:
- هل تتكاثر في بيتك الكلاب؟.
نعم أعرف كل شيء، وأعرف القصد من مقدمك، وأعرف بتكاثر الكلاب قال هاني، وأخرج من جيب سترته العسكرية مفاتيح سيارته السوبر. وأشر بيده اليمنى:
- خذها، سوف لن أفصح عما أعرف. إنها حديثة تفي بالغرض، لقد استلمتها من الدولة قبل أيام إثر حصولي على نوط الشجاعة العاشر في معركة لم أشترك فيها.
- سأذهب بها حيث عائلتي المتواجدة هناك منذ أسبوع.
- اذهب الى أي مكان تريد، افعل ما شئت لن اسألك عن الجهة، والأسباب فإني عارف بكل شيء.
خيم الوجوم على هيأتي بشكل واضح، فزاد من اصفرار وجهي العابس، وضاعف من شدة ارتجاف الساقين. اتكأت على كتفه الأيمن قبل الصعود خلف مقود السيارة، وعندما مرر أطراف اصابعه على كتفي، اهتزت عضلات جسمي ارتجافاً مثل أوتار عود يعزف صاحبه بنشاز.
لم أودعه.
لم أشكره على الموقف والمفاتيح.
لم أسأله ثانية عن تكاثر الكلاب.
ولم أعرف السبب.
…………….
قيادة السيارة في صيف حار بمكيف ياباني مسألة جداً مريحة. استجابة محركها وصوته الناشط نقلني الى عالم الشباب. فاندفعت للضغط على دواسة الوقود، كي أشعر أكثر بنشوة الشباب. عزمت تجريب سرعتها القصوى في الشارع القريب، وعلى جسر الصرافية المشهور، رمقني شرطي المرور بابتسامة ثناء على ما أقوم به من تجريب. كان من محبي السرعة ومن أنصار إقامة سباقاتها في شوارع بغداد التي تملأها عربات تجرها حمير بحوافر مثقوبة. بغداد التي يلفها مغيب فيه بصيص من نور معتم، يتعالى في أجواء كرخها أذان المغرب، وقد اختتمه مؤذن الجامع الكبير تواً، في الوقت الذي لم يبدأ في رصافتها العامرة بعد.
مسلمو بغداد، غالبية ساكنيها من أبناء الصوبين يعيشون فرقاً في التوقيت الاسلامي للأذان يقترب من العشر دقائق. هكذا هو الحال فروق في الوقت، وشكل الوقوف في الصلاة، وطريقة الدعاء منذ مئات السنين. الأجيال الحالية تثني على أجدادها لما أورثوه لهم من خلافات في التوقيت وأشياء أخرى، ويثنون في جلساتهم، وحواراتهم على هذا الزاد في مد الانتقام بجرع تطيل أمده الى يوم الدين.
في هذا الزمن العابر بين التوقيتين، راحت عينيَّ الغائرتين الى مرآة السيارة فوق الزجاج الأمامي من الداخل، دون سيطرة من عقلي المشغول بنشوة الشباب، ساعية الى تدقيق سير المركبات من بعدي، وعندما لم تجد إحداها قريبة، أشعرتني بقليل من الجرأة، فأخرجت عند وصول الجرأة الى الدرجة الأعلى، مسدس كان قد أهداني إياه رئيس الجمهورية، قبل فقدان شجاعتي بسنوات. وضعته الى جانبي بحركة لم أتعودها حتى في سنيّ المراهقة، كمن يريد اكتمال شخصيته القلقة بمسدس يرمز الى القوة، وكأن هذا المسدس قد ملأ الفراغ الذي كان قد شكل جيوباً للخوف في خصائص شخصيتي المكتسبة، وشجعني للتجوال في مدينة المنصور التي اعتدت قضاء بعض الوقت في شوارعها تسكعاً أيام العزوبية، بشخصية لا تعوزها الجرأة.
قلت بصوت مسموع وكأني أخاطب أحداً يجلس بجانبي سأتوقف عند هذه المقهى التي يتنقل عاملها المصري مبتسماً بين موائدها الموجودة على الرصيف بحلة جديدة تقليداً لمقاهي بيروت، عساي تذكر الماضي... الحلو من الماضي ليس غير.
سألني قبل كل شيء عن موعد عودته الى النيل، الذي يخشى نسيان مياهه العذبة، والعشاق الجالسين على حافاته وبائع الكشري، وقد أغلقت الحرب كل السبل الممكنة للعودة، وسأل أيضاً عن التحويلات بالدولار التي عُلقت الى حين تحسن الموقف المالي. وختم اسئلته بسؤال هو الأهم:
- هل يتحسن الحال في العراق؟. وأكمل:
- سأطلب لك فنجاناً من القهوة أعمله خصيصاً لمن ينوي الانطلاق بمهامه الخاصة من هذه المقهى، ينفعك في البقاء نشطاً طوال الطريق، فسألته:
- وهل تقرأ الفنجان؟.
- قراءة الأفكار أسهل بكثير من قراءة خطوط تتركها بقايا بن في فنجان، يعتمد أصحابه القراء وسائل ايحاء كسبيل مقبول للوصول الى الاقناع. قلت:
- لا أحب شرب القهوة مساءً، أريد عصيراً طازجاً ينعش ذاكرتي المشوشة.
- أنت على خطأ سيدي الذاهب بعيداً الى المجهول، فالذاكرة وفي مثل مهمتك وهامش المجهول في محيطها وما سيواجهك من متاعب ومفاجئات، ليس من المناسب إنعاشها. المناسب في هذا الطريق الطويل سد منافذ التذكر التي تستدعي الماضي، وماضيك لا تنفع محتوياته الآن، وفي هذا الزمن، ولهذه المهمة بالذات.
- مقهاكم البيروتية، لا يشبه روادها العراقيون أولئك البيروتيون.
- نعم لا أحد يشبه أحداً، روادها هناك شباب يعشقون بعضهم البعض، مقاهيهم أسست أصلاً لمن يحب الحياة، قريبة من بحر ينفتح على عالم مليء بالحياة. مقاهينا هنا تنتصب موائدها عند حافات الحرب، روادها عائدون من معارك نتائجها متساوية بين المنتصر والمهزوم، يؤمها من يكره حياة الحرب، ومن يريد إقناع نفسه أنه خارج أسورتها الموقدة بالنار.
- الحرب أيها المصري البعيد عن نيله العجيب تنسي العشق والتأمل، إنها تقوي فقط الرغبة بالتشبث في الحياة، وان كانت تافهة بمعايير الحضارة الحالية.
وأنا أتكلم مع المصري الذي يتحرك بين الطاولات، يرد ويبتسم، لم أرفع عينيَّ عن الشارع وسيارتي المتوقفة أمام المقهى، حيث لم تقترب منها أي سيارة، ولم تأخذ واحدة مكاناً لها في القريب أو في الجهة المقابلة، شعور جميل بالطمأنينة، بعد استنتاج بعدم وجود مراقبة، دفعني لأن أودع المصري بالإشارة والقول لقد حان وقت الرحيل. فرد بصوت خافت:
- وداعا سيدي لا تنسَ مرورك على المقهى في العودة من مهمتك المجهولة كي تطمئنني، رواد المقهى العائدون من الحرب، والذاهبون اليها يسجلون لديّ كي أحصي الأموات، أوصيك بعدم الاستعجال في طريق الموت، كل شيء في أوانه، والأهم من هذا وذاك، أن المكلفين بالمراقبة لهذا اليوم في إجازة، لقد حضروا هنا وغادروا هذه المقهى الى بيوت اللهو يكتبون منها التقارير عنك، وعن بقية الزملاء.
...........................
نظرتي الى الطريق السريع بغداد السماوة باقية كما هي، مفتوح للسير دون سرعات محددة. السرعة هنا وعلى هذا الطريق يحددها أصحابها المصابون بداء الاستعجال وأنا واحد منهم، حتى أضحى الزمن في ذاكرتنا المنقولة عن الأجداد لا قيمة له، الا ما يتعلق منه باستعجالنا الحصول على ما نريده، وان كان رغيف خبز يابس.
زخات مطر في هذا الصيف تبدأ مع دخولي الطريق من جهة اليوسفية، لم تعيق هذه السيارة الحديثة، ولم تثنيني سائقاً حلت عليه الجرأة فجأة من السير بسرعة تؤشرها اللوحة مائة وخمسين كيلومتراً في الساعة، لأنني أحث الخطى ساعياً الوصول الى هدفي في السماوة قبل انتصاف القمر المكتمل وسط السماء، حيث تكون الدنيا كما لو أنها غارقة في ماء صاف يقترب من الزرقة، لكن المطر الذي تزايدت شدته، يبطئ سرعتي.
مشهد السيول غير المألوفة على هذا الطريق في الكيلو مائة وواحد تثير الرعب. أربع رجال يحملون فوانيس كأنهم يشيّعون أحدهم الى مثواه الأخير، يتقدمهم الأنحف عوداً، وهم يقتربون من السيارة بجهد يقاومون به الانجراف الى القعر بقوة السيل. بانت هيأته عند اقترابه خطوة أخرى، وكأنه شبح تاه صاحبه في صحراء الربع الخالي قبل مئات السنين، قال بشيطنة واضحة:
- لا يمكنك الاستمرار في السير والأرض مفتوحة شهيتها.
قال الآخر، قصير القامة:
- لقد حاولنا الاستمرار من قبلك بدقائق معدودات، فجرفَ السيل سيارتنا، أغرق سائقنا، وكان فلاح في طريقه الى الزريبة لإنقاذ حيواناته، قد أبقى على أرواحنا عندما كسر زجاج السيارة الخلفي بـ (حدرته ).
طلب الثالث انحرافاً حاداً بالسيارة الى اليمين ثم قال:
- دعنا نصحبك، نُدلك على الطريق المناسب مقابل إيصالنا الى الديار سالمين، في مدينة بابل الأثرية.
- لكنني لا أعرفكم، والوقت قد أصبح ليلاً.
قال الرابع:
- لا حاجة لك أن تعرفنا، نحن نُخيّم هنا كل أسبوع، نصطاد طيوراً، نقيم لها حفل شواء خاص، نحتسي شراباً أحمر كدم المسيح، ثم نعود الى أهلنا مع الفجر الذي نعده أصل الحياة.
- تحرك فالسيول ستأتي من السماء هذه المرة، لا نريد أن تأخذنا قسراً الى أماكن لم نجد فيها من يسأل عنا، ولا نريد أن تُطفئ لنا فوانيس نحتفظ بها صالحة لحفلات قادمة، كما لا نريد لحياتنا هذه، وحياتك أنت نهاية يحددها المطر.
- مالكم وحياتي؟.
قال النحيف:
ـ لأننا نعرفك جيداً.
- لكني لا أتذكركم.
فأكمل النحيف القول:
ـ لقد مسحت السياسة والحرب والسجن جزءاً من ذاكرتك، وأبقى التفكير بالهروب ذاكرتنا سليمة كذاكرة بدو الصحراء، همنا التمتع بمفاتن الدنيا مثل امرأة جميلة بعيون دعجاء، حلاوة ريقها خمر أبقانا أحياء في هذا المطر الغزير، وبهذا الزمن الذي أفسده الأصحاب، وهمك الانتقام، فارق الهميّنْ سيبقينا سعداء في أماكننا، وسيعرضك لمتاعب لم تكن في الحسبان. انزلنا هنا واذهب في طريق انتقامك. سوف لن نبلغ أحدا عن نواياك.
- وجوهكم وكأنها مألوفة، أعرفها منذ كنت طالباً في ثانوية الحلة.
- ها قد عادت ذاكرتك. اتركنا هنا فقد وصلنا المكان الذي نريد.
- والمطر؟. ألم تقولوا نخشى المطر.
- أرضنا عطشى، والمطر مزن صيف لا تنفع في اكبار الخشية.
...........................
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
أطفال الگاردينيا
حكاية صورة
طب وعلوم
مختارات
أيام وذكريات
فى ربوع العراق
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
483 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- أبعد مسبار عن الأرض يرسل بيانات للمرة الأولى منذ ٥ أشهر
- الذكاء الاصطناعي يحدد موقع قبر أفلاطون
- السجن ١٧٩٤ عاماً بحق "أحلام البشير" المتهمة بتفجير شارع الاستقلال في اسطنبول
- باب آخر لغسيل الأموال .. أسعار أرقام السيارات المميزة تثير سخط الرأي العام في العراق
- ٨ طرق مميزة لشحن الهاتف الذكي بسرعة فائقة
- ائتلاف المالكي يؤشر "رسائل سياسية" وراء اغتيال "أم فهد"
- العراقيون في المرتبة الـ٧ عربياً بقائمة أكثر طالبي الهجرة إلى أمريكا.. إليك الأرقام
- أخبار وتقارير يوم ٢٨ نيسان
تابعونا على الفيس بوك














































































